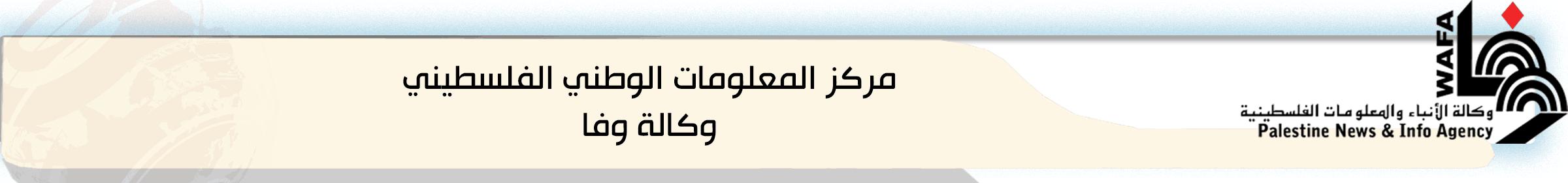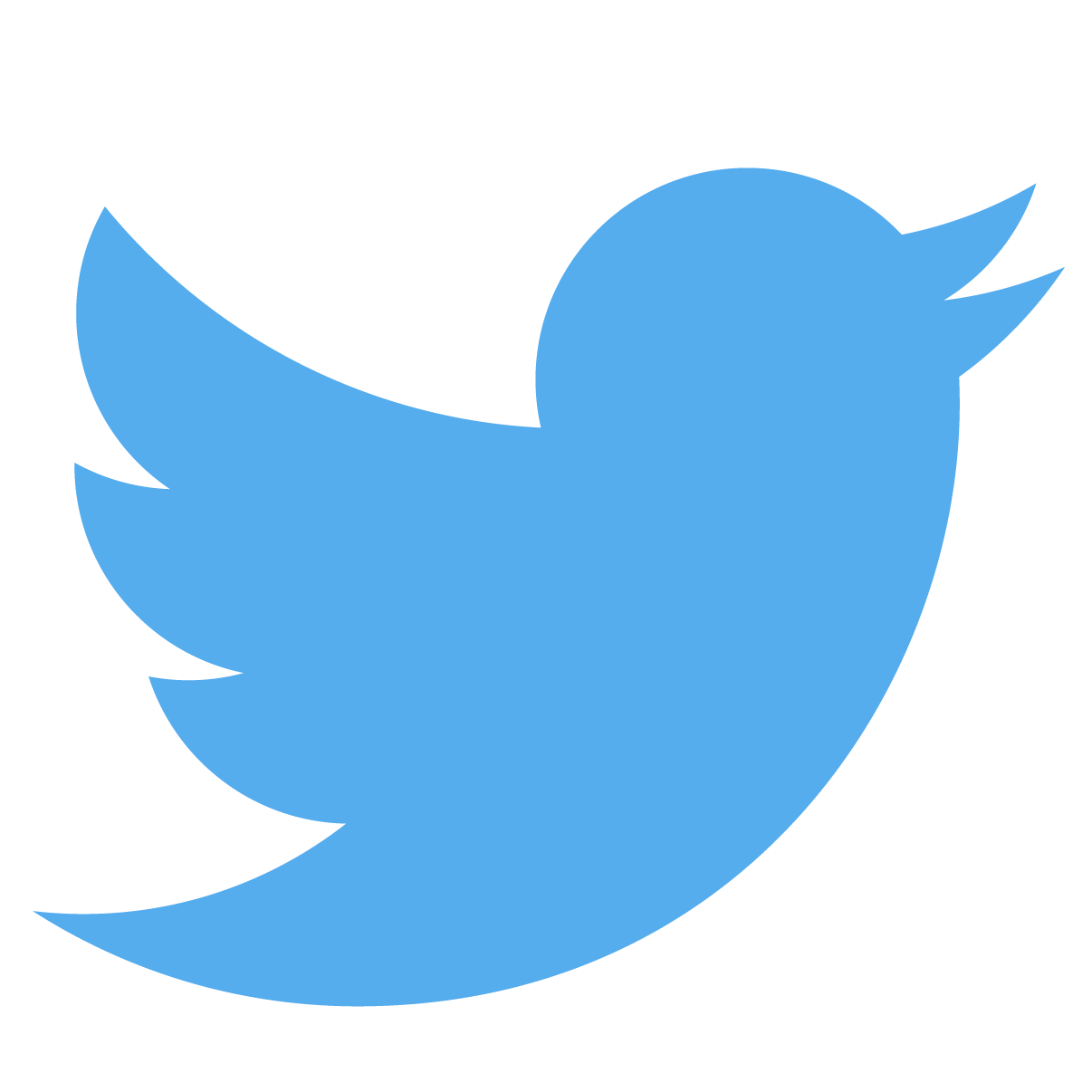الموقع والتسمية:
تقع مدينة بيت لحم بين مدينتي الخليل والقدس عند التقاء دائرة عرض 31.42ْ شمالاً وخط طول ْ35.12 شرقاً، وتمتد على هضبتين يصل أعلاهما إلى 750م فوق مستوى سطح البحر، وهي جزء من الجبال والهضاب الوسطى في فلسطين التي تنتشر موازية لغور الأردن والبحر الميت.
وتشير رسائل تل العمارنة إلى أن اسم بيت لحم يرجع إلى اسم مدينة جنوب القدس عرفت باسم بيت إيلو لاهاما، أي بيت الإله لاهاما أو لاخاما، وهو إله القوت والطعام عند الكنعانيين، وكانت تعني عند الآراميين بيت الخبز، ومن هنا جاءت التسمية، ولبيت لحم أيضاً اسم قديم هو أفرات أو أفراته وهي كلمة آرامية تعني الخصب والثمار.
مدينة بيت لحم مدينة كنعانية قديمة سكنها الكنعانيون منذ حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، ثم توالت عليها مجموعات قبائل مختلفة في معتقداتها، وفي حالة من الصراع والتناحر فيما بينها، ومن بين هذه القبائل القبائل اليهودية الكنعانية، وهي قبائل لا تربطها بالصهيونية الحالية أي روابط تاريخية أو عقائدية؛ لأن مسألة الشعوب والأمم جاءت في حقب متأخرة من مراحل التاريخ البشري بعد أن أقيمت الدول ورسمت الحدود وتطورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ونالت بيت لحم شهرتها العالمية بعد ميلاد المسيح فيها.
في القرن الحادي عشر قبل الميلاد تمكن الفلسطينيون من دخول المدينة بعد أن قتلوا شاؤول، ثم تمكّن داود عليه السلام من استرداد المدينة، وتولّى بعده الحكم ابنه رحبعام الذي حوصر في المدينة عام 937 ق.م، ثم بعد ذلك دخلت بيت لحم تحت الحكم الروماني، حيث بنى فيها الحاكم الروماني هيرودوس قلعة يلجأ إليها زمن الحرب، ثم بنى فيها الإمبراطور الروماني عام103 م معبداً للإله أدونيس فوق كهف السيد المسيح، ويقال أن هذا الإمبراطور قد اعتنق المسيحية سراً، وخشي على الكهف أن يندثر قبل أن تنتشر الديانة المسيحية، وفي عام 314م سمح الإمبراطور الروماني قسطنطين بحرية العبادة والأديان.
وفي عام 330م قامت الإمبراطورة هيلانة ببناء كنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة القيامة في القدس، ثم تعرضت كنيسة المهد للهدم على يد السومريين، فجاء الإمبراطور جوستينان الأول وقام ببناء الكنسية من جديد، كما بنى سوراً حول المدينة وبقي هذا السور حتى عام1448م، حيث أمر السلطان المملوكي بهدمه، أما الكنيسة فباقية إلى اليوم.
تعرضت المدينة إلى الغزو الفارسي عام 614م، ولم يهدموا الكنيسة لوجود صورة للمجوس وهم ساجدون أمام السيد المسيح على لوحة من الفسيفساء.
في سنة 648م دخلت المدنية تحت الحكم الإسلامي، وزارها الخليفة عمر بن الخطاب وصلّى داخل كنيسة المهد، وكتب سجلاً للبطريرك صفرونيوس بأن لا يصلي في هذا الموضع (كنيسة المهد) من المسلمين إلا رجلاً بعد رجل، ولا يجمع فيها صلاة، ولا يؤذن فيها، ولا يغير فيها شئ.
وعاش أبناء الديانتين المسيحية والإسلامية في هذه المدينة بروح من الإخاء والتعاون، ومارس أتباعهما شعائرهم الدينية بحرية.
يعدّ زمن هارون الرشيد 786-809م والدولة الفاطمية 952-1094م، من أكثر عهود بيت لحم ازدهاراً؛ حيث نشطت التجارة، واستتب الأمن، وأطلقت الحريات، ورمّمت الكنائس وأماكن العبادة.
في عام 1099م دخلت المدينة تحت الحكم الصليبي بعد أن دخلها الجيش الصليبي بقيادة تنكرد، الذي دمّر المدينة وأحرقها، ولم يتبق منها إلا كنيسة المهد، وقد دام الحكم الصليبي لبيت لحم حتى عام 1187، حيث عادت بيت لحم لأصحابها، بعد انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبين في معركة حطين.
وفي عام 1229م عادت مدينة بيت لحم لحكم الصليبين بموجب الاتفاقية التي وقعت بين ممثلي الخليفة الكامل فخر الدين وأمير أربيل صلاح الدين، وممثلي الإمبراطور فريدريك.
وفي عام 1244 تمكن المسلمون بقيادة نجم الدين من استعادة المدينة بشكل نهائي، قام بعدها الظاهر بيبرس بدخول المدينة عام 1263 ودمّر أبراجها وهدم أسوارها، وفي عام 1517 دخلت المدينة تحت الحكم العثماني.
وبعد تطور وسائل النقل والمواصلات، تحوّلت المدينة إلى مركز جذب هام للحجاج القادمين من أوروبا، انعكست أثاره على أوضاع سكان المدينة وازدهرت صناعة الصوف، والخزف وغيرها، إلا أن سوء الأوضاع الاقتصادية دفع بالكثير من أبناء المدينة إلى الهجرة خارجها.
وفي عام 1917م دخلت بيت لحم مع باقي مدن فلسطين تحت النفوذ البريطاني بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، واتخذها الإنجليز مركزاً لضرب الثوار الفلسطينيين الذين قاوموا الاحتلال الإنجليزي والعصابات الصهيونية.
في 27/3/1948م نشبت في موقع الدهيشة معركة كبيرة بين الثوار الفلسطينيين، ومجموعة من المستوطنين الصهاينة تتألف من 250 عسكرياً و54 سيارة تدعمهم أربع مصفحات، وتمكن الثوار الفلسطينيون من التغلب عليهم وأجبروهم على الاستسلام، وفي أعقاب حرب عام 1948 م تمّ إجبار أكثر من مليون فلسطيني على الهجرة من ديارهم، لجأ إلى المدينة قرابة الخمسة آلاف فلسطيني استقروا في ثلاثة مخيمات هي: الدهيشة، وعايدة، والعزة. وفي عام 1949م. ودخلت بيت لحم تحت الحكم الأردني بعد توقيع اتفاقية الهدنة لعام 1949م، واستمرّت كذلك حتى عام 1967م عندما وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي.
المساحة:
تبلغ مساحة محافظة بيت لحم 575 كم مربعاً، وتضم خمسة مدن رئيسية، وسبعين قرية، وثلاث مخيمات للاجئين الفلسطينيين. أما مساحة مدينة بيت لحم والتي تخضع ضمن حدود المخطط الهيكلي للمدينة؛ فتبلغ ثمانية آلاف دونم، وتقسم المدينة إلى العديد من الأحياء والأسواق التجارية.
السكان:
بلغ عدد سكان مدينة بيت لحم 6658 نسمة حسب إحصاء عام 1922م، ارتفع العدد إلى 7320 حسب إحصاء عام 1931م، وقدر عدد السكان بـ 9780 نسمة عام 1948م، وارتفع العدد إلى 14860 نسمة عام 1949م بعد لجوء أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إليها وأخذ سكان المدينة في التزايد فيما بعد، ثم تعرّض سكان المدينة إلى الانخفاض عام 1967م وبلغ عدد سكان مدينة بيت لحم 21673 في عام 1997م، ثم ارتفع العدد إلى 25266 نسمة في عام 2007م حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووفقًا لتعداد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017، كان عدد السكان 28,591 نسمة في المدينة، بينما بلغ عدد جميع السكان في محافظة بيت لحم ككل 217,400 نسمة، وتقدّر في 2024 بما يقارب 250 ألف نسمة.
النشاط الاقتصادي:
تشتهر بيت لحم بالمصنوعات الخشبية والصدفية والتحف التذكارية وأعمال التطريز التي تباع للسياح والحجاج الذين يزورون المدينة بالإضافة إلى صناعة الحجر والرخام والصناعات المعدنية. ولأهمية بيت لحم الدينية والتاريخية الأثر الكبير في زيادة وتفعيل النشاط السياحي، إذ تعدّ الصناعات السياحية فيها من المصادر الأساسية للدخل القومي؛ لوجود الأماكن الدينية والأثرية في المحافظة منها كنيسة المهد، ويعمل في هذا القطاع حوالي 28% من السكان.
النشاط الثقافي:
نالت بيت لحم قسطاً وافراً من التعليم منذ زمن بعيد، حيث أقيمت أولى المدارس فيها منذ أكثر من 200عام وذلك بسبب الطابع الديني الغالب على المدينة، ووجود إرساليات وأديرة أقامت الكثير من المدارس الخاصة منذ زمن بعيد، وتطور التعليم، حيث وصل عدد المدارس عام 1978 إلى 31 مدرسة يدرس فيها 8300 طالب.
كما أقيمت في المدينة جامعة بيت لحم لتضم عدداً من الكليات لتعليم العلوم، والآداب، والتمريض، والمعلمين، والفنادق، وغيرها.
أبرز المعالم السياحية و الدينية في المحافظة:
من أبرز المعالم السياحية الدينية في المحافظة كنيسة المهد التي اكتمل بناؤها في العام 339م، وبرك سيحان "برك المرجيع"، وقلعة البرك " قلعة مراد"، ودير الجنة المقفلة، والعين "عين أرطاس"، وتل الفريديس "هيروديون"، ووادي خريطون، وآبار النبي داود، ومتحف بيتنا التلحمي القديم، ودير القديس ثيودوسيوس، ودير مار سابا، ودير مار إلياس. كما يوجد في بيت لحم أربعة متاحف ودار مسرح ودارا سينما.
كنيسة المهد:

كنيسة المهد أقدم كنيسة في العالم، فبعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للدولة الرومانية الشرقية في عهد الإمبراطور قسطنطين عام 324، أمرت والدته الملكة هيلانة في عام 335 ببناء كنيسة المهد في نفس المكان الذي ولد فيه السيد المسيح عيسى عليه السلام في مدينة بيت لحم.
وتضم الكنيسة كهف ميلاد المسيح عليه السلام، وأرضيات من الرخام الأبيض، ويزين الكهف أربعة عشر قنديلاً فضيا، والعديد من صور وأيقونات القديسين.
وقد انتهى بناء الكنيسة عام 339م، وجاء على النمط البازلكي وهو نمط معماري مقتبس من المعابد الرومانية.
والكنيسة عبارة عن مجمع ديني كبير، تحتوي على مبنى الكنيسة بالإضافة إلى مجموعة من الأديرة والكنائس الأخرى التي تمثل الطوائف المسيحية المختلفة، وهي: الدير الأرثوذكسي في الجنوب الشرقي، والدير الأرمني في الجنوب الغربي، والدير الفرانسيسكاني في الشمال الذي شيد عام 1347م لأتباع طائفة الفرانسيسكان.

مغارة الحليب:
تقع إلى الجنوب الشرقي من الكنيسة وهي المكان التي أرضعت فيه مريم العذراء يسوع الطفل عندما كانت مختبئة من جنود هيرودس أثناء توجهها إلى مصر. ويقال أن بعض قطرات من حليب العذراء قد سقطت على صخرة مما أدى إلى تحول لون الصخرة إلى الأبيض.

دير ابن عبيد:
بناه ثيودوسيوس في العام 500 للميلاد، ويقع الدير شرقي قرية العبيدية، التي تبعد تسعة كيلومترات عن بيت لحم. ويقال أن الرجال الحكماء استراحوا في هذا الدير بعد أن حذرهم الله -في الحلم- من العودة إلى هيرودوس.

دير مار سابا:
بناه القديس سابا اليوناني في العام 482 بعد الميلاد، على موقع يطل على وادي قدرون، ويبعد (11) كيلومترا إلى الشرق من دير بن عبيد. وعندما توفي القديس سابا في العام 531 دفن في نفس الدير وتم نقل رفاته فيما بعد إلى القسطنطينية، ولاحقا إلى فينيسيا في ايطاليا على يد الصليبيين، ومن ثم تم إعادة رفاته إلى ديره في العام 1965، حيث تم وضعه في صندوق زجاجي. ويحافظ الدير على نفس نمط الحياة الذي كان سائدا في عهد قسطنطين، حيث لا يسمح للنساء بالدخول إلى الدير.

آبار النبي داوود:
تقع هذه الآبار إلى الشمال من بيت لحم وقد سميت بهذا الاسم بسبب القصة الشهيرة في الكتاب المقدس من نبوءة صموئيل الثانية 23:14-حين شرب النبي داوود من هذه الآبار بينما كان الفلستيين يطاردونه.

دير مار الياس:
يقع دير وكنيسة مار الياس على بعد كيلومترين إلى الشمال الشرقي من الطنطور. ويقع هذا الدير على تلة تطل على القدس وبيت لحم وبيت ساحور.

مسجد بلال (قبر راحيل):

يعتقد هذا المبنى الصغير العلامة التقليدية لقبر راحيل، وهي زوجة يعقوب التي ماتت في بيت لحم بعد ولادة ابنها بنيامين. وهذا الموقع يقدسه المسيحيون والمسلمون واليهود. وقد تم بناء الحرم الحالي والجامع خلال الفترة العثمانية، ويقع على طريق القدس – الخليل، قرب المدخل الشمالي لبيت لحم.
دير الجنة المقفلة:
يقع هذا الدير في قرية أرطاس والتي تقع على بعد كيلومترين من برك سليمان. وقد قام ببناء الدير مطران مونتيفيديو عاصمة أروجواي في أمريكا الجنوبية في العام1901م، وتقوم الراهبات بإدارة هذا الدير.

كنيسة العذراء:
تقع في بيت جالا، وتتبع للروم الأرثوذكس.

كنيسة القديس نقولا:
تقع في بيت جالا، وتتبع للروم الأرثوذكس.

حقل الرعاة للروم الأرثوذكس:
يقع إلى الشرق من مدينة بيت ساحور، حيث ظهر فيه ملاك الرب إلى الملائكة وأخبروهم بالنبأ السعيد وهو مولد يسوع، وحينها هللت ملائكة السماء " المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة".

عندما أتت القديسة هيلانة إلى بيت لحم؛ بنت كنيسة المهد وكنيسة أخرى على مغارة الرعاة والتي هدمت وأعيد بناؤها ثلاث مرات.
كنيسة حقل الرعاة لللاتين:
تقع كنيسة حقل الرعاة لللاتين على بعد600م إلى الشمال من كنيسة حقل الرعاة للروم الأرثوذكس. وقد اشترى الآباء الفرنسيسكان الأرض المبني عليها الكنيسة في منتصف القرن التاسع عشر. ويمثل هذا المكان الموقع الذي ظهرت فيه الملائكة للرعاة، وأخبروهم بالنبأ السار وهو ميلاد يسوع المسيح.
أما الكنيسة الحالية فقد بنيت في العام 1954، على صخرة كبيرة يقال أنها قاعدة لكنيسة قديمة مدمرة. وقد قامت كندا بتمويل بناء الكنيسة والتي جاءت على شكل خيمة، وسميت ملائكة الرعاة. وقد كانت الكنيسة آخر عمل فني للمهندس المعماري الإيطالي أنطونيو بورلوستو.
حقل الرعاة للبروتستانت:
عند زيارة السائح كنيستي حقل الرعاة للروم الأرثوذكس واللاتين يتجه شرقا فإنه يجد مرجًا مليئاً بأشجار الصنوبر، وفي وسط هذا المرج يوجد مبنى جمعية الشبان المسيحية.
وعلى الجانب الشرقي من المبنى يوجد مغارة فيها الكثير من البقايا الفخارية. وتذكر هذه المغارة طائفة البروتستانت بالرعاة الذين خبروا بميلاد يسوع المسيح.
برك سليمان:

تحتوي برك سليمان على ثلاث برك ضخمة مستطيلة الشكل، تتسع ل (160.000) متر مكعب من مياه الأمطار التي تسقط على الجبال المحيطة. ويحيط بالبرك أشجار الصنوبر، وقد ذكر في الإنجيل بأن الملك سليمان الحكيم بنى هذه البرك لزوجاته. وفي السابق كانت مياه البرك تضخ إلى بيت لحم والقدس.
قصور تاريخية وأثرية في محافظة بيت لحم
قصر هيروديون الأثري

بني على تلة تبعد ستة كيلومترات إلى الجنوب من بيت لحم. وتحتوي هذه القلعة على بقايا لقصر ضخم بناه الملك هيرودوس لزوجته في العام 37 قبل الميلاد، وكان القصر يحتوي على أبنية فخمة وأسوار مدورة وغرف محصنة وحمامات وحدائق.
قصر جاسر:

بنى قصر جاسر رئيس بلدية بيت لحم السابق في ذلك الوقت سليمان جاسر في عام 1910 م في مدينة بيت لحم، بالقرب من مسجد بلال؛ واستمرت عملية البناء أربع سنوات (1910-1914 ). والقصر يتكون من ثلاثة طوابق، مساحة كل طابق 800 متر مربع. ويعد قصر جاسر تحفة معمارية بكل المقاييس. استخدم البريطانيون قصر جاسر عام 1940 سجنًا؛ وفي عام 1950 حول إلى مدرسة خاصة؛ وخلال الانتفاضة الأولى، استخدمه جيش الاحتلال نقطة مراقبة عسكرية؛ وبعد عام 2000م، أصبح فندقاً حصد جائزة أفضل فندق تاريخي لعام 2017.
قصر هرماس:

يقع في مدينة بيت لحم بني عام 1910. ولقربه من حرم جامعة بيت لحم؛ عملت الجامعة في عام 1995 على شراء القصر لتعيد ترميمه عام 2002؛ فتحول إلى مكان جميل يمثل فن العمارة المحلية؛ وتوجد فيه حاليًا كلية التمريض والتربية.
قصر مُرقص:

يقع قصر مُرقص نصار في حارة العناترة في البلدة القديمة في بيت لحم. بناه المهندس المعماري المعروف مرقص نصار بمساحته التي تقدر بنحو 520 مترًا مربعًا، زين القصر من الدخل بالرسوم الملونة. وقد احتوت رسومات السقف على مناظر طبيعية، ومشاهد للصيد، ومناظر للطبيعة الصامتة. وفي عام 2013، قام مركز حفظ التراث الثقافي بالتعاون مع "مركز المعمار الشعبي "رواق"" بإعادة تأهيل وترميم القصر لتستخدمه مؤسسة "معا للحياة" التي تعنى بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
قصر حنضل: قصر زراعي مهجور يقع على شارع القدس - الخليل التاريخي في منطقة "الصوانة" جنوب بلدة الخضر. بني وسط خربة أثرية، تحوي قبورًا قديمة، وأنفاقًا، وغرفًا وردية اللون محفورة في الصخور، استخدمت حتى وقت قريب؛ وبالقرب منه تقع عدة ينابيع ماء، منها: نبع عين الطاقة، وعين جديدة.
قصر شهوان "قصر دار صلاح":

يقع في بيت جالا. بنته أسرة شهوان على مساحة 500 متر مربع عام 1917. يحتوي على أعمدة وأدراج داخلية وأقواس ومنحوتات لعدة حيوانات؛ ويحتوي الطابق السفلي على معصرة حجرية قديمة مغلقة منذ عام 2002.
قلاع تاريخية في بيت لحم
قلعة مراد "قلعة البرك"

تقع قلعة مراد على أراضي بلدة أرطاس؛ على بعد 3 كليومترات ونصف جنوب غرب مدينة بيت لحم.
بنى القلعة السلطان العثماني مراد الرابع، الملقب بــ"فاتح بغداد" في عام 1622؛ بهدف حماية أقنية المياه من التخريب أو التدمير، حيث إن هذه الأقنية كانت توصل ماء الشرب من برك سليمان الثلاث إلى مدينة بيت لحم، ثم إلى مدينة القدس.
تمركزت في القلعة في ذلك الوقت حامية عسكرية عثمانية، وسيرت دورية على طول الطريق حتى عين العروب، وعيون واد البيار التي تصب ماءها في برك سليمان الثلاث.
تحتوي هذه القلعة على عدد من الغرف لمبيت الجنود، ومسجدٍ للصلاة، وأربعة أبراج على الزوايا الأربع. ويوجد بجانب القلعة من الجهة الجنوبية نبع ماء صغير يسمى "رأس العين".
قلعة الفريديس "هيروديون"

تقع قلعة الفريديس على بعد 6 كم جنوب شرق مدينة بيت لحم على طريق التعامرة بيت ساحور. بناها هيرودوس الكبير ذو الأصول الآدومية عام 22 قبل الميلاد في العهد الروماني؛ لتكون حصنًا آمنًا من أي غزو خارجي.

القلعة مخروطية الشكل، ترتفع عن سطح البحر 758 متراً؛ وعن جوراها بنحو 100 متر. وتحتوي على أربعة أبراج على أطرافها؛ إضافة إلى قصر، وحمامات، ونظام مائي، وحدائق ذات أروقة معمدة، وأنفاقٍ عميقة في جوف الجبل، توصل إلى آبار، ومستودعات، ومخازن للسلاح، وسجون، وقاعات.
القلعة وما يحيط بها من آثار معلم فلسطيني تاريخي، سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي في حرب عام 1967م، وأجرى بداخلها عمليات تنقيب واسعة؛ وحولها إلى مزار سياحي، يستغله لتدعيم مزاعمه وتأويلاته حول الوجود اليهودي في فلسطين.
السرايا العثمانية في بيت لحم
تُعد سرايا بيت لحم واحدة من المعالم العثمانية التي جسّدت حضور الدولة العثمانية في المدينة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. شُيّد المبنى عام 1873 على الحافة الشمالية الغربية لما يُعرف اليوم بـساحة المهد، ليكون مركزًا إداريًا وحكوميًا يُشرف على شؤون المدينة والمنطقة المحيطة بها.
خلال الثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939)، وفي يوم 14 أيلول/سبتمبر 1938، قام الثوار الفلسطينيون بإحراق مبنى السرايا إلى جانب مكتب بريد بيت لحم، في إطار أعمال المقاومة ضد سلطات الانتداب البريطاني. وردًا على ذلك، قامت السلطات البريطانية عام 1942 بهدم السرايا بالكامل، وأقامت على أنقاضها مركز شرطة حديثًا بُني وفق النمط الأمني البريطاني المعروف آنذاك.
تميّز المبنى الجديد بتصميم مستطيل الشكل، مع زاوية بارزة على شكل برج في الجهة الجنوبية الشرقية، مستوحاة من حصون تيغارت التي أنشأتها بريطانيا في فلسطين لمواجهة التمردات والانتفاضات الشعبية. بقي مركز الشرطة قائمًا ويؤدي وظيفته الأمنية حتى أواخر تسعينيات القرن العشرين، حين قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إزالة المبنى ضمن مشروع إعادة تأهيل مركز المدينة.
في موقع السرايا القديم، أُقيم لاحقًا مركز السلام في بيت لحم، وهو مبنى متعدد الاستخدامات بُني ليخدم أغراضًا ثقافية وإدارية. وخلال أعمال الحفر لتأسيس المبنى الجديد، كُشفت طبقات أثرية مهمة تعود إلى مدينة بيت لحم القديمة، لا تزال أجزاء منها ظاهرة حتى اليوم في الطابق السفلي من المبنى، الذي يُستخدم جزئيًا كمركز للشرطة.
تُمثّل قصة سرايا بيت لحم نموذجًا حيًا لتحوّلات المشهد العمراني والسياسي في المدينة، حيث تداخلت السلطة العثمانية، والاستعمار البريطاني، والنظام الفلسطيني الحديث في موقع واحد، تراكمت فيه الطبقات التاريخية فوق بعضها، بينما طُمرت رمزية "السرايا" – كمركز للحكم – تحت الأرض، ولم يبقَ منها إلا أثر في الذاكرة والصورة.
العمارة في بيت لحم

تشكل العمارة التقليدية في بيت لحم جزءاً أساسياً من الموروث الثقافي للمدينة، كما أنها أحد الروافد المهمة في دعم السياحة خاصة بعد إدراج المدينة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2012م (بيت لحم، مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة المهد ومسار الحجاج).
تكونت عمارة المسكن حتى منتصف القرن التاسع عشر في بيت لحم، كغيرها من العمارة السكنية في بقية أجزاء فلسطين، من تكوينات غير منتظمة من الغرف المتراصة التي تشكل في مجملها "الحوش"، وعليه تعرف الأحواش بأنها تجمعات سكنية يسكنها أبناء العائلة الواحدة.
وتحتوي هذه الأحواش على فراغات متوسطة شبه خاصة، وتتوزع حول فراغات وسطية غير نافذة. وتفصل بين الأحواش المختلفة طرق متعرجة نافذة تصل هذه الأحواش مع الفراغات العامة في المدينة؛ إلى أن جاءت عدة عوامل يمكن تلخيصها في: تطور أساليب البناء، والتغير الواضح في ثقافة المسكن، والإطلاع على ثقافات مختلفة والتأثر بها- أدت في مجملها إلى تمدن المجتمع؛ ما أثر على أسلوب العمارة وشكلها واستخداماتها.
حيث يمكن تصنيف العمارة في بيت لحم إلى عدة أقسام مختلفة وهي: المباني البسيطة، والمباني الطولية، والأحواش، والمباني المنتظمة، والمباني التي تجمع بين الأحواش والمباني المنتظمة، والقصور والمباني الكبيرة ؛ حيث تعكس هذه التقسيمات شكل عمارة بيت لحم وتطورها خلال القرنين الماضيين.
1- المباني البسيطة:
تتكون المباني البسيطة من غرفة واحدة أو غرفتين متجاورتين مبنيتين من الحجر الغشيم والتراب. واعتمد البناء التقليدي البسيط على مواد البناء المتوفرة في البيئة المحيطة. ومن المباني البسيطة: المناطير التي عرفت أيضاً بقصور المزارع، والمخازن التي بنيت بالقرب من المباني السكنية، والطوابين (جمع طابون).
2- المباني الطولية:
تتميز هذه المباني بأنها تتكون من غرفتين أو أكثر من الغرف المتلاصقة التي يتصل مباشرة بعضها ببعض دون وجود فراغ وسطي أو انتقالي يفصل بينها. وغالباً يتم الانتقال بين الطوابق بواسطة درج خارجي يؤدي إلى أحد الغرف التي يتم من خلالها الانتقال إلى الغرف المجاورة. وتتكون معظم المباني الطولية من طابقين، وتنتشر بمحاذاة الشوارع التجارية، وقد غلب الاستخدام التجاري على الغرف الواقعة على مستوى الشارع؛ بينما استخدمت غرف الطابق الآخر الذي قد يكون فوق الطابق التجاري أو تحته؛ وذلك حسب طبوغرافية الأرض للسكن، وحلت الساحة الخلفية للبناء محل الحوش.
3- الأحواش:
الأحواش عبارة عن تكتلات غير منتظمة تتكون نتيجة التوسع المستمر لتلبية حاجات الأسرة أو العائلة، وتنشأ بطريقة تراكمية ولا يتم بناء بيوتها على مرحلة واحدة، وقد تميزت الحارات في بيت لحم بأنها تكونت من عدة أحواش متلاصقة لعائلات من حمولة واحدة، وقد إرتبطت هذه الأحواش بعضها ببعض من خلال شبكة الطرق الرئيسية الممتدة من الغرب إلى الشرق باتجاه ساحة المهد، وارتبطت أيضاً بالأراضي الزراعية من خلال الأدراج التي انحدرت إلى الشمال والجنوب بإتجاه هذه الأراضي .
يتكون الحوش من ساحة رئيسية شبه خاصة، ويتم الدخول إليه من الشارع الرئيسي عبر الساحة الرئيسية التي تحتوي على بعض المرافق المشتركة، مثل: بئر الماء، والطابون، والراوية، أو الإسطبل لإيواء الحيوانات؛ إضافة إلى بستان صغير.
وقد جاء تصميم الأحواش خلال الفترة العثمانية على شكل كتل معمارية متلاصقة تعكس بشكل طبيعي المفاهيم الثقافية الموروثة، والتركيبة الاجتماعية السائدة خلال تلك الفترة، كما عكست الأحواش الأوضاع الأمنية والاقتصادية المعاشة لقطاع واسع من السكان في فلسطين في تلك الفترة.
وقد يختلف حجم الحوش حسب عدد الأسر القاطنة فيه، وحسب وضعهم وقدرتهم الإقتصادية على إنشاء بيوت جديدة.
وترتبط الغرف في الحوش الواحد بواسطة أدراج خارجية في الغالب تربط هذه الغرف بعضها ببعض.
وتتصف الأحواش ببساطة تفاصيلها المعمارية من حيث الزخارف والنقوش، كما تمتاز بعدم تخصص الفراغ إذ كانت تستخدم الغرفة الواحدة للقيام بجميع نشاطات الأسرة، وهاتين الصفتين من أهم الصفات التي ميزت الأحواش عن غيرها من المباني السكنية .
كما تميزت الأحواش بالأبواب والشبابيك الصغيرة، وقد استخدم في بناء الأحواش الحجر المحلي، كما أعيد استخدام بعض الحجارة المنقوشة في الواجهات الرئيسية للمباني.
4- المباني المنتظمة:
بدأت المباني المنتظمة في الظهور بعد منتصف القرن التاسع عشر؛ ويعود ظهورها إلى عدة عوامل ترتبط في مجملها بضعف الدولة العثمانية، وحركة الإصلاحات التي شملت مختلف نواحي الحياة؛ إضافة إلى صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي والملكيات؛ كما يعود ظهور المباني المنتظمة أيضاً إلى الانفتاح الذي تعرض له سكان المدينة نتيجة ارتفاع عدد السياح والحجاج القادمين للمدينة، وما رافقه من إزدهار في النشاط التجاري؛ بالإضافة إلى ذلك بدأت تنتشر مفاهيم جديدة حول ثقافة المسكن نتيجة سفر العديد من التجار وأصحاب مشاغل حرف التقوية إلى العديد من دول أوروبا وآسيا وأميركا لتسويق بضائعهم، وأيضاً سفر العديد منهم إلى أميركا اللاتينية؛ حيث عملوا بالتجارة وأصابوا الثراء ثم عادوا إلى المدينة؛ وعليه جاءت هذه المباني لتعكس أسلوب الحياة المدنية التي بدأت في الانتشار في تلك الفترة .
تقسم المباني المنتظمة إلى ثلاثة أقسام :
- المباني التي تحتوي على ليوان
- المباني التي تحتوي على رواق
- المباني التي تحتوي على فناء (ساحة داخلية)
وتتميز فئة كبيرة من المباني داخل المركز التجاري للمدينة بأنها تنتمي لهذه الفئة، وقد بدأت هذه المباني بالانتشار في نهاية القرن التاسع عشر، وجاءت نتيجة العديد من العوامل أهمها: التغيرات المباشرة في أسلوب الحياة اليومية، وتحسن الوضع الاقتصادي لسكان المدينة؛ بالإضافة إلى ذلك فقد دمر الزلزال الذي ضرب بيت لحم عام 1927 العديد من المباني في المدينة، كما ألحق أضراراً جسيمة بأخرى؛ ما اضطر السكان إلى إعادة بناء المنازل التي تهدمت فجاءت الأبنية الجديدة الأكثر انتظاماً من الأحواش التي هدمت بفعل الزلزال.
وبدأت تظهر بشكل واضح في هذه المباني بعض مفردات عمارة أوروبا والأمريكيتين مثل: البلاكين المطلة على الشوارع، وحديد الحماية المزخرف، والأسقف المزينة بالرسومات الهندسية والمناظر الطبيعية، وعليه تندرج المباني المنتظمة في فئتين: الأولى هي المباني المنتظمة التي استخدمت فيها العناصر المعمارية المحلية، والثانية هي العمارة المنتظمة التي استخدمت فيها عناصر معمارية مشتقة من العمارة الأوروبية، وكلتا الفئتين تظهران التوجه نحو التمدن في أساليب الحياه، بينما تعكس الفئة الثانية بوضوح رغبة أصحابها في إظهار الثقافة الجديدة التي تعرضوا لها.
وعلى الرغم من ذلك بقيت المباني المستخدمة للسكن تعكس أسلوب حياة العائلة الممتدة، حيث سكن الطابق الواحد أسرة أو أسرتين من العائلة الواحدة ، كما كانت تقوم العائلة ببناء طابق إضافي كلما شعرت أن هنالك حاجة لذلك.
كما حل الليوان أو الرواق في البيوت المنتظمة مكان ساحة الحوش، وأصبح الفراغ الذي تمارس فيه العائلة نشاطها اليومي، وغالباً كان يبنى المطبخ في الجزء الخلفي من المنزل بحيث يمكن لسكان المنزل استخدام الساحة الخلفية.
ومن التغيرات الواضحة التي بدأت تظهر في العمارة المنتظمة استخدام الحجر الأحمر والحجر الأبيض في البناء، وكذلك تهذيب الحجر وظهور الشبابيك الكبيرة نسبياً التي تطل على الشارع، كما شاع نقش حجارة قمط باب المدخل الرئيسي، والتي احتوت على رموز دينية وعلى اسم صاحب المنزل والسنة التي أنجز فيها البناء، وقد تم ذكر اسم صاحب البناء والسنة في بعض الأمثلة بأبيات شعرية نقشت على عتبة البيت.
ومن التغيرات التي بدأت تظهر أيضاً نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وكانت من مميزات المباني المنتظمة حديد الحماية وحديد الأبواب المزخرف الذي احتوى في بعض الأحيان على الأحرف الأولى من اسم صاحب البناء أو سنة البناء، كما ظهر في تلك الفترة استخدام البلاط الإسمنتي المزخرف والملون.
5- المباني التي تجمع بين الأحواش والمباني المنتظمة:
تعتبر المباني التي تجمع بين الأحواش والمباني المنتظمة امتداداً للأحواش، إذ شكلت المباني المنتظمة الامتداد الأحدث للأحواش التقليدية، وقد تشكلت الإضافات المنتظمة للأحواش نتيجة لنفس العوامل التي أدت إلى ظهور العمارة المنتظمة، حيث بنيت أغلب الأجزاء المنتظمة من الأحواش في مركز المدينة القديمة، إما فوق أنقاض البيوت التي تهدمت ودمرت بفعل العوامل الطبيعية أهمها زلزال عام 1927 الذي أدى إلى تهدم العديد من الأحواش القائمة لتلبية احتياجات ساكنيها.
أخذت الأبنية الجديدة الشكل الطولي والمنتظم في البناء والتوسع، وشكلت الأجزاء المنتظمة من هذه المباني حلقة الوصل بين الأحواش والفراغات العامة والطرقات الحديثة، كما ساهمت هذه المباني بتحديد مراكز الأحواش المختلفة داخل المدينة التاريخية ورسمت شبكة الطرقات الرئيسية منها.
6- القصور والمباني الكبيرة:
بدأت المباني الكبيرة في الظهور في مدينة بيت لحم، كغيرها في بقية المدن الفلسطينية، نتيجة عدة عوامل ارتبط معظمها بالوضع العام للدولة العثمانية، بما فيها حركة الإصلاحات التي شملت مختلف مناحي الحياة وصدور القوانين الجديدة المتعلقة في الأراضي والملكيات؛ حيث شكل هذان العاملان محركاً للعديد من البعثات التبشيرية للاستقرار في المنطقة؛ فقد سمح تعديل قانون التملك عام 1868 للأجانب بالتملك في أراضي الدولة العثمانية، بما فيها فلسطين؛ فبدأت الإرساليات بالتملك في العديد من المدن الفلسطينية التي شكلت في حينه نقطة جذب تلبي رؤية هذه المؤسسات وطموحاتها وباشرت ببناء الأديرة والمستشفيات والمدارس والنزل، وقد كانت بيت لحم أحد هذه المقاصد.
بدأت العديد من البعثات التبشيرية في البناء في المدينة، وكان من أهم المباني التي ظهرت في تلك الفترة دير راهبات الكرمل، و مدرسة راهبات ماريوسف، ومدرسة دي لاسال (جامعة بيت لحم)، ودير السالزيان، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية، ومستشفى فرسان مالطا (المستشفى الفرنسي)، وغيرها من المباني التي انتشرت بكثافة في محيط المدينة .
وقد عمل على تصميم أغلبية هذه المباني مهندسون معماريون قدموا مع الإرساليات؛ وقام بمعاونتهم في البناء بناؤون محليون.
وقد اشتهر أهالي بيت لحم بمهارتهم في نحت الحجر والبناء، وعملوا مع المهندسين في مدينة القدس أيضاً، كما لعب المهندسون المحليون الذين درسوا العمارة في الخارج دوراً أساسياً في بناء القصور والمباني الكبيرة في المدينة، ومن أشهرهم: المهندس مرقص نصّار الذي اشتهر بتصميمه وإشرافه على بناء دير راهبات أرطاس والعديد من المباني الهامة الأخرى والقصور في مدينتي بيت لحم والقدس.
تم البناء في المباني التي تأثرت بالعوامل التي ذكرت آنفاً باستخدام المواد المحلية وبأيدٍ محلية، وقد ظهرت التأثيرات بشكل واضح في الوظيفة وتوزيع الفراغات في المسكن، كما ظهرت بأشكال وتفاصيل العناصر المعمارية المختلفة في المباني كالأبواب والشبابيك والكرانيش وتفاصيل الفاصون والمنجور. كما تميز بعض هذه المباني بالرسومات التي زينت أسقفها وجدرانها، وقد رسم بعض هذه الرسومات فنانون أوروبيون أو محليون تعلموا الرسم مباشرة من الفنانين الأوروبيين، على عكس ما هو سائد في غالبية المدن الفلسطينية التي وصلها التأثر الأوروبي عن طريق اسطنبول.
وتظهر القصور التي بنيت بداية القرن العشرين بوضوح ثراء أصحابها ورغبتهم في إبراز مكانتهم الاجتماعية في المدينة، وفي محاولتهم لإبراز الثقافات المختلفة التي تأثروا بها. وقد بنيت أغلب القصور في أماكن بعيدة عن مركز المدينة في محيط الأديرة والأبنية الأخرى التي بنتها الإرساليات، أو على امتداد الطريق الواصل بين بيت لحم والقدس، ومن أشهر قصور مدينة بيت لحم وأكثرها فخامة: قصر جاسر (1914)، وقصر هرماس (1910)، وقصر حنضل (1911)، وقصر الجعار (1932)، وقصر جقمان (1908)، وغيرها من القصور.
كان للازدهار الاقتصادي الذي تمتع به سكان المدينة نتيجة انخراطهم في التجارة مع أوروبا والأمريكيتن، الأثر المباشر والواضح في ازدهار العمارة في المدينة. واستمر الإزدهار حتى نهاية العشرينات من القرن العشرين؛ حيث أثرت الأزمة المالية العالمية كثيراً على أهالي مدينة بيت لحم ممن عملوا في التجارة مع الخارج؛ ما أدى إلى إغراق العديد منهم في ديون أدت بهم إما إلى بيع منازلهم أو لتأجير جزء منها أو في بعض الأحيان إلى عدم تمكنهم من إكمال البناء كما حدث في قصر الجعار وقصر مرة، وقد استخدم العديد من هذه القصور أو ما زال يستخدم كمبانٍ عامة.
امتازت غالبية القصور والمباني الكبيرة، كما هو الحال أيضاً في المباني المنتظمة، بالتماثل حول محور وسطي (أي أن يقع هذا المحور حول وسط المدخل الرئيسي للبناء)، وتميزت غالبية القصور والمنازل الفخمة بتعقيد تصميم الواجهة الرئيسية وكثافة زخرفتها لتعكس نفوذ صاحبها ووضع العائلة الاجتماعي والاقتصادي؛ أما واجهات البناء الأخرى فتميزت ببساطة تصميمها وخلوها تقريباً من الزخارف؛ إلا أن الواجهات الأربعة كانت تتشابه من حيث روح التصميم ونسب الفتحات وأبعادها. وفي بعض المباني -كما هو الحال في منزل الدبدوب- فقد اختلفت نوعية الحجر بين الواجهة الرئيسية وواجهات المبنى الأخرى، بحيث تم استخدام الحجر الأحمر في الواجهة الرئيسية؛ بينما بنيت بقية الواجهات باستخدام الحجر المزي.
أحياء البلدة القديمة في مدينة بيت لحم

تشكل الأحواش نوى الحارات التي تتكون منها مدينة بيت لحم. وتفصل بين الأحواش طرق متعرجة نافذة تتصل مع الفراغات العامة في المدينة. وتمثل هذه الحارات حكاية حياة التلاحمة، وتثبِت جزءاً مهماً من الثقافة في بيت لحم؛ وهذه الحارات هي: العناترة، والنجاجرة، والفراحية، الحريزات، والتراجمة، والقواوسة، والفواغرة.
حارة النجاجرة

تقع حارة النجاجرة غرب ساحة المهد (تمتد من خلف مسجد عمر إلى الشرق من سوق المدينة)؛ ويعتقد أنها أقدم حي في المدينة. وتذكر أحاديث الموروثة أن سكان هذا الحي من سلالة الغساسنة (وهم أول القبائل التي اعتنقت المسيحية) الذين جاءوا من نجران (شمال اليمن) في القرن السادس الميلادي؛ ودعي من جاء من نجران بالنجاجرة؛ كما انضمت إليها عدّة عائلات تسمّى بـ"حمولة الغثابرة" الذين جاؤوا في الفترة الفرنجية المبكرة. ومن العائلات التي تسكن الحارة: العلي، مرقص، زروق، حزبون، حنضل، بعبيش، جقمان، المصو، قطيمي، أبو زيد، صنصور، مصرية، أبو ردينة، وعالول، ومهيوب، وحبش، وشريم، وأبو دوح انسطاس، سمور، سقا، غطاس، نينو، أبو زعرور، حوش، ونصار.
حارة الفرحية

تقع حارة الفرحية غرب ساحة المهد (من دوار المدبسة إلى مسجد الفاروق)، سميت بهذا الاسم نسبة إلى جدهم (فرح) الذي التجأ من وادي موسى إلى بيت لحم في القرن السادس الميلادي؛ فيما سكن أخوه كولح حارة الصرار في بيت جالا ليكون حمولة الكوالحة، وذلك في القرن السادس الميلادي، خلّف فرح أربعة أولاد:
- موسى : خلّف عائلتي: جاسر، ومسلم.
- غانم : خلّف عائلات: ماريا، مرّة، وناصر، وزبلح.
- سلامة : خلّف عائلات: سلامة، والأعمى، والزغبي.
- مخلوف : خلّف عائلات: عتيق، وبابون، وسلمان، وبلوط أو الدنين.
من بعض العائلات التي تسكن الحارة: ناصر، وجعار، وتويمة، وجاسر، وأبو عياش، والجمل، ويونس، والصقعان، ودويرى، وصليبي، وسلامة، والأعمى، والزغبي، وقطان، وحنانيا، وقراعة، وسالم، وأبو حمود، وأبو سعادة، وقزاقيا، ومرة، وميلادة، وزبلح، وماريا، وبلوط، وعصفورة، وفقوسة، وسلمان، وأبو الدنين، وحرب، ومسلم، والأعرج، وبابون، وشحادة، وسايح، وحيحي، والجدي، والسعدي.
حارة العناترة

تقع حارة العناترة جنوب كنيسة المهد؛ ويعتقد أن سكانها جاءوا من تل عنتر جنوب جبل الفرديس، زمن السلطان مصطفى الثاني (حوالي عام 1744م). وكان هذا الحي يلقّب بحارة "النتش" لكثرة وجود النتش (وهي نبتة بريّة تستعمل لإشعال النار لخبز الشراك). ومن العائلات التي تسكن حارة العناترة: فريج، وقنواتي، ومتري، والبندك، واقطيش، وسلمى، وطافش، وسابا، وشامية، وشاهين، وسلحي، والراهب، ووردة، واقطيش، وبربارة، وخبز، وحزينة.
حارة الحريزات

تقع حارة الحريزات غرب ساحة المهد)من شمال حارة الفواغرة إلى الجنوب من حارة التراجمة(، يعتقد بأن سكان هذه الحارة جاءوا من قرية أم طوبا جنوب غرب صور باهر. ومن العائلات التي تسكن حارة الحريزات: الحزين،, أبو حمامة، وبطّو، وصافية، وزرزر، وأبو جابر، وسلعوس، ودار البحري، وأبو صبحة، وريادي، وسلامة، والحريزي، والغزاوي.
حارة التراجمة
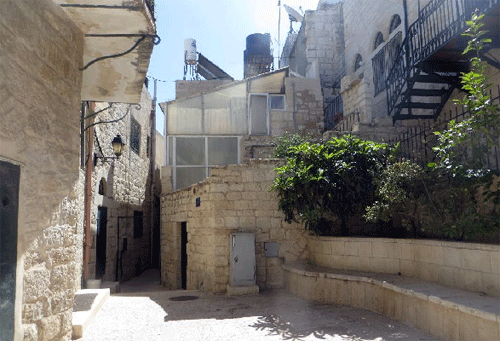
تقع حارة التراجمة غرب ساحة المهد (شمال غرب حارة الحريزات في شارع النجمة(. وقد سموا بهذا الاسم لأنهم عملوا مترجمين، وهتموا بمرافقة الحجاج والسياح الأجانب، وعملوا كأدلاء سياحيين حيث أنهم أتقنوا عدة لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية والإيطالية وغيرها؛ ويعتقد أن أصولهم فرنسية وإيطالية؛ جاء البعض منهم في بداية الفترة الفرنجية، ومن العائلات التي تسكن حارة التراجمة: دعيق، وسوادي، وأبو خليل، وميكيل، وبطارسة، ومنصور، ودبدوب، وجابرية، وصابات، وأبو جابر، وأبو العراج، وداود، وفليفل، وطلماس، وطارود، وروك، وأبو فليحة.
حارة الفواغرة

تقع حارة الفواغرة غرب ساحة المهد (من جامع الفاروق إلى سوق المدينة)، ويعتقد أن أصل قسم منهم هو كردستان العراق؛ أما القسم الآخر فقد جاء من جنوب تركيا، مع جيش صلاح الدين الأيوبي، وسكنوا قرية فاغور الواقعة جنوب غرب برك سليمان، وانتقلوا إلى المدينة في الفترة العثمانية، وتعاونوا مع مسيحيي بيت لحم للتخلص من الحكم واستبداد "الديري" (الديري هو شخص متمرد سيطر هو ورجاله على المدينة).
ويسكن هذه الحارة ثلاث حمايل هي:
- حمولة العطايات وهم : الهريمي، وشوكة، وكنعان، والزر، وأبو السرهد، وأبو فشخة، وزيادة.
- حمولة المراعشة وهم : شخطور، وشحادة، وحمد، وحميدة.
- حمولة المطور وهم : عابدة، وهرماس، وحجازي، وعايش، وعبد الله، وحميدة.
حارة القواوسة

تقع حارة القواوسة إلى الجنوب من ساحة المهد وبلدية بيت لحم، وهم قبيلة جاؤوا من تقوع جنوب بيت لحم وبنوا حارة القواوسة. سميت بالقواوسة لأن بعضهم كان يمتهن حرفة قواس (الشخص الذي يلبس الزي العثماني والطربوش، ويحمل عصًا يضرب بها الأرض ليفتح الطريق أمام البطريرك). ومن بعض العائلات التي تسكن حارة القواوسة: قواس، واجحا، ومرزوقة، وثلجية، واللوصي، وسكافي، وقرنفل، وأندونية، ومعمّر، وأبو مقحار، وعطوان.