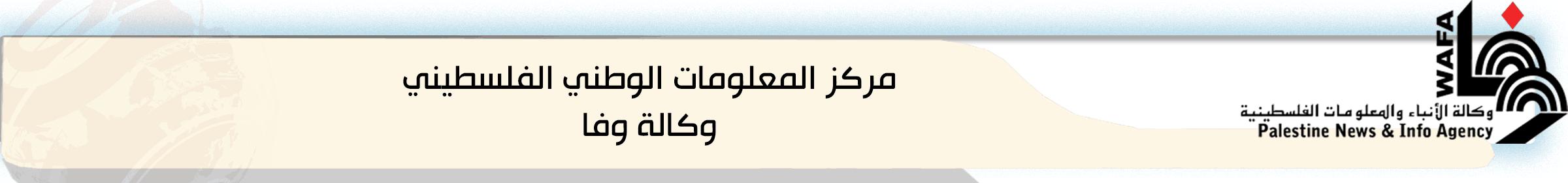تنظر حولك فترى عسلَ الضُحى يُغطّي نهارَك من أوّله! ما هذه الشجون التي تحطّ على غصون قلبك، أيها الناظر في كل الاتجاهات؟ ثمة زنجبيل يُعبئ الهواء، وثمة عملاق خرافي يُشقّق سقفَ الأرض، وينذر بدخان كثيف وغبار قاسٍ!
.. وسيخرج، بكامل رماده وعُرْيه، وستبقى انحناءته، حتى لا تضيع ملامح المدن أمام عينيه . ويرى هلع المخلوقات، وحركتهم المتوترة الحائرة -قبل أن يهدأ روعهم- فتزداد دهشته، ويحاول أن يمعن بعينيه الواسعتين، في تفاصيل الفسيفساء المتناثرة.. فيرى جنوداً بحجم البيادق، يصوّبون رصاصهم نحوه .. فينخدش لحاء ساقيه .. وتسري قشعريرة الوخز في بدنه، فيمدّ أصبعيه، بين الأزقّة، يلتقط المدجّجين، كما يلتقط فلاح يستريح في ظل كوخه، النملَ الأحمر، ويفركه بيده الخشنة .. وينهض ثانيةً ليكمل افتراع حقله بمِحراثه الصلب! دون أن يكترث ببيت النمل . لعلم هذا الفلاح الطاعن بالأرض، أن أيام الشتاء القادمة، ستدفن النمل، وسيبزغ شَعر الربيع الناعم، بثقة ويسر، وهدوء!
سندخل هذا المحيط الرملي، دون أن نخشى الغرق. فالصحراء، رغم هوامها وأفاعيها، أكثر رحمةً من سمك القِرش البحري، أو من حطم التماسيح الهائجة في المستنقعات. وفي النهاية، فإن الصحراء أكثر دماثة وشفافية من البحر - رغم أنها أقل حياة منه - غير أن كلاًّ منهما له فتنته ومنطقه وأسراره، ولكل منهما مفاتيحه وأغانيه وغوائله.
ويبدو أننا ننتمي لثقافة الصحراء؛ فكم فغرنا أفواهنا أمام بأس فرسانها المُنصفين، وجنون شعرائها العذريين، وكم غفونا على حكاياها، وعمّتنا النخلة تظللنا بجدائلها الكبيرة، حتى كنا نرهب حمام الدار إذا بغم، ظنّاً منا أن حدأة الحكاية هي تلك المستوحشة التي تهدل على شباك البيت . وربما وضعنا أيدينا الصغيرة فوق رؤوسنا، خوف أن تنقر الحدأة رؤوسَنا بمناقيرها الحاذقة.
سندخل هذه الصحراء التي يبدو أنها كانت مدناً من نحاس نخّلَتها الرياحُ وعويل الليالي، فانفرطت، واستوت رملاً ... وها نحن نطأ الرمل، لكنني أسمعُ تهاليل الوالدات، وشخب الحليب اليانع، ومناداة بائع الفاكهة السمين، واعترافات النساء خلف ستار التوبة، والرهز في بيت الأمير، وأنين حاملي الماء في الأسواق ... أسمع سقوط الكمثّرى في جدول البستان الكبير، ومنطقَ الطير، كأن العطّار النيسابوري أكمل أشعاره المتبتّلة هنا، بل هنا كان ابن القارح يدور على الشعراء من ضفّة الجنّة إلى ضفّة النار. وهنا حطّ الهدهدُ على باب سليمان، ورفعت بلقيسُ ذيلَ ثوبها خوف ماء الرخام، فانقشع البرّ وتلعثم الجان!
هنا، على هذه الصحراء استراح ذو القرنين، قبل أن يموت مخموراً بالنصر، وقتلوا لوركا دون أن تفترّ فَراشةُ القُبلة في شفتيه، تلك التي وشمتها امرأةٌ هي كل الغجريات . وهنا حطّت سفينة نوح، وابتاعت نفرتيتي الإثمد لجفنيها، وسكبوا الحمامةَ لملكة النهرين سميراميس. هنا تبلبل الخَلْق أول مرّة، وابتدأ مسمار الحضارة والكلام... وهنا نكمل، على أطلال الصدى، جبروت جدّنا عوج بن عناق، الذي كان يجلس، بالضبط هنا، فيمدّ ذراعه في البحر المتوسط، ويمسك بالحوت، ويضعه في عين الشمس، ويصطلي لذةً بالشواء.
ندخل إلى حضرة الصحراء، وما فتئت همومنا تشغلنا عن التبؤّر فيما حولنا، وإمعان النظر في هذا الفضاء الجديد. ونواصل تأثيث المكان بما نمتلكه، بالترتيب والتحديد، والتشدّد في النظافة ... ونحتاج، على ما يبدو، إلى أيام حتى نكتشف حداثة أحاسيسنا، تجاه كل ما تقع عليه عيوننا. والغريب، ربما، وبعد بضعة أسابيع، أننا نتأقلم مع المكان، حتى ننسى من أين جئنا، ولماذا، وإلى متى ... كأننا وُلدنا هنا، وخُلقنا هكذا، فجأةً، بالكيفيّة التي نحن عليها. ولا تحزّنا سكينُ الحقيقة إلاّ عندما نخلد للنوم أو لأنفسنا، أو عندما تقع حادثةٌ خارج السياق اليومي الرتيب.
كان ثمة جدارٌ سميك يلفّ المعتقل، من كل جنباته، يفصله عمّا وراءه، جدار لا يُرى، لكنه سدٌّ مانع، يحول بين الصحراء وما خلفها.
وهنا، في مدينتنا المسوّرة المغلقة، يصبح النسيان نعمةً، تمنحنا القدرة على التجدّد والمثابرة والمضاء، وتصير الغفلةُ التي طابت لنا، وسعينا إليها، بلا وعي، ربما، أوقاتاً مريحة رحبة، طالما فككنا خلالها أثواب الضيق والاختناق، عن روحنا، فتنطلق من إسارها... لعلها تتّحد مع نجمة تدفّ بفضّتها، وتنادي الروح، لتأخذها إلى بيتها... هناك، معها في البعيد.
أين الرمل في جسدي؟ ما دمتُ أعرف أن الماء والمعادن والتراب كُلّها فيه . إذاً، أين الرمل؟
أنأى بالقلب ومصادر الحواس، معتقداً أنها من تراب خصب وماء . فما الذي يبقى في الجسد؟
يبقى الكثير، ولكن، ما هي القطعة التي ستعود رملاً بعد الموت؟
ربما العظام، لأنها أقرب ما تكون لهذه الذّرات الجافة التي لا تشرب الماء، وتصرّ على عطشها إلى أبد الداهرين، بل تكره أن تكون رحماً ينشأ بينه الزرع أو الضرع .
هل يكره الرملُ الحياة والنماء؟ هل هو جماد عبثي، اكتشف مبكّراً النهايات المُفزعة، فآثر التفرّد والوحدة، وعدم التعلّق بصاحب أو شبيه؟ وهل أقول إن جفافَهُ تعبير عن رغبة في العزلة والابتعاد، وكراهية لكل ما يَنبت من البذور والجذور .. ولهذا يبتعد عنه المطرُ، يأساً من طبيعته وإصراره على الضمور واليباس، مهما أغرقه في غيثه، وبسط له من نور برقه؟
ألهذا السبب يخفّ حمل رمل الصحراء حين يغضب ربّ الرياح، فيصير جناحاً أسود من شواظ، يولول في حمأة الظهيرة، ويحطّ حيث يبدأ الموت؟
- ربّما، يصرّ الرمل على خديعة الإنسان، يبدو ناعماً، يهفت تحت الأقدام، ساحراً بثنياته اللامعة .. لكنه ماكر، يُخفي بئراً عند كل خطوة -
والرمل ذاكرة مخيفة، يدفن في طيّاته الكثير من الصهيل والنشيج والدماء والحسرات! وهو مساحات بلا أفق، تختزن الشمس والليل في معطفه . يتسلل ويرسو بطرائقه الغامضة الخاصة، يحتلّ ويسيطر، ويهبّ عند كل خريف.
والرمل موج البرّ الذي يحدّ الأشياء، يجاور البحر، ويضع له حدّاً، ولا يشبهه . والرمل يبتهج بأمثاله من الصعاليك والعشاق المشروخين . لا يطرب لناي، ولا تبكيه ربابة . حياده قاسٍ مثل صُبّاره وطيوره، وله ألوانه الذهبية المتماوجة، كأنها تجاعيد الأرض الهرمة، أو وجه الساحرة المتغضّن، التي ذهبت بعيداً في العرق والخطايا.
ولا يفوز عليه إلا الصبور المُجْتَرّ أو الثعلب الحديد، عليه يُقام الخباء - كأنه يختبئ من القيظ والصلّ والهجير - ليهيّئ للظبية خدرها وعطر السوسن والسامر المجروح.
والرمل مزاجيّ متقلّب، يَملّ الثبات مثل صدر اللعوب، يشبه الكابوس وفسحة اليأس، أو كأنه وَهْمٌ من وَهْم، تمسكه فينثال من بين أصابعك كالماء الحُرّ، يساجل الواحات، ويتسع للثأر، وسخريته دائمة، تشعّ بالسراب . لا وجه للرمل ولا فؤاد.
والرمل شاهد إثبات على تحوّل الكرة الأرضية، من مرحلة الغابة، إلى ما هي عليه الآن، من يباب وأخاديد عذاب. يدفن تحته قارّات من الأشجار والأعمار، اختزنها تحت أقدامه، حتى تخمّرت فأصبحت سائلاً هائلاً، يعيد تشكيل سطح الأرض من جديد.
الرمل، باختصار، مخادع، فقير ويائس . تَذرْذرَ لفرط وحدته، وجفاف ينبوع دموعه .. فَفَقَد الحياة.
وعلى رمل هذه الصحراء سنقدّ من عُمْرنا سنواتٍ ودموعاً وأحلام يقظة، وسنخرج من دُرّاعتها أكثر صلابة ووهجاً وقوة، كأنها مخرطة أخذت شوائب الشحم واللحم، وصبّت فينا الشمس والقمر والأغاني الصعبة . وسنرى الخيام، بعد عقد من الزمان، كأنها بقايا حلم خفيف، حطّت على أرض رخوة، ثم أخذها باشق عظيم تحت جناحيه، وألقاها في النسيان.
وها نحن نتذكر، كل نأمةٍ ونشيدٍ وقيدٍ ولمعةِ جوعٍ وغضب، حتى يعلم القادمون كم كانت هذه الفلسطين مُبهظة ونفيسة، وكم كان الاحتلال خارجاً على كل الصفات والنواميس والضمائر .. وكم كان زماننا مشوّهاً .. وعبقرياً.
وعلى رمل هذه الصحراء، لن نرى إلاّ قوافل الحديد. وسنتخيّل كيف أن قافلة، في المغيب، تمرّ أمامنا، فنراها مثل خيال عرائس الأراجوز، تتمايل وسطها الهوادج، ونسمع حُداءها من بعيد، وستقترب القافلة مع الشروق، وتمرق قرب السياج، فتظهر أثواب الجِمال وسروج الخيل الضامرة السريعة . وخلفها يخبّ العبيد والحرّاس بجسومهم الممشوقة كأنها سهام من حديد، وسنرى الكلاب تهرّ خلف الخِفاف وحول الأظلاف، بعصبيتها وبحثها عن اللاّ شيء . وربما نتخيّل عصابة من فرسان الطوارق الملثمين، اتقاء هبوب الرمل على وجوههم، فيتوقفون حال رؤيتنا، ويعجبون لأننا مثل نسائهم، دون لثام! وربما نوقد ناراً وسط الساحة، دون حطب، ليَطرقنا أبناء السبيل، ونهمس لبعضنا حتى نتمّم واجب القِرى والمبيت . بل سيقوم شيخ منّا ويصعد بنظره إلى السماء الشاسعة المكشوفة، ويشير بعصاه إلى طرق الصحراء، الموصولة من نجمٍ إلى أخيه .. وقد نتقمّص أجدادنا البعيدين، الذين أتوا بنا من كوكبهم الرمليّ، وثاراتهم القبيحة، إلى سواحل بلاد الشام، وأبقوا جيباً صحراوياً هو صحراء النقب، قريباً من بيوتنا حتى لا ننسى جذرنا الأول؛ الجزيرة العربية .. لكننا، وفي كل الأحوال، سنرى حبّات الرمل المفككة، والمتفرّدة المنفصلة عن باقي الحبيبات، وسندرك خسارة هذا التفكك، ونعي حيوية أن نتماسك، وأن لا نشبه الرمل، بل نكون سبيكة ذهبية، عزيزة على التشظّي والانفراط.
لقد كانت انتفاضة كاملة!
اليوم، يكون قد مرّ على انفجارها العبقري أكثر من اثنتي عشرة سنة، وها نحن نشهد، اليوم، ميلاد انتفاضة جديدة، اسمها انتفاضة الأقصى أو الاستقلال .. لا فرق . والشيء بالشيء يُذكر.
تلك انتفاضة كاملة!
كان الفهد خارجاً بكامل سخونته، من الغابة البكْر، يحمل قلب الريح، كأنه عاهل العاصفة، كان ريّاناً، مُشْبَعاً بغضب الأشجار التي ماتت واقفة، ولم تركع! وكان صمته قِطَعاً من غضب الليل الذي كَنَس البساطير الثقيلة من ليل المدن والقرى، وجعل يقظة الخوف أبديةً في حدقات الخونة والجنود .
تلك كانت انتفاضة . أما انتفاضة هذا العام فإنها سبعٌ روّضته البيوت، وأطلقته على الدخلاء. أما تلك فكانت فهداً بريّاً، له أناقة البرق وإغواء الغزال.
هذه صوت الرأس، أما تلك فكانت شعلة الجسد كلّه.
تلك كانت زفّة واحدة أو جنازة واحدة، أو بالأحرى كانتا متداخلتين إلى درجة اختلاط الدمع بالحبق، وملوحة عرق الأعراف بعسل شهد الفرس.
تلك كانت صيحة إسرافيل الفلسطيني، الذي أيقظ الحجر والشجر والطير والينبوع، أما هذه فصحوة الجسد من خَدَر العملية الجراحية الفاشلة.
تلك كانت غيث كانون الواضح، أما هذه فهي تردد الغيمة في عباءة العاصفة.
تلك كانت البداهة والبديهة، أما هذه فإنها صنعة الثوب الكنعاني المطرّز.
تلك كانت الدخول الحاسم إلى بهاء الموت برضى كامل، أما هذه فالحسابات تزاحم المشهد الذي يشدّك إلى أن تغسل الأرض، كل الأرض بوريدك الكريم .
تلك تاج المليحات، وأم الحكايات، وقصّة الراوي الذي لن تنتهي لياليه . أما هذه فهي مسرحية الكاتب المسلّح الناضج، الذي تقلّب على سفّود الجمر، وما فتئت تأكل كبده ليل نهار.
تلك لحم التفاحة الأحلى، وليلة الدخلة التي لن ننسى لذعة السوسن فيها، أو حُرقة عجين ورقة الليمون، وصخب أغنيات الأهل الفرحين، أما هذه فهي زواج الوردة للمدى الدامي، في فضاء قاعة المدعوين والشهود.
تلك شهوة الزيت، وانفعال الشفتين، ورضى الزوجات عن الغياب المليء بالدوالي والرسوخ. أما هذه فإنها البهجة بالموت العالي، والفجيعة باللوعة المجانيّة .. أحياناً.
وتلك مقابسات ليالي القبر التي أشرقت بالجنين الرسولي، أما هذه فهي نهضةُ الفتى لتكتمل دروسه، وتصحو مداركه.
يغيب الآن الموسم كله، بإرهاصاته، وحلقاته وأسواقه وتجمعاته! وتحضر هندسة الحرب، لتبعدنا أكثر عن فِطرة ما كان في ذلك الموسم من حالات وحكايات . كأن الناس كانوا في موسم قطف الزيتون، أو بناء معبد كبير، أو كأنما يريدون تحويل نهر عظيم عن مجراه، أو إزاحة البحر إلى الوراء .. لهذا لم يتأخّر أحد! كان الرجال أطفالاً وشباناً وشيوخاً في الحقل أو البرّ، وكانت النساء يكملن أعمالهن في البيت دون توقّف!
ولعل التاريخ لم يشهد حالة انشغال دائبة مثل التي كانت، أيام تلك الانتفاضة الكبرى - ولا أقول الأولى - هذه الانتفاضة قيّدت الكثير من الناس، واقتصر فعلها على جيل محدد، يتمتع بلياقة رمي الحجارة واستعمال المقلاع، أو على المُدَرّبين جيداً على استخدام السلاح والرشاشات، ما جعل الكثيرين، وبالتحديد القاطنون في المدن المحررة "المناطق أ"، يبحثون عن دور مباشر لهم في هذه الانتفاضة، فلا يجدونه! مما جعل الكثيرين يرزحون تحت وطأة ضميرهم وسؤاله القاسي الممض، وهم يرون الشبان الصغار يبتلعون أدوارهم، ويتربعون على عرش المشهد السخيّ الجريء.
كما أن المرأة تراجع دورها كثيراً، ولم تهيئ لها هذه الانتفاضة ذلك الدور الواسع العملاق الذي وفّرته لها تلك الانتفاضة، حيث حلّت المرأة مكان زوجها الذي اعتقلوه، فأصبحت أماً وأباً، وعمّق حضورها ذلك الدور الاجتماعي المشرّف الذي ظهر في تشييع الجنازات التي طالما انتهت باشتباك طاحن مع جنود الاحتلال، وفي عيادة الجرحى، ومواساة العائلات الثكلى، وزراعة المساكب والخضروات، وتطوير الاقتصاد البيتي ..
ولم نسمع أحداً يسأل عن مصير أُسرته، وهو في حمأة الزنازين، أو في عين المتراس الحمراء .. ولم يخلع الناس - آنذاك - التطهريّة التي تليق بالأولياء والفلاحين البعيدين .. ولم يسقط رجل في إغراء المقارنة بين الطبقة المستريحة الحريرية، التي تشكلت في السنوات الأخيرة، وبين أحوال الدهماء أو الرعاع -هكذا يسميّهم البعض-، وينظر إليهم على أنهم ليسوا أكثر من حطب، يصلح للاشتعال تحت طنجرة السياسة حتى تنضج، وبالتالي لا يأكل منها إلاّ الطبّاخون المعلمون، أو المَهَرة.
وفي تلك الأيام، كان الانضباط أعلى، في السنوات الثلاث الأولى، وكان جدار الانتفاضة صلباً، لم تخترقه الأصابع الخفية المدسوسة، أو الشائعات السوداء . وكان الاستنفار كاملاً، ولهفة الناس حاسمة، حيث نكشوا حواكير بيوتهم وزرعوها، ورموا المنتجات الاسرائيلية، وكانوا أكثر قناعة بالتقشف الحقيقي الذي فاق زهد الرهبان في الجبال الجرداء، ولم تكن -حينها- تلك المجموعة التي تدبّ الآن بين الناس، تشدّها مصلحتها -بصفتها كمبرادور يستورد البضائع الإسرائيلية، أو وكلاء لكبرى شركات الدولة العبرية- أو يدفعها طموحها الأجوف -بصفتها، كما ترى نفسها، مؤهلة لوراثة الحكم، أو من أولي الأمر الذين يجب أن يصنعوا القرارات المصيرية للشعب والقضية-.
وفي تلك السنوات، كانت عبقرية الانتفاضة تتمثل في تحييد أسلحة الاحتلال الثقيلة، باعتمادها على الحجر والمولوتوف، كما تتمثل - أيضاً - بالالتزام الحديدي والدقيق بالقرارات التي كانت تصدرها القيادة الوطنية الموحدة عبر بياناتها آنذاك.
أيام الانتفاضة الكبرى كان لها لون واحد هو الأبيض الذي يسعى للانتصار على الأسود بكل مكوناته ومصادره . ولم يدخل الرماد إلاّ بعد ثلاث سنوات أو أكثر، من بدء ذلك الانفجار العبقري الواسع والعميق.
في تلك الأيام، كانت روح الجندي المجهول تمور في ضلوع كل الناس، فكان التكاتف والتكامل والتكافل قد وصل إلى أقصى صوره ودرجاته، إلى حدّ أستطيع أن أقول، دون مبالغة: إن المليونين ونصف المليون فلسطيني في الضفة والقطاع كانوا أُسرة واحدة، فالأب للجميع، والأم والدة كل الأبناء والبنات، والأولاد أشقاء نزلوا من مجرى واحد وعسيلة واحدة، يتشابهون إلى حدّ التوأمة، ويتسامحون إلى أن أصبح الإيثار لغة منحوتة، لا يغلبها قولٌ مشبوه أو صراخ حاسد.
تلك الانتفاضة غسلت الجسد الواحد، من كل أدرانه وشوائبه، بعد أن صهرته في مرجل هائل، وسكبته لامعاً مضيئاً، لا طريق له إلا الأمام، بعد أن أحرقت، هنا وهناك، تلك الجيوب المُعيبة؛ سواء أكانت بؤرة للمخدرات، أم السقوط الأخلاقي، أم علبة لليل القاصف، أم بقعة كريهة متصلة بالاحتلال، أم الشقاوة المريبة. تلك كانت التاج الذي أكمل حجارته المسحورة، والعُرسَ الذي اكتمل إلى حدّ المعجزة، والحجر الخرافي الذي حكّ هواء الفولاذ، فدبّت النار في هشيم الدنيا، وفهقت السماء بنجومها، فغاب الليلُ .. إلاّ قليلاً .. بانتظار الشروق الكبير.
لم تذكر رقمي تلك "الشحرورة" السمراء! فانتبه المعتقلون، في كل الأقسام، إلى البنطال الكاكي المحشور بلحمها وهي عائدة، تحمل أوراق الإفراج عن عددٍ من المعتقلين. وليس غريباً، ربما، أن ينتبه المعتقلون والأسرى، إلى مفاتنها المتواضعة، وهي قادمة، تخبّ، نحو بوابات الأقسام، لتنادي على "الأرقام" التي سيتم الإفراج عنها.
والشحرورة هذه، امرأة قصيرة مكتنزة سمراء، لعلها من جذر يمنيّ أو من الفلاشا الذين وجدوا أنفسهم على تلال "يهودا والسامرة" فأصبحوا بشراً! ولقد أطلق المعتقلون اسم "شحرورة" عليها لأنها تُشحرر المعتقلين. واللفظة آتية من كلمة "شحرور" العبرية، ومعناها حرية أو إفراج أو إطلاق سراح!
ولعل إدارة المعتقل وضعت هذه الشحرورة مرسالاً "يُبشّر" السجناء، بعد طول اعتقال، بفرج العودة إلى المرأة والبيت، أو بالأحرى لتكون مصيدة للقليلين من ضعاف النفوس المكبوتين الذين يرون فيها كل الأنوثة والدلال!
ولطالما مشت الشحرورة بين أقسام معتقل
"أنصار 3"، أو ما يُسميه الإسرائيليون "كتسيعوت"، حيث كان كتسيعوت هذا مبنىً متواضعاً بناه البريطانيون أيام انتدابهم لفلسطين، ليكون مركزاً يشرف على الحدود الفلسطينية المصرية، واستلمه الإسرائيليون، فجعلوه ساحة إعدام للجنود المصريين الأسرى عام 1956، وعام نكسة 1967، وعندها كان اسمه "كيلي شيفع" أو السجن السابع. وثمة رأي يقول: إن أصل هذا المعتقل يعود إلى أيام الامبراطورية العثمانية، حيث أقام الأتراك مركزاً لحماية القوافل المتجهة من مصر إلى بلاد الشام، وكان هذا المركز يدعى "نقطة الحفرة" أو "مركز الجورة" أو "سجن الحفرة" أو ما إلى ذلك.
التاريخ يعيد نفسه، بشكل مُكْلِف، على مَنْ لا يقرأه، أما هنا في "أنصار 3"، فالتاريخ ثيّب، جربناه وطلّقناه، وحاول أن يعود بِكْراً، حتى ننزف من جديد، أو نسوق أغنامنا في جبال الضبع، كأننا رعاة عميان!! ومهما يكن من اختلاف، فالسجن سجن، الهدف واحد والحوذيّ الساديّ لم يتغيّر، والنهر لم يبدّل ماءه، بل إن السابح لم يخلع ثوبه كالأفاعي، ومع ذلك، لِتَلْهُ الأيام كما شاءت بالدُمى التي تقطّعها في العتمة، بالمقصّ، فتخرج في النهاية ناقصة ذراعاً أو ساقاً .. لا بأس، فنحن لسنا دُمْية، وحتى لو اعتبرونا كذلك، فإن لهذه الدُمْية رأساً، على الأقل، وشفتين حمراوين، كما يقول شارلز سيميك.
في آذار 1988، ومع ازدياد أعداد المعتقلين الفلسطينيين إثر تفجّر الانتفاضة، اضطرت الدولة العبرية لبناء سجون جديدة على شاكلة معتقلات النازية، فالفكر الشوفيني يعيد نفسه دائماً، وكأن التاريخ يفقد دوره وحكمته لدى سدنة هذا الفكر، وتبدو العنصرية في التاريخ خارج حدود القيمة الروحية أو الأخلاقية، وتدخل حدود المرض الذي له أعراض معينة ومدونة، منها استعمالها المفرط والعصبي لكل أنواع القوة وغرورها وأشكالها، فهي سرعان ما تقتل وتقمع وتبني السجون ومراكز الاعتقال والتعذيب، فمهّدت الرمال المحيطة بـ "السجن السابع"، وضربت اثنتي عشرة خيمة في كل قسم، ستاً مقابل ست، وبينهما مساحة تمتد إلى عشرين متراً. وكل قسم محاط بثلاثة جدران من السياج الشائكة، تفصل مسافة متر أو أكثر بين كل سياج وسياج، حيث يرتفع السياج أكثر من عشرة أمتار، والأسيجة متقاربة ومتراصّة في الجدار الواحد، حتى أن طيراً قد لا يستطيع الدخول من بين السلك وأخيه! ودفعت إدارة السجن إلى كل قسم مئتين وأربعين معتقلاً، موزعين بالتساوي على الخيمات الاثنتي عشرة، ليصبح نصيب كل خيمة عشرين سجيناً، يحمل كل منهم أربع بطّانيات وقطعة جلد بحجم الإنسان تسمى "البُرش" يفرشها السجين تحت بطّانية هي فرشته، وبطّانية أُخرى يجعلها وسادة، وتبقى بطانيتان، هما غطاء المعتقل في ليل وشتاء الصحراء القارس الذي "يقصّ" المسمار!
وقد جعلت إدارة "كتسيعوت" ستة أقسام في كل وحدة أو مجموعة، حيث ترى شارعاً رملياً بعرض خمسة أمتار بين كل قسم وقسم، أي أن كل مجموعة أو وحدة تحتوي على ألف وخمسمئة معتقل ... وبالطبع، كان هناك خمس وحدات هي كل "أنصار 3" أو "كتسيعوت"، أو ما يزيد على سبعة آلاف وخمسمئة معتقل.
ولمّا أدركت إسرائيل أن الانتفاضة ستستمر، وأن "حبالها طوال" راحت تُكرّس هذا المعتقل، وتحيله سجناً مركزياً، فأمرت بتعبيد أرضية الأقسام والشوارع التي تحيط بها، وأبدلت الحفرة العميقة المحاطة بألواح زنك، وأرضيتها ألواح خشبية، في وسطها فتحات، هي المراحيض ... راحت تبني حفراً أسمنتية جعلتها مراحيض وحمامات للسجناء.. وظل المعتقلون الداخلون، لقضاء حاجاتهم، يرون بحر الوسخ المترجرج المقرف الذي ينداح تحتهم، وتصلهم طراطيشه، بين الحين والآخر.
ما أن تضع قدميك على العوارض الخشبية، وتبدأ بفكّ أزرار بنطالك، لتقرفص فوق الفتحة الواسعة، لتقضي حاجتك .. ويخرج من باب بدنك ما اختزن في أمعائك من طعام تافه، حتى يبدأ خيالك يذهب بك إلى سيناريو الوقوع في المستنقع المضطرب الذي يموج تحتك ... يا إلهي!!
تخيّل لو زحلقت أو زلّت قدمك، وسقطتَ إلى الأسفل؟!!
ماذا سيكون مصيرك؟
الموت في حفرة المجاري!؟
أية مِيتَة هذه ؟!
انتبه، إذاً! وثبّت قدميك، وانتبه وأنت تشطف بإبريق الماء قحفتك المسموطة ..
تخرج من المرحاض، وبقعة الماء بادية على مؤخرة بنطالك .. وتسرع إلى ماسورة الماء وقطعة الصابون تفركها، وتغسل يديك .. وتنفضهما في الهواء، أو تمررهما على جنبات قميصك، وتحمد الله أنك لم تمت، حتى الآن، في تلك الحفرة المهولة!
ولكن، مَنْ يدري ما الذي سيجري في المرّة القادمة؟
(حالما بدأ "سوان" في التعرّف على "أوديت"، بدأ يشك فيها)، وأنتِ أيتها الصحراء! منذ أن وصلناك، هاجمتنا الكآبة مثل كلبة مجنونة، تقف أمامنا، تغلق الطريق بلهاثها المبلول الأحمر، فنرجع للوراء قليلاً، حتى نتحفّز، ونجد طريقاً آخر بعيداً عن نشيجها المسعور، أو نمدّ ذراعنا في فمها، حتى نقبض قلبها الحامض، وفي الحالتين يراودنا إحساس بأننا في الفراغ، خارج الزمان والمكان.
هذه هي المرة الثالثة التي أُساق فيها إلى "كتسيعوت". كان ذلك في صيف 1989، حيث قضيت عاماً كاملاً قبل ذلك، امتد حتى ربيع 1989، حين جاءت الشحرورة، ورطنت برقمي ضمن أرقام المُفرج عنهم.
والآن، أنا في معسكر الظاهرية المُرعب، قضيت فيه، هذه المرّة، عشرة أيام، لم أغسل فيها يدي أو وجهي، ولم أتناول خلالها سوى خبز "الفينو" والماء، وبعض حبّات من الرزّ، فالغرفة التي كنتُ فيها مع ثلاثين فتىً ورجلاً، لم تكن تتسع لأكثر من خمسة عشر، وكان علينا أن نقضي حاجتنا، في برميل بلاستيكي يطفح بالوسخ، ويترنح أحياناً تحت مَنْ يجلس فوق فوهته المقززة... فينقلب، وكثيراً ما انقلب، فتمتلئ الغرفة والبطانيّات بالوسخ والفضلات والنتن الخانق، لهذا، كُنّا نُفضّل ألاّ نأكل، وأن نشرب ماءً كثيراً، وتحوّل الاغتسال إلى رفاهية حالمة لاستحالة ذلك، ولعدم وجود صابون أو شامبو!!
للغرفة، في معتقل الظاهرية، بابٌ حديدي مُغطىً بصفيح حديدي سميك، حتى لا تكاد ذرّة الهواء تدخل إلى الغرفة! لكن هذا الباب عبارة عن جرس تنبيه، يذكّرنا بقدوم الجنود إلى الغرفة واقتحامها، إذ لم يتخلَّ الجنود عن عاداتهم القبيحة، والتي كان من ضمنها أن يركلوا الباب الحديد ببساطيرهم، فيُحدث ايقاعاً خَشناً، أو فرقعة مدويّة .. تبعاً للركْلَة! وعندها علينا، نحن المعتقلين الثلاثين، أن نقف فور سماع الركْلة، ونوجّه وجوهنا للحائط، ونرفع أيدينا إلى الأعلى، دون أن ننبس ببنت شفه!
وعندما ينشقّ الباب، ونرى جناح النهار، علينا أن نقول بصوت جماعي واحد "موخانيم يا كابتن" .. فيقوم الجنود بإحصائنا، والتأكد من أن أحداً لم يهرب!!. وقبل أن ينصرفوا وينغلق الباب، لا بُدّ من صفعة هنا أو ركلة تحت الظهر هناك، أو بصقة أو شتيمة..
يتنفسّ المعتقلون الصعداء! ويحمدون الله أنهم ما زالوا "موخانيم"، أي "جاهزين"؛ للعدّ والإحصاء، ورفع الأيدي والتوجّه إلى الجدار، وقَوْل "نَعمَ" بعد ذكر رقم السجين، وسبّ كل شيء..
وكان يمكن لهذا الموقف أن يكون عادياً جداً، السجانون يعدّوننا لدواعٍ أمنية، ولكني أعترف هنا أن ذلك لم يكن كذلك، لم يكن يتم بهذه الصورة الروتينية العادية.
كان الموقف فيه تعمد الإذلال والإهانة، كان يقصد من صياحنا الجماعي أن نتحول إلى قطيع لا يعرف سوى أننا "موخانيم" .
"موخانيم" لكل شيء،
لركلة غير متوقعة،
لعصا من هذا الجندي أو ذاك؟
لرصاصة حاقدة،
لسخرية من مجندة "بنت هوى" دخلت مع ضابط الساحة المكلّف بعدّنا؟
كان هذا الموقف يملأني بالحقد الأسود والأعمى، والجنون الذي يمنعني من فتح فمي والصياح "موخانيم يا كابتن" ..
ودفعني الجنون ذات مرة إلى القول للضابط ".. .. أُختك يا كابتن"، وحمدت الله أن الكابتن لم يسمع .. وإلا لفعل بنا الأفاعيل ..
كان الزملاء يصيحون "موخانيم يا كابتن" فيتفطّر قلبي.
نادى الجنود علينا عصر ذلك اليوم، وخرجنا من الغرفة، وللحظة الأولى، لم نستطع أن نرى شيئاً، لأننا لم نر الشمس طيلة تلك الفترة، وبعد حين وقفنا بعضنا خلف بعض، وكنّا أكثر من مئة سجين، نادوا علينا كأرقام، والويل، كل الويل، لمن نسي اسمه الذي هو رقم وأعداد، -والغريب أن لكل رقم معادلة تكتشفها مع الوقت، أو سِرّاً له دلالة ما!-
وبعد ساعتين، ربطوا كل اثنين بكلبشة واحدة، اليد اليمنى لسجين مع اليد اليسرى لسجين آخر... وزجّوا بنا في موقف سيارات مُغطىً بالزنك، وكان علينا أن نظل واقفين حتى تحضر الحافلات، وتنقلنا معصوبي العيون مقيدين إلى مصيرنا المحتوم ... إلى "أنصار 3". وبقينا ننتظر حتى صباح اليوم التالي! فهل أخبركم كيف أمضينا تلك الليلة واقفين مثل الأفيال أو الأشجار؟ .. والجنود النزقون يحيطون بنا، وينتظرون مَنْ سيقع منا، ليتسلّوا عليه ضرباً ولطماً وركلات في كل مكان!!
صعدنا إلى الحافلات، وكان زميلي في الكلبشة الأخ "نبهان خريشة" الذي تيسّر لي أن أتعرّف إليه منذ ثلاثة عشر عاماً، أيام كنّا طلاباً في جامعة بيرزيت .. وكان - بحق- جسوراً، ومعنوياته عالية، مما أدخل الطمأنينة والبهجة إلى ضلوعي.
صعدنا إلى الباص، وأَجْلسَنا الجنودُ على المقاعد، وراحوا يعصبون أعيننا بشرائط من القماش الكاكي السميك، حتى لا نرى أو نعرف إلى أين نمضي كجزء لا يتجزأ من الحرب النفسية لهدم معنويات المعتقلين. وعندما اكتمل الجلوس، راحوا ينادون على أرقامنا التي هي أسماؤنا، ونجيب بـ "موجود" ... وتتحرك الحافلة، وتصل إلى مشارف "كيلي شيفع" عصراً!
لقد مرّ يوم كامل دون أكل أو نوم. لا بأس ... وتدخل الحافلة إلى باحة رملية تنتهي بـ "كرفان" أو غرفة جاهزة، يجلس فيها ضابط ومعه، طبعاً، الشحرورة تلك، وطبيب، وعشرات الجنود يحيطون بالباحة. ويأمرنا الجنود أن نهبط من الحافلة، بعد أن يزيحوا العصبة عن العيون، فنهبط مثلما صعدنا.. ونصطف طوابير بعضنا خلف بعض، فيقرأون علينا، ثانية، أسماءنا الرقمية، ونقول "موجود" ثم يفكّون الكلبشات، ويتقدم كل واحد منّا بمفرده نحو الطبيب الذي يسألنا إن كان يُعاني من مرض أو مصيبة.. والجواب، طبعاً لا يهم الطبيب؛ فعنده جواب واحد هو المقبول وهو"لا يوجد به مرض!"
ثم نمضي خلف "الكرفان"، واحداً واحداً، ونخلع كل شيء عدا الملابس الداخلية، ويعطوننا قميصاً برتقالي اللون وبنطالاً كحلياً باهتاً، دون أن ينتبه الجندي إلى حجم السجين ونُمرة لباسه.. (فهناك في الأقسام بدّلوا فيما بينكم)، يقول الجندي. حسناً أيّها الجندي. ثم نتجه صوب الشحرورة التي تجلس خلف طاولة خشبية متهالكة، وتقول كلمتها المعهودة: اقعد على طيزك يا خيوان!! فنقعد على أقفيتنا مقرفصين، ومنظرنا يدعو للضحك المبكي، فكيف لواحد مثلي يلبس نُمرة خمسين، يتسلّم ويلبس بنطالاً نمرته أربعون، وعليّ طبعاً أن ألبسه.. حتى ولو أدخلت ساقيّ فيه بالقوة... وبقي الجذع فالتاً دون غطاء!!
نقعد على "قفانا" كما أمرت الشحرورة، وتسألنا عدة أسئلة: اسمك؟ عمرك؟ بلدك؟ هل سجنت قبل الآن؟ أين؟ ثم تعطيك رقماً جديداً هو اسمك الجديد في "كتسيعوت"... وبعد أن ينهي المئة معتقل هذه الإجراءات يكون الليل قد امتد إلى نصفه.. فيأخذنا الجنود طابوراً واحداً، أيادينا خارج جيوبنا، ممنوعين من الكلام أو حتى النحنحة.. ويوزعوننا على الأقسام، ليتسلّمنا جنود آخرون، يسوقوننا خلف بعضنا، كلٌ في قسمه... وبالطبع، مرّ وقت توزيع العشاء .. وعلينا أن ننتظر وجبة الفطور عدة ساعات أُخرى.
يستقبلنا المعتقلون، فمَنْ كان نزيلاً، هنا، قبل اليوم فإن الزفّة تكون من نصيبه، وأما مَنْ يدخل "أنصار 3" أول مرة، فثمة لجنة وطنية في كل قسم تتعهد الأخوة والرفاق الجدد؛ توزّعهم على الخيام حسب أعمارهم وانتمائهم السياسي والجغرافي ومستواهم التعليمي والثقافي، حيث تتم مراعاة التوازن في التوزيع، ويجلسونهم في حلقة، ويتولّى مسؤول اللجنة شرح الوضع وكيفية الحياة في هذا المعتقل، بما يُدخل الطمأنينة والثبات في قلوب الوافدين.
هنا تتكرّس بشخصياتك الثلاث! لكن، يجب أن تحذر، فإن وجودك أربعاً وعشرين ساعة طيلة اليوم، في حيّز محدود، فيما ستضطر لأنْ تمارس كل أشيائك .. سيعني أن جانباً من شخصيتك الأولى ستنكشف، وسيراك الآخرون، مثلما تراهم، نصف عراة، كمقدمة لُعرْي يوم القيامة القادم!
شخصيتك الأولى هي أنتَ كما أنتَ، كما ترى نفسك وحدك أمام المرآة، أو المرأة التي أطلت الحياة معها، أو كما ولدتك المرأة الأُم!
ولكي تُغطي ثغرات الأولى، عليك أن تلبس قناعك المُهذّب الأنيق .. لتصبح مقبولاً..! والقناع إما إسقاط أو تبرير أو كل آليات التعويض أو الارتكاس أو...
أما ما تصبو إليه، وما ترغب أن تكونه، لتتطابق مع النموذج المثالي، فهو شهوتك الدائمة، ورغبتك الباقية.. وهي شخصيتك الثالثة.
وبقدر ما تتخلص من قناعك، وتعيش بشخصيتك الأولى، بقدر ما تكون صادقاً ومعافىً وحقيقياً .. لكننا يا صديقي، مضطرون لأنْ نكون بعضنا مرايا بعض .. فلا بأس!!
.. لهذا يقولون إن السَفَر أو السجن يُعرّف الناس بعضهم ببعض، ويكشف المعادن!! والحقيقة الأكيدة هي أننا عرفنا بعضنا جيداً، وتم فرزنا جيداً .. فشكراً لغربال السجن هذا، وسحقاً له .. أيضاً.
يا شماتة الأصحاب! ما أن رأوني أحمل بطانيّاتي، وأطلّ برأسي.. حتى تنادوا.. وقالوا: رجع المتوكلّ... هيه... ويصطف الأصدقاء والمعارف خلف السياج "الشيك"... كأنّهم يستقبلونني، ضاحكين، مازحين، شاكرين الله أن أعادني إليهم!! وبالطبع يسأل أحدهم عن "الوضع" خارج السجن، وآخر يسأل عن "البلد" وآخر عن "فلان" ... إلخ، لكنني بالتأكيد أكتفي بهزّ رأسي، ضاحكاً دون صوت... حتى لا أمضي الليلة في الزنزانة عقاباً على "كلامي" معهم!
يريدنا الاحتلال الإسرائيلي، أن نصبح جزءاً من هذه الصحراء، إحدى فسيفساء التوحّش فيها، ولو كنتُ وحدي في هذه الصحراء، فربما أصير ذئباً يطأ الحنظل والعوسج، ويضرب بمخالبه جحور الضبّ، وتتهدل أكتافه، وتزهر عيونه كالمواقد، ويبدأ أنفه، بخنفرته الخشنة، يشمشم آثار الرمم، وبول البقر الوحشي. لكنني لستُ وحدي، لأن هذا الحراك البشري يُكرّس آدميتي ويبقيني بشراً، رغم مصارعة هذا التنّين الذي له ألف رأس من الرمل والرصاص والسياج .. تُطالعنا أنّى تحركنا أو غفونا أو أكلنا، وتظل الكلمة والصرخة فزّاعتين تُبعدان الوحش الذي يضرب رؤوسه في بعضها، فتُحدث زلزالاً مُريباً، يوقظ وحوشاً جديدة، تُخرج رؤوسها من تحت الرمال.. وتحاول أن تحاصرنا، فنصرخ.. لنظل بشراً، نطأ الأرض المُمهّدة، ونغفو على زهرة سوسن، تتراءى لنا من بين الرؤوس.
تستيقظ مرهقاً، كأن تعب الزمان كلّه حلّ في بدنك، تقوم متثاقلاً، تغسل وجهك كأنك تصفعه بالماء البارد .. وتجلس بلا مبالاة على الأرض، دون اكتراث، ولا تنظر لشيء .. كأنك وحيدٌ على قمة هرم من الغبار اللامتناهي .. ويمضي الجنود، ويجيء الفطور .. فلا تأكل! ثمة حجر خشن يسدّ بلعومك! تنهض، بعد أن تبلّ جرعةُ شاي جفافَ فمك، وتشعل سيجارة "أُسكت" .. وتمضي إلى الخيمة، تعيد فرْش البطانيات، وتسقط على وجهك في نوبة بكاء، تحاول أن تخفيه، بأن تغمر وجهك في البطانيّة الوسادة، حتى يدخل أحد الأصدقاء، ويسمع نهنهة صدرك، واضطراب رأسك المهتزّ .. يقترب منك.. ويمسّد شعرك، فتنهض، محاولاً إخفاء وجهك، وبكُمّ قميصك تمسح دموعك .. فيشعل لك سيجارة ويعطيك إياها .. ويسود صمت كاوٍ ..
تحاول أن تنظر إلى عينيه، فتجد ماءً زجاجياً يبرق فيهما..
- لماذا نعود إلى هذا المعتقل؟
الظُلْم ثقيل .. ثقيل .. ثقيل ..
في أيار من العام الماضي أي عام 1988، كنتُ قد خرجت من فترة "التحقيق المركزي" في أقسام المخابرات في طولكرم ونابلس، وكان طبيعياً أن تنمو لحيتي وشعري وأظفاري، وأنا في "الخزانة" و "الإكس" مدة ثمانية وسبعين يوماً، ابتدأت من نهاية شباط حتى مطلع أيار، رأيت فيها ما يدور في القبر بعد الموت! بعدها تمّ تحويلي إلى الاعتقال الإداري، حيث تم نقلي من زنازين سجن نابلس إلى معتقل الفارعة المهول، الذي كان إسطبلاً لخيول الانتداب والجيش الأردني، ثم أصبح زنازين لخدمة شهوة اليهود الساديّة. فما أن تدخل معتقل الفارعة حتى يتلقاك الجنود بهراواتهم، قبل أن ينزعوا العصبة عن عينيك، وبعد "حفلة الاستقبال" (الضرب مدة ساعة) يتلقّاك الطبيب والجنود، ... يسألونك، ثم يعطونك رقماً - اسماً جديداً.... ثم تذهب إلى "ساحة الشبح"، وهي مساحة تقدر بنصف دونم، يأمرك الجنود، وقد أحكموا الكلبشات حول معصميك، أن تقف آخر الساحة، مقابل جدار اسمنتي، وعليك أن ترفع يديك إلى الأعلى وكذلك أحد ساقيك .. والويل كل الويل لو أنزلت يدك أو رجلك . فالمسموح هو تبديل الساق بالساق الأخرى فقط! .. وتبقى مشبوحاً هكذا مدة لا تقل عن يومين كاملين دون طعام أو شراب، والوجبة الدائمة هي اللطم والهراوة، والبُسْطار الذي يُلصقك بالحائط. ولزيادة وجبة العذاب والإهانة، فإنه ليس من المستغرب أن يرمي الحراس فوقك قشر البطيخ أو قاذورات أخرى مختلفة، ولكنك تتوقعها من لزوجتها أو رائحتها الكريهة. ولقد أصبح ذلك الجدار شبيهاً بحائط البراق، غير أن هذا الجدار أكثر قداسة من حائط المبكى الذي سرقوه من البراق، وجعلوه شاهداً على تضرّعهم الكاذب ودموعهم المخاتلة الوقحة... ثم يأخذونك إلى الزنزانة ويزجّونك أنت واثنين آخرين فيها، رغم أن مساحتها، بالضبط، بمقدار القبر. ويتم تسليم كل واحد ثلاث بطّانيات، ويسمح لنا أن نخرج من الزنزانة، إلى الحمّامات يومياً، لقضاء حاجتنا مدة خمس دقائق بالثانية! حتى أصبحنا حالة اشتراطيّة نفسية، لا تتحرك أمعاؤنا، ونشعر أننا "سنعملها" إلاّ عندما يطقطق المفتاح في الباب.. فنتسابق على المراحيض... ونخرج منها للحنفيات، لنغسل أيدينا ووجوهنا، ودون صابون طبعاً، رغم أن المراحيض فيها برابيج مياه لنغسل القحفة بعد الغائط، ولكن من أين لنا الصابون أو ورق التواليت!! ساق الله ... وعلينا، طبعاً، أن نفرك أيدينا جيداً لننظفها... دون جدوى ... ونضطر لنتناول ربع رغيف الفينو وحبّة البطاطا المسلوقة باليدين ذاتهما... ونضع بأصابعنا اللقمة تلو أختها في فمنا.. وطبيعي أن يكون هناك "جردل" (دلو بلاستيك) داخل الزنزانة لنقضي حاجتنا الخفيفة فيه! ولا أُنكر أن بعضنا كان يضطر - إذا أصابه الإسهال - أن "يعملها" في الجردل ... وطبعاً لا ماء ولا ورق ولا صابون.. بل رائحة فوّاحة!!
لم يذهب الشتاء تماماً! ولم يسحب أذياله الرمادية.. وكنّا مشبوحين أمام حائط الصفع، في ساحة الفارعة .. وجادت السماء بالمطر ..
كان الجنود يلبسون "الافرهولات" المانعة، كأنهم دببة هجينة داكنة، أمّا نحن فكان لزاماً علينا أن تبقى أيادينا مرفوعة إلى الأعلى، ونقف على رجل واحدة.
وفجأة، أحسستُ يداي أنهما غُصنا شجرة، وأنني جذع شجرة منزرعة في الأرض .. وبعد قليل، ستضرب جذوري أكثر في عمق الأرض، وستبرعم أصابعي وذراعاي، وستطلق أذناي وأنفي وبُصيلات شعري ورقاً... وسأصبح مثل الجميّزة الراسخة...
وبدأ النسغ يصّاعد من أخمص قدمي، إلى جبيني وأطراف أصابعي.. وأصبح جلد جسدي سميكاً وأكثر صلابة وخشونة... وها هو كتفي ينفتح ليخرُج غصن جديد، وتنشقّ خاصرتي ليطلع منها برعم جديد.. وأطلّت الشمس بعد قليل، فعادت الطيور، وحطّت على القضبان الخضراء المتنامية، فيما بقيت عيناي فتحتين أعلى الجذع، تراقبان هذه الشجرة المُمرعة التي كادت تُغطي بجذوعها معظمَ ساحة الشبح ...
بعد منتصف الليل، استيقظتُ فوجدتُ نفسي مُمدّداً في زنزانة مع اثنين من المعتقلين ... يسهران على رأسي، وما أن فتحت عيوني حتى قالا: الحمد لله على السلامة... لقد توقف النزيف .. والجرح في رأسك غير عميق .. كيف حالك الآن؟
أذكر ذلك الآن بإلحاح . بعد إحدى عشرة سنة، ذهبت بصحبة العزيز الشاعر غسان زقطان لنحيي أمسية شعرية في سجن الفارعة الذي أصبح مركزاً شبابياً، تم تأهيله ليكون مركزاً للنشاطات الرياضية والدورات التثقيفية، ويتبع لوزارة الشباب والرياضة الفلسطينية.
... وعندها طلبت أن تكون الندوة الشعرية في الساحة، ووقفت، بالضبط، قبالة جدار الشبح والصفع، ولعلها من أكثر الندوات الشعرية المؤثرة، والمشحونة بكل تلك الصرخات والأوجاع... والمحمولة على الضربات التي ما زلت أسمعها، على بوابات "الخزائن" الحجرية! وبعد الندوة ذهبنا في جولة داخل المعسكر، ورأى أخي غسان زقطان المكان الذي تم حبسنا فيه، والخزائن التي كانت تنطبق مثل القبور على المعتقلين المحشورين فيها.
والخزانة هي غرفة من الباطون المُسلّح، طولها سبعون سنتيمتراً بعرض سبعين سنتيمتراً، ولها باب حديدي سميك، يتم زجّ المعتقل داخلها مقيّداً بالكلبشات، وعلى رأسه كيس خيش كريه، ويظلّ المعتقل واقفاً داخل تلك الخزانة إلى ما شاءت المخابرات ... وقرارات التعذيب.
وتنتشر هذه الخزائن في كل مراكز التحقيق، وإلى جانبها تقع الإكسات التي هي زنازين صغيرة، وسُميّت بـ "الإكس" للتدليل على شطب مَنْ يدخل إليها.
بعد أيام قليلة من تلك الندوة، كتب غسان زقطان يقول:
(كان المكان يبدو أليفاً بممراته المرتبة وطرقاته المرصوفة، غرف النوم وقاعات الدراسة، نوع الأثاث ... ولون الجدران النظيف، الزهور المسقية حديثاً.. كل شيء كان يوحي بالألفة، حتى أولئك الأطفال الذين يعبرون الشارع الرئيسي قادمين من المخيم ليقفوا على الباب ويحدقوا في الداخل ... هذا العبور الآمن كان يذهب بنا إلى الألفة التي تعم المكان وأشجاره وطيوره.. هكذا كان "مركز الفارعة"؛ سجن الفارعة سابقاً عندما وصلنا، أخي المتوكل طه وأنا، بناءً على دعوة من أصدقاء.
خلف البناء الدراسي الرئيسي تقع الباحة الكبيرة، وحولها تتوزع صفوف من الإسمنت بأسقف منخفضة:
- هنا غرف التحقيق
- هنا الخزانات
- الخزانة زنزانة ضيقة جداً، أشبه بتابوت يوضع داخله المعتقل...
- هنا ساحة "الشبح"
- هذه هي "الزنازين"
في الممر الضيق الذي تتوزع على جانبيه زنازين ضيّقة كانت تتردد أسماء المعتقلين، في حين أحاول أن أقرأ ما لم يتمكن الدهان الجديد من إخفائه ... أسماء وإشارات وتواريخ وشعارات، هنا كانوا، مئات منهم أولئك الذين يتذكرون هذا المركز الهادئ الذي نعبر طرقاته النظيفة ... عندما كان سجناً.
لم أكن هنا، ولكنني أستطيع أن أتذكر سجن الفارعة أيضاً، الذي ارتبط لدي بأخبار قصيرة ومؤلمة وأسماء شعراء وكتّاب وفنانين ومناضلين محترفين حملتهم إليه شاحنات الليل معصوبي العيون والأيدي على مدار سنوات الاحتلال الطويلة تلك.
أفكر، فيما يواصل الأصدقاء ذكرياتهم، أنه كان ينبغي الاحتفاظ بالمكان، أو على الأقل بهذا الجزء منه، كما كان، بصفته شاهداً على بربرية الاحتلال، وعلى صمود أهلنا... متحف للذاكرة... ليست الشفهية التي أسمعها الآن فقط، ولكن تلك الموثّقة والمكتوبة ... حيث لا وقت للنسيان).
... وللتاريخ، فإنني أمضيت في الخزانة، في مركز التحقيق بطولكرم، مدة اثنين وثلاثين يوماً، ليلاً ونهاراً فقط... سبقتها أربعة أيام أمام العديد من المحققين، دون أن يُسمح لي بالنوم دقيقة واحدة. ثم تمّ زجّي في "الإكس" حتى الساعة الأخيرة من الأيام الثمانية والسبعين التي أمضيتها متنقلاً بين الجلوس أمام المدفأة، ثم إخراجي شبه عارٍ ومكلبشاً تحت المطر حتى ساعات الصباح، وبين الضغط النفسي، والتجويع والترهيب، أو بين حمّامات منتصف الليل المثلّجة، أو تركي مكلبشاً وكيس الخيش الكريه على رأسي أياماً متوالية، مهملاً.. هكذا، أو منعي من قضاء حاجتي، هذا عدا الشبح المتواصل حتى الخدَر أو الشلل!
يدخل المحقق، وهو مسلّح بشعار واحد، ويظلّ يحفر في بقعة واحدة، ويحفر لعله يجد شيئاً، ويدخل محقق آخر، ويحمل شعاراً آخر، ويروح يجزّ بمبضعه على نغمة واحدة في زاوية محددة.. لعله يستخرج شيئاً ما، ويدخل محقق ثالث ورابع وعاشر.. وهم مُتفقون على مجموعة من النقاط، حيث تشكل هذه النقاط دائرة كاملة، يحاولون سلخها... والنفاذ منها إلى قلبك وعقلك.. والسخرية في الأمر كله أن هؤلاء يعتقدون حقاً أنهم الأذكى والأرفع، وأنك بالنسبة إليهم مجرد فأر تجارب، تنكسر عند نقطة معينة، وتنهار في مستوى معين من الضغط النفسي أو الجسدي "المعقول" أو غير المعقول، ولوهلة ما تشعر أنهم يطبّقون عليك الأساليب التي يتعلمونها في التحقيق، ثم، وفي لحظة واحدة، تنكسر هذه القشرة الرقيقة اللامعة، ويظهرون كامل أحقادهم وعنصريتهم، ويتحولون بعدها إلى ثيران وجواميس وخراتيت لا يفهمون ولا يمارسون سوى القوة، والقوة فقط .. عندها تسلمهم جسدك الأعزل الطري .. تنكمش على نفسك، تخاف قليلاً، ولكنك تعرف أن النجاة قريبة.
لكنك تواجههم بأنهم ليسوا بشراً، بل محترفو تعذيب وإرهاب، وأن ادعاءهم بالحضارة والأناقة ما هو إلاّ قناع، سرعان ما يتهتك، أمام أصغر حقيقة من حقائق وجودنا وحقّنا، في الحياة مثلهم ... تماماً!
وبشكل مباشر تقول لهم: إن الشبح والتجويع و"دُشّات" الماء البارد والكلبشات... ما هي إلاّ أدوات تحاولون من خلالها قهرنا وإخضاعنا، ولكن عليكم أن تختصروا الوقت، وتطلقوا الرصاص علينا، لإنهاء هذه الملهاة المُرّة التي لن تُفضي إلا إلى تعميق الكراهية..
أما البديل فهو الاعتراف بالحقائق الساطعة، وبأنّ ما تدّعونه من معلومات ما هو إلاّ تخيلات وأكاذيب وأحاجٍ...
وما عليك، أيها السجين، إلاّ أن تبدو أكثر تماسكاً وزهواً بعد كل "حفلة" شبح أو حمّام أو خزانة..
ولا تنسَ أن تُذكّر المحققين بأنهم موظفون، ولهم صورة البشر، وعليهم أن يتصرفوا كالآدميين ... وأن العنف والإذلال له نتيجة واحدة، هي إعادة التأكيد بالكلمات نفسها على مسامعهم .. فعندها سيفقدون أعصابهم.. وستضحك، دون أن يلحظوا ابتسامتك المنتصرة!
بعد أسبوع كامل، تم نقلنا من معتقل الفارعة، وكنّا أقل من عشرين معتقلاً، في حافلة، معصوبي العيون، والكلبشات تدمي معاصمنا، إلى سجن "عتليت" الواقع بين الطنطورة وحيفا، وصلنا منتصف الليل، وبعد الإجراءات نفسها، أدخلونا إلى غرف السجن الذي ذكّرني فور رؤيته بسجن عكا القريب، وثورة البراق، والشهداء الذين تسابقوا إلى المشانق فيه .. و"من سجن عكا طلعت جنازة محمد جمجوم وفؤاد حجازي ...وثالثة الأثافي عطا الزير".
في سجن عكّا أمضى والدي سبعة أعوام معتقلاً، أيام الجهاد ضد الانتداب والعصابات الصهيونية، والشهود يؤكدون أنه تمّ أسرُه وكان جريحاً عام 1932، ليخرج بعين واحدة، ويدٍ تشهد على ثلاث رصاصات، وساق تشهد على شظية شقّت اللحم والعظم!! رحمك الله يا أبي، أيها الشيخ الذي جاء بي إلى هذه الدنيا.. ليرحل عنها، وفمي ينقط بالّلعاب...
رحمك الله يا أبي، لقد أورثتني السجن والقصيدة...
أبي . يا أبي .
يا حنينَ الترابْ .
- ترابٌ تغنّى قليلاً .. وغابْ -
.. أذكرُ لمّا تَكفّنْتَ بالزعفرانِ ودمعِ النساء
بكيتُ، وما كنتُ أعرفُ أنك تمضي
لدربِ السرابْ .
وأذكرُ لمّا دُفِنْتَ وصلّوا عليكَ،
رجعتُ وفيّ غموضُ اليتيمِ
وحزنُ السحابْ .
وأذكر أني دُهِشْتُ من الموتِ ..
كنتُ صغيراً، ولم أعرف الفرقَ
بين الجنازاتِ - تمضي إلينا -
وبين الشبابْ .
وأذكرُ لما دخلتُ ..
تفتّقَ دمعُ الأراملِ حُزناً عليّ
وقُلْنَ: تيتّمَ طفلاً ..
وما كنتُ أعرفُ
أن الذي ماتَ شيءٌ بأُمي
فمن يومها لم تَضعْ عطرَها الياسمينَ
ولم تكتحلْ لليالي الملاحِ
وما عَجّنتْ لابنتيها الخِضابْ .
وأذكرُ أني تحاشيتُ من أن تراني
ولكنها لطمت وجهها ..
والفجائعُ تخبو وتعلو
بصوتِ اختناقٍ وصوتِ انتحابْ .
تَسَمّرْتُ؛ ماذا؟ أأبكي،
أَأصمتُ، ماذا سأفعلُ؟
أصرخُ مثل اللواتي مَزَعْنَ الضفائرَ فوق الرؤوسِ
وقددْنَ، فوق الصدورِ، الثيابْ؟
وماذا أقولُ لهذي التي انتظرتهُ طويلاً؛
ومن سجن عكّا أتاها جريحاً
وقد مَزّقتهُ سيوفُ الخيانةِ
والانتدابْ؟.
أبي . يا أبي كنتَ أنتَ الكبير
وكنتُ صغيراً، صغيراً
ولم أعرف الكلماتِ التي
تُطفئ النارَ في مرجلِ الحزنِ والاضطرابْ .
أبي .
يا أبي لم أُداعبْ يديكَ ...
تصبّ الحنانَ، وطيْبَ العِقابْ .
ولم أتعلّق بقمبازِكَ الصوفِ
- لمّا تروح هناكَ -
تقول لأُمي: سأرجعُ،
لا تقلقي إن تأخرتُ ليلاً ..
وكانت تنام
وعينان تنظرُ وَقْعَ الرجوعِ
وإغلاقَ بابْ .
ولم تُعطني يومَ عُدتَ من المسجدِ العُمري
سوى بضعةٍ من قروشٍ
لأبتاعَ ريحَ المراجيحِ في العيد ..
لكنّها حين ضاعت .. بكيتُ ..
ولم تلتفتْ لي حين قلتَ:
انطَلِقْ للصِحابْ .
ولمّا رجعتُ من الصفّ ...
قلتُ: أبي . قد أخذنا دروساً ..
وإني حفظتُ دروسي جميعاً،
فلم تُعطني بعضَ حلوى ..
وقلتَ: انتبهْ للكتابْ .
ولمّا انكببتُ على أُمّ رأسي في الحوش ..
قلتَ: انتصبْ! كيف تبكي وأنتَ كبير؟
وما كنتُ - سامحكَ الله - إلاّ صغيراً
يخافُ الرعودَ ..
ويَنْقُطُ من شفتيهِ اللّعابْ ...
أبي ..
كانت غرف سجن عتليت، أقرب ما تكون، للعقود العتيقة أو البيوت ذات الأقواس الضخمة، مقسّمة إلى عدة غرف تفصلها قضبان حديدية غليظة وقاسية ... وقديمة.
أمضينا تلك الليلة، ليحملونا ظهر اليوم الثاني من حيفا، شمال فلسطين، إلى "كتسيعوت" جنوب بئر السبع، في قلب صحراء النقب، على الحدود المصرية!
يطيرُ بنا التمنّي كأنّه قضاء غامض، ونحن نرتحل من مكان إلى مكان .
ماذا لو أصابت سائقَ هذه الحافلة سكتةٌ قلبية، وتدهورت الحافلة في أحد الوديان .. عندها سيكون هؤلاء الجنود جثثاً هامدة.. أما نحن، فسنتمكن من الهرب ...
أو .. ماذا لو اجتمعت الدول العربية، وشنت حرباً كاسحة ضد إسرائيل .. عندها سيتركنا الجنود داخل الحافلة، وسيهربون، وستدخل جحافل العرب المنتصرين لتكسر حديد الكلبشات، ويسقونا الماء .. ويقولوا لنا: الله يعطيكم العافية..
أو .. ماذا لو استطاع واحد منّا أن يُفْلِت إحدى يديه من الكلبشات، ويفاجئ الجندي الحارس، وينقضّ عليه، ويأخذ سلاحه: عندها سنأخذ الجنود رهائن، ونحظى بـ "تبادل" يُحرّرنا جميعاً من السجن .
أو، ماذا لو كان سائق الحافلة عربياً، مدسوساً بين الجنود، وفجأة يوقف الحافلة، ويشهر سلاحه المخفيّ في وجه الجنود .. ويُطلق سراحنا ..
أو .. ماذا لو أبرقت وأرعدت .. وهطل المطر مدراراً .. ونزلت صاعقة على هذه الحافلة .. فحرقتها، عندها سنتمكن من الإفلات وسط هذا الماء المشتعل الصاخب..
أو ..فجأة! يعلو صوت أحد الجنود، بلغته العربية الثقيلة، وهو يصرخ في أحد المعتقلين عندما حاول أن يرفع، قليلاً، العصبة عن عينيه، لعلّه يرى إلى أين نمضي.
.. وماذا لو!!
وصلنا تلك الليلة، من أيار، وكانت الحافلة مكتملة العدد، وبعد أن تعرّفنا على الشحرورة، وجُملتها المشهورة، دخلنا المعتقل الذي لم يكن حينها إلاّ معتقلاً صغيراً مكوّناً من وحدة واحدة، أو ستة أقسام، تنام على الرمل وتصحو على عقاربه وأفاعيه التي عقصت ثلاثين سجيناً، ولدغت عشرين آخرين. وقتها كان لا بُدّ من أن يجتمع ذوو الخبرة من المعتقلين؛ سجناء سابقون، وطلبة جامعيون، وأعضاء نشيطون في الفصائل الوطنية، لتنظيم حياة المعتقل... وبدأ بالفعل الترتيب لذلك ... وخلال أسبوع واحدٍ، كان النظام قد تم تعميمه، وتم تشكيل لجان النظافة، والمطبخ، والأمن، والفصائل، واللجنة الوطنية العليا، ولجنة الصندوق والطعام والنشاطات، خصوصاً أن المخضرمين في المعتقلات قد تم نقلهم جميعاً من سجن جنيد غرب نابلس، إلى معتقل كتسيعوت.
بعد أن تكاثرت حوادث لدغ الأفاعي عدداً كبيراً من المعتقلين، وأصبح مرأى العقارب مريباً ومرعباً، اقترحت لجان الأقسام أن يسهر، كل ليلة، ثلاثة من المعتقلين، في كل خيمة، لحراسة السجناء من الأفاعي والعقارب ..
لكن غسان الحرامي "أبو زياد" صاحب النوادر، كانت لديه وجهة نظر أخرى، لها وجاهتها وفتنتها! وهي أن يقوم الشيخ أحمد بـ "التعزيم" على الأفاعي، وحبسها في دوائر، ومن ثم "تنظيمها" لصالح المعتقلين، وإعطائها الأوامر لتلدغ الجنود!
- لكن الشيخ أحمد لم يكن حاوياً في يومٍ من الأيام يا حرامي!
.. وتروق الفكرة لعماد عامر الذي أصبح اسمه في المعتقل، لوسامته، "شيتا" .. فيحملها، ويبدأ بالترويج لها .. لتصل الفكرة اللمّاحة إلى الشيخ أحمد، فيهشّ ويبشّ، ويبدأ الإدعاءَ بأنه يستطيع أن يقيّد الأفاعي ويطرد العقارب الصفراء!!
وكم كانت دهشتنا، عندما كان يقفز الشيخ أحمد فجأة، حاملاً حذاءه، ويقلب إحدى البطانيات ويبدأ طرق حذائه .. فنرى العقرب المتفسّخ بفعل ضربات الشيخ!
.. وبعد أيام قليلة، بدأت لجنة القسم تواجه مشكلة حقيقية، مفادها أن كل المعتقلين، تقريباً، يريدون أن ينتقلوا إلى النوم في الخيمة التي ينام فيها الشيخ أحمد ..
بعد أُسبوع تقريباً، تم نقل الشيخ أحمد إلى عيادة السجن . لقد لدغته أفعى! ومن فضل الله عليه، أنها كانت "فرخاً" صغيراً .. غير مهلك!
تصحو مبكراً، فترى شال الغبش ينسلّ برشاقة، ليجلو الطريق في الأفق، أمام حبال الشمس الطالعة من الشرق، هذا فجر الصحراء .. فما على البدوي النائم، في ضلوعي، منذ عشرين قرناً، إلاّ أن يصحو الآن، ليرفع ستائر خيمته، لتدخلها مياه الشمس، ويرتّب بطانياته، ويطوي فرشته البلاستيكية، ويركزها مكانها . ويُلقي تحية الصباح على زملاء الخيمة، ويذهب إلى الماسورة التي تقذف ماءها البارد ليَغسل وجهه، ويفرك قطعة الصابون برفق، حتى لا تذوب، لأن إدارة السجن صرفت قطعة صابون صغيرة واحدة، ولمدة أسبوع، لكل خيمة .. لاستعمالها في غسل اليدين والوجه، والحمّام الأسبوعي.
ومع تمام السادسة صباحاً يكون كل المعتقلين قد افترشوا الأرض، على شكل أسراب متتالية، ليأتي الضابط وثلة الجنود، لإجراء "العدد" أو إحصاء المعتقلين. وطبيعي أن ينادوا على أرقامنا، لنقول "موجود"، ثم لا نقوم عن الأرض أو نأتي بأية حركة، حتى يخرج الجنود، وينغلق الباب بالمفتاح! لكن عشرات الجنود المنتشرين، في الطرقات الفاصلة بين كل قسم وآخر، يظلّون على حالهم، متمنطقين أسلحتهم، ومدافع الغاز .. والكلاب تلهث حولهم، تلحمس أيديهم التي تحاول أن تداعبها.
وعلى الساعة السابعة، بالتمام والكمال، يدخل "الشباب" يحملون طناجر الشاي وطعام الإفطار .. ويبدأون بالتوزيع، حيث يبدأون كل وجبة، من عند الخيمة الأولى، ثم يبدأون في اليوم الثاني، من عند الخيمة الثانية، وهكذا..
أما الإفطار، فهو ملعقة تطلي "مربّى" وثلاث شرائح خبز فينو وأربع حبّات زيتون، وقطعة "مرجرين" زبدة ونصف بيضة . أو يكون حبة بطاطا مسلوقة، وأربع حبّات زيتون، ونصف بيضة و"مرجرين". أو يكون حبة بطاطا مسلوقة، واربع حبات زيتون، وحبة بندورة . أو مغرفة فول، مع أربع حبات زيتون وسنتيمتر مكعب من المرجرين .. وطبعاً يحمل كل واحد منا كوب الشاي البلاستيكي، ليدلحوا له من هذا السائل الأسود، الذي لم نشربه ساخناً، بل فاتر ومزّ، أو شديد المرارة أو التحلية.
بعد الفطور، ينهض ثلاثة معتقلين، من الخيمة الأولى، ويجمعون الكؤوس والصحون البلاستيكية، ويذهبون بها، في صندوق بلاستيكي كبير، إلى فتحة ماسورة الماء ليغسلوها! وفي اليوم الثاني ينهض ثلاثة معتقلين آخرون، من الخيمة نفسها لغسل أطباق الغداء، ويليهم ثلاثة آخرون لغسل أطباق العشاء .. وتدور دوائر الغسل على كل المعتقلين، دون استثناء، ويكون ذلك، طبعاً، بإشراف لجنة التنظيف التي غالباً ما تُصدر أوامرها لمَنْ غسلوا أطباق الصباح لينظّفوا الساحة من أعقاب السجائر أو بعض ما تطاير من ورق.
مع الساعة العاشرة، تبدأ لجان النشاطات العمل، حيث يتم تقسيم المعتقلين إلى مجموعات . فهذه مجموعة لمحو الأميّة، وتلك مجموعة تعلّم اللغة العبرية، وتلك الانجليزية، وتلك الفرنسية، وتلك لتعلّم النحو والصرف، وتلك لتحفيظ القرآن وتفسيره، وتلك لقراءة الكرّاسات والكتب التي وضعتها اللجنة لمجموعة ما لقراءتها حتى تتم مناقشتهم بمضامينها بعد أسبوع .. وهكذا.
وعند الساعة الثانية عشرة منتصف النهار، يدخل "الشباب" حاملين طناجر طعام الغداء المكوّن من مغرفة رزّ صغيرة، ومغرفة شوربة بزر مكانس، أو مغرفة شوربة عدس، أو شوربة يخنة بطاطا أو بصل، وثمة نصف حبة برتقال، أو نصف حبة تفاح، أو نصف قرن موز، مرتين أسبوعياً، يتم توزيعها على المعتقلين!
وحين ينتهي "الاخوان" من الغداء، تبدأ لجنة النظافة الإشراف على غسل الأطباق، وتكليف ثلاثة معتقلين جدد لهذه المهمة، وعند الساعة الواحدة ظهراً، يرفع أحدهم الأذان لصلاة الظهر ... وهنا مشكلة المشاكل!!؟
فلقد منعت إدارة المعتقل المعتقلين من ممارسة ثلاثة أشياء رئيسة في ساحة القسم، وهي: الصلاة أو رفع الأذان، ثم الرياضة والتجمّع لأكثر من اثنين، ثم الغناء أو إقامة الاحتفالات.
لكن المعتقلين أصروا على رفع الأذان -وعندما سمعت الأذان في ذلك المكان لأول مرة، شعرت بالصوت العذب والكلام العذب يكسر الحواجز والأسلاك، ويحيل الحصار والصحراء والشمس إلى رياض غنّاء تنضح بالزهر وسلسبيل الماء- فدخل الجنود، واعتقلوا المؤذّن، وزجّوه في الزنزانة! فخرج مؤذّن آخر، فاعتقلوه، وخرج مؤذن ثالث.. فاعتقلوا، حتى ثلاثة وعشرين مؤذناً اعتقلوا في يوم واحد . وما كان من حنّا الساحوري إلا أن تبرّع برفع الأذان لصلاة الظهر .. ومن يومها أصبح "حنّا" أحسن مؤذن للمسلمين وأشجع مَنْ رفع الأذان!
ولمّا اعتقلته إدارة السجن، وقالوا له: أنت مسيحي، فكيف تصلّي صلاة المسلمين؟ قال "حنّا" لهم: تلك كانت معركة بيننا وبينكم، ولم تكن بين المسلمين واليهود . ثم إن رفع الأذان هو واجب وطني . وفوق كل ذلك: إذا سجنتم كل المسلمين في الزنازين، فإنني سأرفع الأذان وسأصلّي بدلاً منهم .. وسأبقى على ديني .. ولا تعارض بين هذا وذاك.
أما الصديق المرح فؤاد كوكالي، فقد اعتبر موقف الأخ "حنّا" سابقة يجب الاعتراف بها، والحسبان لها، خاصة أن المسلمين زادوا "صوتاً" في حين كسب المسيحيون "مسلماً" إضافياً . وبالطبع يختتم كوكالي جملته بضحكة طفل بريء.. لا تنتهي قهقهته، حتى تدمع عيناه، فيستغفر الله، بكل الديانات.
وكالعادة، وضعت إدارة السجن حنّا في الزنزانة فترة مضاعفة .. وعاقبته ثلاثة أضعاف ما عاقبت به المسلمين.
في تمام الساعة الثالثة ظهراً، تُعاد كرّة "العدد"، وربما، بل غالباً، ما تتركنا إدارة المعتقل جالسين على الأرض اللاهبة مدة وصلت الساعة أو أكثر، حتى "تُشرّفنا" وتحصينا . وبالمناسبة، لقد طلبت إدارة السجن منّا، وقت العدد، أن نضع أيدينا خلف ظهورنا، ونطأطئ رؤوسنا، ونجلس متربعين على الأرض، دون أن يُسمح لنا بافتراش كرتونة أو ثوب أو بطانية .. لكن المعتقلين، وبإصرار، كانوا يضعون أيديهم أمامهم، ويرفعون رؤوسهم .. وبالتدريج تغاضت إدارة السجن عَمّن وضع شيئاً تحته وقت العدد.
أيها الجندي القابض على بندقيته، كأنها حِرْز مُقدّس! لماذا، وأنتَ ترى حالنا، والظلم الهائل الذي يبهظنا، لماذا، لا تصرخ في وجه قائدك، وترمي سلاحك في وجهه، وتنتصر للعدالة؟
اطمئن أيها الجندي! لا نريد ذبحك، أو إلقاءك في البحر! فلماذا يطيب لك القهر والإذلال والتجويع والضرب؟؟ لماذا؟
ماذا صبّوا في قلبك، وماذا قالوا لك عنّا؟؟
مَنْ الذي عبّأ عقلك بكل هذه الكراهية العمياء؟ وكيف لك أن تحتمل كل هذا الظلام بداخلك، وهذه السموم بأنفاسك! وكيف لم تمت من ثِقَل ما حشوك به من موت، وجعلوك مشوّهاً إلى هذا الحد؟
هل ترى عيناك أيها الجندي، غير الذي تراه عيون البشر؟ وهل تسمع أذناك غير الذي تسمعه آذان الناس؟
ألم تر ما يَفعله قومك بنا؟ ألم تسمع الصرخات والولولات والأنين؟
كيف تسمح لك إنسانيتك أن تكون شريكاً في ساحات الإعدام؟
ألم تلاحظ أننا بشر مثلك، لنا عيون ووجوه وأيدٍ وأرجل .. وأننا نأكل ونشرب ونمشي...
إن صمتك، أيها الجندي، وحَمْلك هذا السلاح، وسرعتك في سحب أقسام البندقية، وإطلاق الرصاص، جعلتني أحلم ليل نهار كيف أُطبق بكلتا يدي حول عنقك، وعنق كل جندي مثلك .. لا لأنك جندي مشوّه أحمق، بل لأنك جعلتني أعرف الكراهية! وجعلتني أكرهك وأنتَ على حالك هذه، بل دفعتني إلى أن أفكر في القتل، أعني قتلك أنت.. حتى أوقف القتل، على هذه الأرض.
.. كم أنت مشوّه أيها الجندي!، كم أنتَ بعيد عنا..!
ثمة قصّة وقعت وقت العدد، كادت تحصد ألف قتيل منّا . كُنّا نجلس والضابط الإسرائيلي ينادي على أرقامنا، وفي تلك اللحظات اضطر أحد المعتقلين، على ما يبدو، لينفّس بعض غازات بطنه .. فخرج الصوت وتضاحك بعض المعتقلين على هذا "الصوت" الذي جاء في غير أوانه .. لقد كان صعباً على "أحمد الحزين" و"علي الرجوب" و"الفطافطة" ألاّ يضحكوا .. رغم أنهم محسوبون من قيادة المعتقل ورجالاته الأشداء، فما كان من الجنود إلاّ أن ابتعدوا عدة أمتار، وسحبوا أقسام رشاشاتهم، وأعطى الضابط الأمر لهم بإطلاق الرصاص .. لولا أن شاويش القسم الشجاع منير العبوشي اعترض بجسمه البنادق، وسارع بلغته العبرية إلى شرح الموقف للضابط .. حتى هدّأ روعه!! فعادوا بعد ساعة، وأعادوا "العدد" وعاقبونا بالدخان والراديو!
- مَنْ هو شاويش القسم، وما هو عقاب الراديو والدخان هذا؟ -
شاويش القسم هو أحد المعتقلين الفلسطينيين، ينتخبه المعتقلون ليكون حلقة الوصل بينهم وبين إدارة السجن، على أن يكون هذا الشاويش معروفاً بوطنيته وصلابته وإتقانه العبرية، وغالباً ما يكون "خرّيجاً" من أحد السجون الإسرائيلية.
أما عقاب الدخان والراديو، فإن إدارة السجن توزّع على كل معتقل خمس سجائر يومياً من نوع "خنتريش"؛ وهو دخان سيء ومن دون فلتر ويُسمّى "أُسكت"، حيث تقطع ادارة السجن الدخان عن المعتقلين، حسب مزاجها، يوماً أو أكثر . أما الراديو، فإن إدارة السجن التي وضعت مكبرات صوت نشرتها على كل الأقسام، وعلّقتها على أعمدة الكهرباء، فإنها "تشنّف" آذاننا بنشرة أخبار من "صوت اسرائيل" صباحاً، وأخرى مساءً، وأحياناً تُسْمعنا أغنية أم كلثوم عصراً! وفي إحد الأيام، كان صوت أم كلثوم يسبح مع غروب الصحراء وهي تهدهد قصيدة "سلوا قلبي"، ولما أتت على قول أحمد شوقي (وما نيل المطالب بالتمنّي) قطعت إدارة السجن الأغنية، وعاقبت أم كلثوم على أغنيتها تلك، فلم نعد نسمعها.
وعند الساعة الرابعة، تعود لجنة النشاطات إلى الحياة، حيث تفتح ورشة نقاش في كل خيمة، ويتم فرز أحد المتحدثين، لمناقشة الحضور في موضوعة معينة، أو إلقاء محاضرة، حسب تخصصه واهتمامه .. وهكذا يدور المتحدثون، كل يوم في خيمة، ويتم اقتراح ندوات ومحاضرات جديدة .. وتظل الندوات كخليّة النحل، حتى الساعة السادسة موعد طعام العشاء . وطعام العشاء هو ذاته طعام الإفطار! وبعد ساعتين، أي عند الثامنة، يدخل الجنود ومدافع الغاز، ليتمّموا "العدد" الثالث! ثم يقول الضابط لشاويش القسم الجُملة نفسها: عند العاشرة يتم إغلاق الخيمات.. وعَ النوم! وما بدّي صوت .. مفهوم!!
وقبل العاشرة بقليل، يكون المعتقلون قد اصطفوا في شبه طابور أمام ماسورة الماء، يحملون فراشي أسنانهم، و"البشاكير" على أكتافهم، ويذهبون إلى بحر الحمّامات الطافح المقرف، ليفرغوا ما حملته المثاني . أما إذا ازدحم جسم أحد المعتقلين بالماء، وأراد أن يذهب إلى الحمّام، لقضاء حاجته بعد العاشرة، فعليه أن يخرج من الخيمة بصحبة شاويش القسم، الذي يضطر لاصطحابه.. وانتظاره أمام الحمّام .. حتى يقضي شأنه! وكثيراً ما يقضي الشاويش هذا، ليلته في هذه المشاوير الآسنة . لهذا تقوم لجنة الصندوق، بصرف ثلاث سجائر إضافية للشاويش، تقديراً لجهوده . ولجنة الصندوق هذه، مسؤولة عن تسلم السجائر والصابون، وشفرات الحلاقة (12 شفرة شهرياً لكل قسم)، ما دفع أكثر من تسعين في المئة من المعتقلين إلى إطلاق شعر ذقونهم! وتقوم هذه اللجنة بتوزيع التموين بالتساوي الشديد على الجميع، ودون تمييز!
المعتقلون، عادة، وبعد أن يتم إسدال أذيال الخيمة، عند العاشرة ليلاً، يقوم بعضهم برفع أطرافها، حتى يدخل ضوء أعمدة الكهرباء، قليلاً .. ليواصلوا القراءة .. وللقراءة في السجن طعم آخر مختلف، فهنا لا تتم القراءة لزيادة المعرفة، ولكن، باعتبارها تحدياً من نوع آخر، نوعاً من إثبات الذات والانشغال بأمر "علوي" لا يستطيع السجّان منعه عنّا . للقراءة في السجن طعم تطهّري ونضالي، ولهذا، فإن ما نقرأه في السجن لا ننساه عادة.
وساق الله على تلك الليالي التي كان "بُرشي" أو سريري إلى جانب سرير الصديق الشاعر وسيم الكردي الذي جعلني وإياه نحفظ العهدين القديم والجديد (التوراة والإنجيل)، وروايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، والطاهر وطّار، وجان بول سارتر، ومنشورات "دار التقدم" السوفييتية، من روايات وكتب فكرية وتنظيرات ماركسية ...
أما باقي المعتقلين، فكانوا يحلمون بيقظتهم .. ويخرجون بأرواحهم إلى آفاق بعيدة، يلتقون أزواجهم وأبناءهم وأحبابهم .. ويحلمون .. ويحلمون ..
... إنّ هذا الرَملَ يكذِبُ
لا أُصَدِّقُ غَير هذا الشَّهدِ
في عَيني هَزار
وجُلَّنارِ خُدُودِها
ومياهِ ضحكتِها إذا فاضَت عليَّ
وطَوَّقتْني بالمراجيحِ البَعيدةِ والذِراعِ
وقَبَّلتني كالحمامةِ كي أقولَ :
حَبيبتي الأحلى هَزارُ
ومُهجَتي، رُوحي ..
واسْكُتُ كيْ تُجيبَ بِصَوتها القُزَحيِّ ..
- تضحكُ، تُشرقُ العَينانِ ،
تَنْظُرُ في عُيوني كي أُقَبِّلَها -
أَقولُ: حبيبتي ؟!
وتردُّ في فَرحٍ: أنا، وتضُّمني ..
ويكادُ قلبي أن يطيرَ ،
ويخلعَ القَفصَ المنيعَ
لكي يُسَربلها بِحُبِّي أو بِخَوفي
آهِ يا روحي الصَّغيرة، لا تنامي
داعبي شَعري بكَفِّكِ ،
واسأليني باندهاشٍ
كَيفَ جاءتْ أُختُكِ الصُّغرى ،
وقولي ما حَفظتِ منَ الأَغاني
والأناشيدِ القَصيرةِ ،
رَتِّلي الآياتِ كالطيرِ السَّعيدِ ،
أو اطلبي بَعضَ السكاكرِ والعَرائِسِ
والعبي مَعها ،
ونُطِّي في زَوايا البَيْتِ
وابكي، كسِّري بَعضَ الأَواني
خَربشي المَهْدَ الرَّتيبَ
ومزِّقي الصُّوَر القَديمةَ
وانعفي الحَلوى وأَوراقَ الزُّهورِ
على السرير
أَو ادلحي كَأسَ الحليبِ على الفراشِ
ولا تنامي .
إنَّ وجْهَكِ يَغسِلُ القلْبَ المُعذَّبَ بالضياءِ
وإنني أنسى ـ إذا حَضَرتْ عُيونُكِ ـ كلَّ أَحزاني
ـ وحزني مِثْلُ غاباتِ الشتاءِ ـ
فلا تنامي يا ملاكي
ثُمَ أَسأَلُ:
هَل تنامُ حبيبتي
أَم أَنَّ عينيها تَلوحُ؟؟
فَلا تُخبِّرُني النجومُ
عَنِ السُّؤالِ أوِ الجوابْ.
ثمة بئر عميقة، لا يملك رؤيةَ ما فيها إلاّ علاّم الغيوب وأنت! وما فيها كثير كثير! وهو ما تحاول إخفاءه أو إنكاره، بل تسعى لنسيانه ..
- لكنه خربشات المراهقة وهوس الشباب! فلماذا الخجل؟ بل ما الذي نبّهك لتلك البئر التي دفنتَ فيها كل عيوبك وفلتات جنونك؟
يا للفضيحة والعار، لو انكشف المستور! يا ويلك.. أما كان بإمكانك أن تكون أكثر عفّة ومعقولية!؟ وما أدراك أنّك لن تفضح نفسك، كما فضح ذلك الشاب نفسه، وقال كل أسراره وهو نائم! كأنه كان تحت تأثير تنويم مغناطيسي، في غرفة طبيب، وعلى سريره الإكلينيكي؟
- لكنني لا أتحدث وأنا نائم؟
ومَنْ أدراك؟ ربما تتحدث هنا في السجن، ويكون البعض مستيقظاً، وسيسمع كل خطاياك وزلاّتك ..
- إذاً، لن أنام!
لكنك ستنام، فالنعاس مثل الموت أو المرض، لا يستأذن، ولا يرعوي، ولا يخضع لتعليمات الملوك، أو فرمانات السلاطين.. إننا بشر .. إننا بشر ..
- لأننا بشر، سأنام إذاً، فما فعلته بشري تماماً .. وليسمعوا ما لم أقله، وما سأقوله ..
تنام .. وفي الصباح، تنظر وجوه زملائك .. فلا ترى شيئاً جديداً، فتسري الطمأنينة إلى نفسك .. وتتأكد أنك لم تحلم بصوت مسموع .. ولم تتكلم! الحمد لله ..
الليل في "كتسيعوت" محيط من الثلج غير الملموس، لكن العظام تتخشب من مساميره التي تصطك بالنخاع الشوكي، وخناجره القاسية التي تعرّي العظام من كل دفء . أما النهار فهو هواء مليء بالذباب والبعوض الوقح، ولشدّة حرّه وقيظه تكاد أمعاؤك تخرج من بين شفتيك! وربما لن يسعفك ماء الثلاجة!
- هل ثمة ثلاجة؟
ثلاجة المعتقلين هي برميل بلاستيكي، دفنه المعتقلون حتى رقبته في الأرض، ولفّوا ما تبقى منه بقطعة بطانية، وأغرقوا محيطه بالماء، وغطوه بقطعة قماش نظيفة، غالباً ما تكون قميصاً برتقالياً كئيباً.
أما الرياضة الفُضلى، فهي "الكسدرة"، "ويا عيني" على المشي السريع، حيث يذرع معتقلان أو ثلاثة ساحة القسم جيئة وذهاباً، مدة ساعتين أو أكثر، خصوصاً بعد "العدد" الثالث وحتى إغلاق الخيمات .. أما باقي المعتقلين فيتحلّقون في جلسات متناثرة هنا وهناك، يتحدثون، يتناقشون، يضحكون، يُغنّون، يسهمون في لا شيء .. وبعضهم يعمل نحّاتاً، حيث يجمع بعض الحجارة الصغيرة، التي يقترب شكلها من الرخام، ويبدأون بشحذه مع حجر آخر، مستعينين بالماء، أو بمسمار تمّ تهريبه .. ليتشكل بين يديه تمثالاً أو أيقونة أو حبّات سبحة، أو خاتماً أو تعليقة عقد.. أو شكل حرف .. وما أكثر ما نحت المعتقلون!!
أما وسيم الكردي وأنا، فكُنّا، غالباً، ما ننادي على ذي الصوت الجميل، الرجل الفكاهي خفيف الظل إبراهيم رمضان، وعلى الأصدقاء طلال دويكات، وأبي عاصف البرغوثي، وأبي محمود السلوادي، وعلي دخل الله، والصيدلاني أحمد عديلة .. ونشكّل نجمة كنعانية تضجّ بالغناء والشعرِ والقفشات والحوارات .. والحنين .. أو مناقشة أمر ما!
وكثيراً ما كانت تتسع الجلسة لتشمل عدداً رائعاً من الأحبّة، أذكر منهم الرجل الطيّب محمد خالد الفقيه، وعمر أبا عبيد "أبا بيسان" الحنون الرقيق، وكامل جبيل، وسمير الشاويش، وبدران جابر، وجبريل البكري، وأبو صبحة والحوراني، والحزين، وعلي الرجوب، ولؤي عبده، وجمال الديك وأبا بشار!
- مَنْ أبو بشار هذا؟
أبو بشار رجل تجرّأت عليه السنوات، وبلغ الستين، اعتقل تسع سنوات في معتقل الجفر الصحراوي، وظلّ شيوعياً صلباً، يتقن الثبات والدماثة والابتسامة الكبيرة. أما زهران أبو قبيطة فكان غالباً ما يشاركنا فكاهتنا دون أن يتخلّى عن جديته ورصانته العميقة.
وكثيراً ما يمر بنا أبو دلال ضاحكاً مازحاً .. وأبو دلال هذا أشجع مَنْ رأيت وسمعت! رجل جسور، أعتقد أن الموت سيتردد كثيراً قبل أن يقترب منه .. لكن أبا دلال (كامل الأفغاني) شديد التواضع، وهو كتلة من الطيبة والرقة والإيثار.
لقد كانت نجمتنا الكنعانية مصدر جذب طيّب للعديد من المعتقلين الراسخين في عوالم السجن والنضال، حتى أن رجلاً مثل رشيد منصور، والمعروف بتبتُّله وتديّنه، وحرصه على أداء صلاة الضحى، والصيام يومي الخميس والإثنين .. كان يحب جلستنا، ونُسعد بشَهْد لسانه وطلّته المضيئة . أما زياد هبّ الريح الذي يخيفك حضوره المجرد، فسرعان ما تكتشف الرقّة والرجولة والمرونة خلف هذه الصلابة الظاهرة.
أما عصام أبو بكر فإنه يحمل ذاك اللمعان الذي كان يميز الشهيد القائد أبا علي إياد، حيث إن "عصام" ينتمي إلى عشيرة شريم التي أنبتت أبا علي إياد، ويحرص عصام، على ما يبدو، على أن يظل محافظاً على هذا الخيط الذهبي المهيب الذي يشعّ من جبهته الناضجة الصلبة.
أمّا د. ثابت الثابت، وأبو الطيب جرادات، فإنهما "يزعلان" إذا ما اتسعت الجلسة، ولم يكونا حاضرين .. لكن غيابهما كان محموداً، لأن د. ثابت كان يلازم المرضى حتى يبرأوا، وعندما يتعب يُسلّم المهمة للدكتور سعيد الطريفي الذي كان يعتبر نفسه مسؤولاً عن صحة المعتقلين، في حين يكون أبو الطيب يدور من خيمة إلى أخرى مع عبد الفتاح أبي الذهب وأبي صالح يتحسسون أحوال السجناء، معتبرين أنفسهم آباء لكل الشبّان الذين وجدوا أنفسهم، فجأة، في حمأة هذي الصحراء.
أمّا نايف سويطات، فإنه يبقى بكامل تماسكه وجدّه المتواصلين يعمل ليل نهار، في المطبخ، والتنظيم ... وترتيب الأوضاع .. والبسمة البريئة لا تفارق أسنانه الواضحة.
أين أنتم يا كلكم الآن؟ هل تحتاجون لكتسيعوت جديد حتى تلتقوا ثانية؟ على أشغالكم، في هذه الدنيا، اللعنة..
وإبراهيم رمضان، مع كل هذا، لا يكفّ عن الغناء، بمصاحبة الصديق الشجاع فتحي جرادات والحاج نادي، مختار "سعير" المتوّج، اللذين يُشكّلان كورالاً، يزيد نشازهما في الغناء ... في تواصل ضحكنا .. الذي غالباً ما ينتهي بصمت عميق!
وهل تذكر باسم يا إبراهيم!؟
ذلك الشاب "المشخّصاتي" الذي كان يقلّد أشهر ممثلي السينما المصرية، وخصوصاً توفيق الدقن؛ بصوته الأجش، وسخريته النهارية المحمولة على المفارقة، واللعب على ملامح وجهه وتنغيم صوته ..
كان باسم شديد الحزن، لكنه يفتح ستارة مسرحه وسط الخيمة، كُلّما طاب وحي الموقف . كان يبدأ بتقليد محمود المليجي، ويُغّني كما يفعل فريد الأطرش، بكاريكاتورية صوتيّة مبالغ فيها، ويتقّمص عادل إمام واسماعيل ياسين وغيرهم.. ويُنهي عرضه بتوفيق الدقن. حتى نسي المعتقلون اسم باسم الحقيقي، وصاروا ينادونه بـ توفيق الدقن.
لقد خشينا، كثيراً، من الموت ضحكاً، عندما كان ينفجر باسم العنبتي، وهو يقدم لنا أفلامه المجّانية، كلما كانت المناسبة مواتية، والتي أحياناً، يجعل أحد المعتقلين المسؤولين بطلاً لواحدٍ منها، فيُسقط على لسانه وحركاته شهواتنا ورغباتنا ... وأحلامنا المكبوتة.
أين العَنبتي؟
إنني أفتقد، جداً، توفيق الدقن، يا إبراهيم.
بل، أين أنت الآن يا إبراهيم؟ إنّ صوتك ما زال يُجَنّح في فضائي كلما ذهبتُ وحدي إلى وحدي! وكيف أحوالك يا أحمد عديلة، يا مَنْ كنت تغسل الملابس الداخلية للمرضى وتطعمهم بيديك أنتَ وجمال الديك كأنهم أبناؤكم القاصرون؟
وهل تذكر يا ابراهيم ليلة نبهان خريشة المزدوجة؟
كان نبهان خريشة شاويشاً لقسم 4، عندما لم يستطع "بكر المبسوط" الجلوس ساعة العدد على "مؤخرته"! فظل الضابط والجنود واقفين على باب القسم، ولمّا استفسروا عن "رفض" هذا المعتقل الجلوس .. لم يتمكن نبهان من أن يشرح للضابط مأساة "الباسور" التي داهمت بكر هذا، ومنعه النزيف من الجلوس .. لكن الضابط لم يفهم على نبهان لضعف لغته العبرية .. وأخيراً، قال نبهان للضابط إن لديه مشكلة في قفاه .. ولمّا ضحك الضابط .. كان الدم قد غطى أرضية الساحة . وسُمح لبكر المبسوط أن يقف ساعة العدد والدم يقطر منه.. بعدها أمضى الأطباء المعتقلون ساعة كاملة، وهم يعبثون بـ "قاعدة" بكر المبسوط الذي آلمه الباسور حتى الصراخ.
وللتسرية عن بكر أقام المعتقلون حفلة على شرف باسوره.. فسمع الضابط الغناء! فنادى الشاويش نبهان خريشة مستفسراً منه عن سبب الغناء الممنوع... فقال له نبهان: إن المعتقلين يحتفلون بعيد ميلاد أبو هريرة!
- مَنْ أبو هريرة هذا يا نبهان؟
شرح نبهان للضابط مَنْ هو أبو هريرة .. ومضى، وبعد نصف ساعة ارتفع صوت الغناء .. فهرع الضابط يلوم نبهان ويحذّره، فقال له نبهان: إنهم يحتفلون بعيد طهور أبو ذرّ الغفاري!
- مَنْ أبو ذرّ هذا يا نبهان؟
حاول نبهان أن يشرح الأمر للضابط، لكن أغنية "غلاّبة يا فتح" فضحت نبهان . وبان الأمر .. وسمع الضابط كلمة "فتح" فأخذ نبهان إلى الزنزانة مصحوباً بتهمتين: الأولى: الضحك على الإدارة بحجة مشكلة "باسور" بكر، والثانية: الاحتفال بأعياد ميلاد رجالات "فتح"، وهما أبو هريرة وأبو ذرّ الغفاري!
ذهبت إلى عيادة بكر في خيمته، فوجدته مبطوحاً على بطنه، يئنّ من الألم، ويضحك من التعليقات التي يسمعها من الاصدقاء: (سلامة قفاك يا بكر) (إن شاء الله قفا "إيتسك" ولا قفاك) -وإيتسك ضابط أمن طويل القامة، أنيق، يحمل عصا الجنرالات دائماً، يضع نظارته الشمسية ليل نهار، لا يبتسم، كأنه مصنوع من الشمع .. لكنه لا يرحم! وهو نموذج للرجل الأبيض الدموي المُهلك-.
- كيف وضعك يا بكر؟ وبكر بلدياتي، كلانا من قلقيلية.. يهمس لي بكر بأن "أبو الهزاع" و"أبو علي شريم" وبقية شباب البلد معتقلون .. ووصلوا اليوم إلى القسم الثاني!
أبو الهزاع؟
أحمد هزاع شريم، أمضى عشرين عاماً، غير منقوصات، في سجون الاحتلال، امتدت من شتاء 1968 حتى شتاء 1988، وكان إفراجه في ذروة الانتفاضة، وبعد عشرين عاماً، هي السنوات الطويلة المليئة بالعذاب والفجائع، خرج أبو الهزّاع ليجدد نضاله ونشاطه الوطني فاعتقلته اسرائيل .. واحتمل عتاب خطيبته التي عليها أن تنتظره أكثر.. كأن عشرين عاماً لم تكن كافية، للاستعداد وإتمام الزواج؟
كانت كافية يا أحمد تلك السنوات، ولم يكن ليعتب عليك أحد، لو استرحت قليلاً، وتزوّجت لترى ابنك قبل أن تخونك الأيام تماماً!
أمّا وريث سيدنا أيوب في القرن العشرين، وأعني أبا علي شريم فقد أمضى ثمانية عشر عاماً في سجون الاحتلال، وها هو يعود إلى السجن صابراً راسخاً، كأنه جبل صلد لا تهزه القيود، ولا تخيفه الزنازين والجنود! فكيف لنا ألاّ نصبر ونقاوم ونغنّي .. ونحن في حضرة هذه الآلاف المؤلفة من مخضرمي النضال والكفاح والصبر الواعي المطمئن!
وكيف لي ألاّ أُصدِّق كلَ أحبابي
بأنصار البطولة
والرجالُ هنا بأنصار البطولة
لم تساوم
بل تقاوم
أو تقاوم ذُلّها
أو جوعَها
وزوابعَ الصحراء
والرملَ المعبّأ بالذئاب!
اشتدّ الألم على بكر، حتى اضطررنا إلى أن نبقى حوله طيلة الليل، ولا أمل في نقله إلى أي مشفى، لأن العلاج الُمتاح في السجن هو إعطاء المريض حبّة "أكامول" أو "اسبرين" .. وفي أقصى الحالات يتم إعطاء المريض شريطاً من كبسولات المضاد الحيوي "الأنتي بيوتيك". لكننا، وبعد مراجعة الطبيبين ثابت الثابت وسعيد الطريفي، وجدنا ضالتنا لعلاج بكر بوساطة "طشت" ماء ساخن! فنادينا على "المختار" مسؤول المطبخ والصيانة في الأقسام الأخ المناضل قدورة موسى، ابن جنين، الذي لا يهدأ ولا ينام، وهو يدور من قسم إلى آخر يتفقد الماء والنظافة وكميات الطعام وأمور الصندوق، وما يحتويه من صابون ودخان .. والذي كان يُهَرِّب، بطريقته، راديو صغيراً، لكل قسم، وكميات إضافية من الدخان والطعام .. وبالطبع كان قدورة ضابط الارتباط السريّ بين كل أقسام المعتقل!
- أحضر لنا ماءً ساخناً من المطبخ يا أبا موسى! فيسارع قدورة موسى بضحكته الطازجة حاملاً "طشت" ماء يغلي .. ويترك الباقي للطبيبين ثابت وسعيد .. وبالمناسبة فهما طبيبا أسنان!
بعد ثلاث عشرة سنة، تقريباً، وعند انتهائي من كتابة هذه الشهادة / الرحلة الشاقة لـ "أنصار 3"، فُجعنا بخبر استشهاد د. ثابت ثابت صبيحة يوم 31/12/2000 أمام بيته في مدينة طولكرم. وعليه، لا بُدّ من الوقوف إجلالاً أمام هذا الشهيد البطل الذي سقط وهو يواجه وباء الاحتلال، بكل ما أوتي من دم وشرف وبسالة.
(يحق لعيني الفهد الخضراوين اللتين انطفأتا باغتيال د. ثابت الثابت، أن نَصبغ أسناننا بالسواد، حزناً ومرارةً، وأن نهيل الرماد والتراب على رؤوسنا، وأن ينتحب القلب، ويجوح الصدر ... حتى لا يظل دمع في الرأس.
مَنْ يُصدّق أن ثابت مات!؟
-أستغفر الله العظيم-
هل رأيتم رجلاً من ندى وريحان، ووجهاً من فرح الأطفال، وضحكة من رذاذ العيد؟
ذاك ثابت الثابت.
وهل عانقتم نهراً في جسد يضفضف بالنور والذهب؟ وهل أحببتم صلاةَ الشجر، أو لقاءَ البعيد العائد؟ وهل حملتم زهرةَ الحليب إلى الأمهات، بأناقة وخشوع؟
لقد كان ثابتُ في العناق المجيد، حتى سقط!
ثابت (أبو أحمد) مات. إذاً لتدقّ الأجراس ألف ألف عام، ولتُكَبّر المآذن ألف ألف مثلها، وليكتبوا على مداخل المدن والبلاد: إن ثابت مات! فلتُرضع السروةُ ابنتها لبناً من دمعها عليه، ولتُطلِق السباعُ قشعريرةَ الوديان بعويلها، لأن أبا الجبال مات، وأبا الينابيع مات، وأبا الطيور البريئة مات.
مَنْ رأى منكم أبا أحمد في السجن؟
كثيرون، بالتأكيد!
كان تاج شمعة بحجم الإنسان، يحبّ الشِعر الواضح وأطفال السخرية، ويمتعض من الالتباس والغمغمة. قليل الكلام، دائم الابتسام، لم يلق بالاً لقمصان السجن أو لزمهرير الهزيع. كان يفرك كفّيه، ويعاود الاطمئنان على المرضى، يجسّ نبضهم، ويعصر خرقة الماء، ويبسطها على جبين مَنْ وقع في حمّى تردّد المناخ.
حُمْرةُ وجهه زائدة، كأنه مرهون لغضب أبدي، أو كأنه من سلالة "الزهراء" الطاهرة.
على مثله يبكي الرجال، وعند موته يموت الصبر، ويصبح الحزن وحشاً يفتتّ الكبد ويحرق القلب.
مَنْ رأى أبا أحمد؟
كان زهر الليمون الشتوي يسّاقط من أكمامه، ويطلّ النرجس من عنقه المشرّب بالمغيب، كانت تَحفُّهُ عرائسُ الغموض، وتحمل خطوته إلى درج الصباح، فيظلّ واثقاً رائقاً يضوّع الطريق بالأريج.
كان في المعتقل، يرقب رقعة الشطرنج، حتى إذا فرغ اللاعبان نصح الغالب والمغلوب، وبيّن لهما أخطاءهما ... وعندما يطلبه أحد للمبارزة، كان يقول له: إن بيادقي من لحم ودم، وأنا الحصان والقلعة والملك!
كيف سمحتَ لهم، أيّها الملك، أن يُقلّبوا جثمانك أمام كاميرات الصحافة، ليظهروا للعالَم مكمن إصابتك ومداها ... ولم تبعدهم؟!
كنتَ مستسلماً، ذراعاك على بطنك مقيّدتان، كنتَ حيادياً، ثم دفعوا بك إلى الصندوق المُعتم البارد!
انتظرتُ أن تدفعهم بعزيمة يديك، وأن تنهض بكامل نبيذك وعسلك، وأن تذهب إلى ملابسك، فترتديها من جديد، وتعود إلى إصلاح السيارة من ثقوب الرصاص الغليظ.
لماذا لم تفعلها وتنهض يا ثابت ... لماذا؟
هل ذهبت إلى الجنّة!؟
حسناً، طولكرم جنّة أيضاً، وأقسم بالله، لو أنكَ سمعتَ بكاء أبنائك وأهلك ونشيج صراخهم، لكشفتَ غطاء النعش، ونزلت منه ... وذهبت إليهم، تعتذر لهم عن موتك!
لكنك لم ولن تعتذر، كأنك تريد بموتك أن تدفن قرن المظلمة والاستلاب، وتبعث بدمك الجُلّنار، ذكرى العاصفة المتجددة، حتى الأسوار والنشيد الأخير.
وهل نحن أحياء لنقول إنك ميت يا ثابت؟ وكيف نكون أحياء وصخرة المعراج محاطة بسنابك خيل الآخرين، ولم يرتفع حزننا الغولي فوق قامة الفقاعة، أو على ضباع أسبارطة التي تلعق دماءنا بأنيابها وخراطيم حديدها المُهلك.
وهل سنواصل السلام بعد قليل؟ لتنسرب الرغوة الفاسدة إلى رئتي القرى والصلوات، ونطوي صفحة وجهك الأرجوان؟
أرى حبّةً من كهرمان صدرك تسقط في الطريق .. وبعد قليل، ستنفجر الأشجار، وينفضُ فتى العاصفة غُصْنَ البرق، لتنثال على الدنيا أنوار المجد والخلاص! عندها، ربما، سنبكي رجلاً، كان ثابتاً على عهد التراب، وكان اسمه العالي المسجّى: ثابت ثابت!)
وإذا غاب قدورة أبو موسى، أو كان مشغولاً في مطبخ المعتقل، ولا بُدّ من بعث رسالة من قسم إلى آخر، فثمة طريقة "الحمام الزاجل" أو "الصحون الطائرة" حيث يتم لفّ الرسالة وربطها بحجر أو بقطع ملبّدة من لبّ الخبز .. ورميها بأقصى قوة إلى القسم الآخر .. ودائماً هناك شخص مُكلّف بالتقاط الرسالة وتسليمها للجنة القسم الوطنية ..!
إذ إن لكل قسم "لجنة وطنية" أو "لجنة نضالية" تتكون من ممثل لكل فصيل (فتح، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الحزب الشيوعي الذي أصبح حزب الشعب) وهي أعلى لجنة مسؤولة عن كل شيء داخل القسم، ولها مرجعية تزوّدها بتعليمات دورية، غالباً ما تكون أُسبوعية. والمرجعية هي "اللجنة النضالية العليا" المكونة من الفصائل الأربعة المذكورة، ويكون ممثل حركة فتح منسقاً للجنة العليا، ولجنة القسم... لأن أكثر من نصف المعتقلين ينتمون، أو أنصار، لحركة فتح.
ويقوم كل فصيل بتسمية أو فرز ممثليه للّجان الوطنية في الأقسام، وكذلك ممثله في اللجنة العليا.
وتكون لكل لجنة نضالية في كل قسم لجان فرعية تشرف على كل صغيرة وكبيرة، تبدأ من الطعام وتوزيعه، مروراً بالنشاطات والفعاليات، وانتهاءً بإصدار البيانات والتعليمات المحلية، والضبط والرقابة الأمنية.
ثم إنّ لكل فصيل لجانه الخاصة، وغالباً ما تتركز حول التنظيم والأمن . عدا أن لكل فصيل لجنته المركزية على مستوى كل المعتقل، ولجنة تنظيمية على مستوى القسم، ويتم انتخاب هذه اللجان التنظيمية بطريقة الاقتراع السرّي والمباشر، وبشرط منع الترشيح، بمعنى أن على كل مَنْ ينتمي لحركة "فتح"، مثلاً، أن ينتقي أو يرشّح سبعة أشخاص ليكونوا لجنة مركزية .. ومَنْ يُجمع عليهم المعتقلون الفتحاويون تتم تسميتهم كلجنة مركزية للحركة في المعتقل، ويتم تكليف كل عضو لجنة مركزية ليكون مسؤولاً عن قطاع من القطاعات التالية: الأمن، الثقافة، التنظيم والتعبئة والتوجيه، اللجنة العليا، النشاطات، الاتصال والاعلام، التموين أو الصندوق .. الخ
أما الاخوة في "الاتجاه الإسلامي" فكانوا خليطاً من عدة مجموعات، هي الاخوان المسلمون، الجهاد الإٍسلامي، حزب التحرير .. ولم تكن "حماس" قد اشتدّ عودها بعد، ولم ينتظم أعضاؤها في هرميّة تنظيمية لها حضورها وفاعليتها، رغم أن الأشقاء في الاتجاه الاسلامي، كانوا يتميزون بالشجاعة والالتزام والانضباط العالي، وساهموا مساهمة طيّبة في تمتين جبهة المعتقلين في صراعهم مع إدارة المعتقل.
كأني رأيته وهو يهبط من البدر المكتمل الموشّح، بثيابه البيضاء، الموشّاة ببقع الأرجوان المقدّس، وقدميه الناعمتين اللتين مرَّرت المجدلية ضفائرها عليهما!
كان شفيفاً، عملاقاً، كان شَعره مخضّلاً بالمياه، يضفضف ويضيء .. فتح ذراعيه، كأنه ما زال مصلوباً، فتنزل سحابتا أردانه حتى تلامسا الرمل ..
يا سيدي البهيّ المخذول بقُبلة الخيانة اللئيمة! عُدْ إلى أبراج السماوات، واهتف للعليّ المجيد، الذي يرانا .. ليمسح عن وجهك دموع المعتقلين البسطاء، واقرأ بشارتك النافذة، في هذه البراري القاسية؛ بأنك جئت لتلقي سيفاً، في قلب الرمل .. لعلّ صغارنا يدخلون - الآن - باب العامود، ويدلفون بأناشيدهم الصغيرة، إلى طريق الآلام .. فلا يُصعّرون خدودهم، بل يكسرون صليبهم، ويرمون تيجان الشوك .. وينظرون إلى الأعالي، التي تُسبّح لمجد أمواه القلوب، التي تغسل الطريق من غبار الجنود .. الذاهبين، وحدهم إلى الجلجلة .. ويعلو قُدّاس الحياة واليمام .. في كل الأزقة والأجراس .. والنداءات الخاشعة ..
يا ابن البتول! لن يتمكّنوا منك ثانيةً، فاذهب، على مهل .. إلى غبش الخشوع والملائك الساهرين ..
في صيف 1988، أعلمتنا إدارة السجن بزيارة "وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين" للمعتقل!
ورابين هذا هو الذي أمر بتحطيم وتكسير أيدي وأطراف المنتفضين، فما العمل؟ هل نقابله؟ هل نتظاهر في الأقسام؟ ماذا نردد؟ هل نرشقه بالحجارة وقطع الصابون؟ هل يهجم عليه ثلاثة من حاملي شفرات الحلاقة، ويمزّقون وجهه؟
(لكن إدارة السجن جمعت شفرات الحلاقة قبل يومين، ومثلما تسلّم شاويش القسم 12 شفرة، عليه أن يسلّمها 12 شفرة ... وإلاّ تقوم الدنيا ولا تقعد)
إذاً، ما العمل؟
أجمع المخضرمون وأعضاء اللجان الوطنية والفصائل، بعد طول نقاش وحوار ... على تشكيل لجنة لمقابلته، وطرح مجموعة من القضايا عليه، وتم تشكيل اللجنة من: لؤي عبده، أبي الرامز، بدران جابر، موسى أبي صبحة، محمد الحوراني، أبي بشار، سامي الكيلاني، عز الدين العريان، نايف سويطات، جمال الديك، بلال الشخشير، ثابت الثابت، كامل جبيل، رضوان زيادة، وكنتُ معهم.
دخل رابين محاطاً بأكثر من ثلاثين جندياً مدجّجاً -من القوات الخاصة على ما يبدو، لاختلاف لباسهم والشعار على أكتافهم وطواقيهم- جلس في أول خيمة، في قسم 3، وسُمح للمعتقلين أن يقتربوا، دون أن ينبسوا ببنت شفة! وحاول رابين أن يبرر إجراءات وزارة الحرب التي يقودها بشراسة وساديّة ضد الأطفال والناس العُزّل.. والجميع صامت... وعندما انتهى هزّ رأسه، كأنه ينتظر سماع شيء ما..
بدأ لؤي عبده الحديث باللغة العبرية، بثقة واتزان ووضوح، وافتتح حديثه الموجه إلى رابين بقوله: إن إجراءات الاحتلال هي إجراءات فاشية نازيّة، وإننا سنمضي قدماً في الانتفاضة حتى نتخلّص منكم (الاحتلال)، وإذا أردتم أن تتفاوضوا معنا، فإن لنا ممثلاً شرعياً وحيداً موجوداً في تونس، اذهبوا -إذا أردتم التفاوض- إليه في تونس، فهناك لنا رئيس اسمه ياسر عرفات، وأعتقد أنك يا سيّد رابين تعرفه جيداً ... في "الكرامة" عرفه موشيه ديان، وفي بيروت عرفه بيغن وشارون...الخ.
واستيقظنا صبيحة اليوم التالي، فلم نجد لؤي عبده ولا بلال الشخشير ولا رضوان زيادة (الذي توفي بعد إبعاده بعامين في غربته .. بعمّان) ... لقد تم إخراجهم من القسم منتصف الليل، ليكونوا خارج فلسطين، مُبْعدين... مع آلاف المُبْعَدِين الآخرين!
هل أبعدوك؟
هل توّجوك القلب سرّاً
عندما جاءوا إليك
مع الغسق
وقيدوك ..؟
لا تسرقوا منه العبق
قلبي تشقق واحترق ..
ربما، كان لا بُدّ من الدم، حتى تكتمل التفاحة أو البرتقالة أو البيضة، وحتى يكفّ الجنود المدججون عن ركلنا وصفعنا، بسبب أو دون سبب! كان ذلك،عزّ ظهر يوم 16/8/1988، حيث كان الجنود يسحبون معتقلاً إلى الزنزانة، ولشدّة ضربه، غطى دمُه كاملَ وجهه .. ولمّا كانت السياج لا تمنع الرؤية، احتجّ بعض المعتقلين بالصراخ: الله أكبر .. وما هي إلاّ ثانية أو أقل حتّى كانت "الله أكبر" تخرج من سبعة آلاف فم زلزلت الصحراء.. فيما ذهب المعتقلون يبحثون بين الرمل عن الحجارة والحصى، وحمل بعضهم قطع الصابون والأحذية ... وألقوا كل شيء على الجنود الذين فتحوا النار عشوائياً على كل الأقسام، بصورة هستيرية، وبدأ الجنود المنتشرون في طرقات الأقسام فتح فوهات مدافع الغاز... وظهر المسؤول الأول عن معسكر كتسيعوت "أنصار 3" "العقيد تسيمح" ورأى ما رأى، فتناول بندقية "الأم سكستين" من أحد الجنود، وصوّب نحو المعتقلين... وغطّت سماء المعتقل غيوم الغاز الخانق... فارتمى معظم المعتقلين أرضاً، يسعلون ويعطسون... وهدأ الرصاص... وبعد نصف ساعة، انجلى المشهد، فرأينا المدافع والدبابات الثقيلة، توجّه فوهاتها الكبيرة الغليظة باتجاه الأقسام...وأمر ضباط، لم نرهم من قبل، أن نحمل الجرحى ونضعهم أمام بوابات الأقسام، لنقلهم إلى المستشفى، ففعل المعتقلون، وحمل الجنود الجرحى والمصابين إلى مكان قيل لنا إنه عيادة السجن ... وبعد ساعتين، نادى ضابط السجن على الأخ منير العبوشي الذي كان شاويش القسم، كما كان ممثلاً للمعتقلين، وعلى الأخوين عبد الله ياغي وسالم أبي صالح شاويشيّ القسمين اللذين استشهد فيهما اثنان من المعتقلين .. وأبلغوهم أن الشهيدين هما بسام السمودي وأسعد الشوّا ...
أعلن المعتقلون الإضراب عن الطعام، حداداً واحتجاجاً.. وليستمر المعتقلون تسعة أيام دون طعام، حتى استجابت إدارة السجن إلى بعض مطالبهم، فكان أن أصبح نصف التفاحة تفاحة كاملة، ومُنِعَ الجنود من ضرب السجين أمام زملائه، وتم تبديل "بُرش" البلاستيك بسرير خشبي يُسمى "مشتاح"؛ وهو ألواح خشبية متباعدة.. وتكسر الظهر، عند النوم!، وتمت زيادة كمية الطعام، وإدخال القهوة وجبة أسبوعية!!
اعصفْ فإني عاصفهْ
ودماءُ قلبي راعفهْ
وجموعنا في كتسيعوت الموت
هبّت واقفهْ
لا الموتُ يكسرنا
ولا رعبُ الدماء النازفهْ
. . . . .
يا لعنةَ التاريخِ هذا قيدُك الهمجيُّ
أُلقيه بوجهكِ صخرةً
ولظىً على كل الوجوه الزائفهْ
. . . . .
ولتحذروا
هذي الجموعُ، سيولُنا الغَضبى
تهدّرُ جارفه
اعصفْ فإني عاصفه
واعصف فإني عاصفهْ ...
هل تنفست الصعداء لأن العناية الإلهية حرستك من الرصاص؟ آه أيها الجبان .. لقد انكشفتَ .. إنّك تخاف الموت!!
- لا .. ألم ترني، والرصاص المجنون يئزّ حولي، بقيت واقفاً، أو منحازاً لنقل بعض المرضى إلى داخل الخيام، حتى لا يموتوا خنقاً أو رصاصاً؟!!
لكنك سعيد بأنك ما زلت حيّاً، بل إنك ستدّعي البطولة، وأن الموت لا يهمك ..! على كل حال احمدْ ربّك، لأنك كنت مشغولاً ساعة زلزال الرصاص .. ولو فكرتَ لحظةً باحتمال موتك لسقطتَ ميتاً! ألم تسمع المثل القائل: إنّ مَنْ يخشى الذئب .. فإنه يراه ..
ستراه يا صديقي .. ستراه! انتظر ..
بعد شهر تقريباً، استطاع الفارس الشجاع، المناضل الشاعر توفيق زيّاد من زيارتنا في قلب أنصار3، كان وقتها عضواً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، جاء... وشدّ على أيدينا، وسمع مطالبنا، وعلا صوت احتجاجه.. وودّعنا وهو يلوّح بقبضته، وهو يقول: سننتصر ... سننتصر! وسمعنا صوتَ هذا النورس الأسمر، وهو يصرخ في وجه "تسيمح" القاتل ...
وسمعناه، وكأنّا به يهتف بقصيدته "مليون شمس في دمي" التي يقول فيها:
سلبوني الماء، والزيتَ،
وملح الأرغفهْ
وشعاع الشمس، والبحر،
وطعم المعرفهْ
وحبيباً - منذ عشرين - مضى
أتمنى لحظةً أن أعطِفَهْ
سلبوني كل شيءٍ:
عتبة البيت، وزهر الشرفَهْ
سلبوني كل شيءٍ
غيرَ قلبٍ،
وضميرٍ،
وشَفَهْ!!
كبريائي، وأنا في قيدِهم،
أعنف من كل جنون العجرفهْ
في دمي مليون شمس
تتحدّى الظُّلَمَ المختلفهْ
وأنا أقتحم السبعَ السموات
بحبي لكَ ..
يا شعبَ المآسي المُسرفَهْ
فأنا .. ابنكَ .. من صُلبكَ
قلباً،
وضميراً،
وشَفَهْ!!
يَدُنا ثابتةٌ .. ثابتةٌ
ويَدُ الظالمِ، مهما ثبتت،
مرتجفَهْ!!
بعده جاء عدد من أعضاء الكنيست العرب منهم: محمد ميعاري، وعبد الوهاب دراوشة، وأعضاء من حزب "راتس" اليساري، قبل أن يصبح اسمه "ميرتس" . وبدأ المحامون زيارتنا، واستطعنا، لأوّل مرّة، بوساطة المحامين، أن نتخارج مع الأهل، ومع المدن المشتعلة التي يضيء نشيدُها ودمُها شمسَ الله ونجومَه!
وهنا، لا بُدّ من ذكر المحامي الإنسان محمد كيوان، ابن أم الفحم الذي كان جندياً مجهولاً في دفاعه المستميت عن المعتقلين، وتقديم ما أمكن لهم... رحمه الله! لقد استشهد وهو يحرث أرض أم الفحم لتظلّ عربية!
وهو الذي حمل قصيدة "ونحن سواء" التي كنتُ كتبتها للأخوات المعتقلات والأسيرات في سجن "نفي ترتسيا":
أَكتبُ من نرجس القلبِ
آيةَ حُبّي الكبير اليكِ
وأُهدي اليكِ السلام ،
وأسأَلُ عن مُهرة قيَّدُوها ،
وعن غيم عينيكِ ، أسألُ ،
عن دمعةٍ في المساءْ ،
ومن عندِنا في لهيبِ الصحارى ،
سبعةُ آلافِ واحة عشقٍ
تقدُّ اليك نشيدَ النخيل ،
وتُهدي اليكِ رحيقَ الحُداءْ ،
وترسلُ عبرَ رداءِ الطيورِ ،
جراحات ناي المحبينَ ،
عطرَ الصهيل ووجهَ السماء،
وأسأَلُ : كيفَ تنامُ عصافيرُ حُزْنك ،
في الليل ،
كيف يغرّد فيكِ الهزارُ ،
نهاراً ،
وكيفَ تَشُقّينَ ثوبَ " العتابا " ،
على كربلاءْ ؟!
- وقلبي أحقُ بهذا السؤال -
فنحن نواجه رملَ المعسكر " بالآوف "
نكسرُ وحشَ الصحارى ،
بعُرْس انتفاضتنا ،
لا نكفّ عن الدَبكاتِ ،
ونغمرُ هذا المدى بالغناءْ ...
يا أُختَ روحي التي ما نسيتُ
أراكِ بسجنكِ أحلى وأبهى ،
فلا تستثيري حنانَ اليمامِ ،
وراءَ الشبابيك ،
حتى يظلَّ هديلُ الشتاءْ ،
فقد حرّقتني دمعةُ عينكِ
لما تنزَّتْ ،
قبيلَ الدخولِ لمعنى القيودِ ،
وكنتُ أراك ابتساماً ،
ليورقَ "أنصارُ" عُشباً وماءْ ،
ونحن بدون العوالم:
ندفنُ مَنْ مات منا،
نُشيّع مَنْ راح للسجنِ
أَو للوقوف شموخاً على النطعِ ،
أَو مَنْ تدلّى بأنشوطة الرعب ،
بزغرودة الإِنتماءْ .
يا أُختَ روحي ..
أَأَسأَلُ جوعَكِ كيف يشقّق فيك الجبال ،
وكيف البلابلُ في شفتيكِ تنادي البحار ،
وكيف الزنازينُ تصحو على الصرخات ،
ونحن سواء؟؟
أَأَسأَلُ، والسجنُ غازٌ يُفجّر قلبَ الهواءِ ،
ونحن سواء؟؟ ،
أَأَسأَل، والقيدُ يبدأُ من رسغ كفي ،
في "كتسيعوت" ،
ويمتد حتى يعانقَ كفيكِ
في عتمات سجون النساءْ؟؟
لا بأس !!
فالسجنُ سهمٌ يصيبُ المخابئَ ،
في القلبِ ،
يكشفُ سرَّ الزمانِ الثقيل ،
ويجعلُ ذكرى الطفولة والعشق ،
أشهى العذابِ ،
ويكتبنا سورة للإباء ...!
والسجنُ قبرٌ بكل العصور
وفي عصرنا روضة للصغار الذين ،
أتوا في زوايا الإناء ...
فنحن - بدون السماوات والأرض -
نكبر بالموت ،
نولد في كل حربٍ وسجنٍ
ونُطلق أطفالنا في براري النداءْ ...
والسجنُ من عهد جان سليمان ،
حتى النبيّ الذي راودتهُ زليخةُ ،
حتى "نفي ترتسيا" أوجدوه ،
لحرق البساتين في الصدرِ ،
أَو لاحتواء العواصفِ والأَنبياءْ ،
ولكننا قد جعلنا السجونَ قلاعاً ،
تضجُّ شموساً ،
وسرجاً نطرّزه للعراءْ
شقيقةَ روحي .
إذا ما سأَلتِ ، فأنَّي ما زلتُ حيّاً ،
وكُلِّي شوقٌ لعينيْ هَزار ،
وكلّي وفاءْ .
المرّة الأولى التي سمحت فيها إدارة معتقل "كتسيعوت" للصليب الأحمر بزيارتنا، كانت في نهاية أيار 1988، حيث دخلت امرأة سويسرية وشاب فرنسي، كوفد من الصليب الأحمر ليسمعوا مطالبنا، ويطمئنوا على أحوالنا.
قابلهما الأخوة محمد الحوراني، وموسى أبو صبحة، وعدنان الضميري وجبريل البكري وأنا في إحدى خيمات قسم "1"، وحاولنا أن نشرح لهما كل شيء، وقدّمنا لهما قائمة مطالبنا المشروعة، التي تبدأ بتحسين شروط اعتقالنا، ومروراً بحقّنا في زيارة الأهل لنا وكذلك المحامون، وانتهاء بحقنا في توفير الصحف اليومية والكتب والقرطاسية .. الخ.
كانت الأقلام معدومة، وكذلك الأوراق! لكن الشاب الفرنسي ذاك، نسي عمداً قلمَه لنا، فيما تركت الفتاةُ السويسرية دفترَها الصغير.. ربما استشعرا المحيط المرعب الذي يلفّنا.. فتعاطفا معنا!
بعد شهر، أو أقل، جاءت سيّارة كبيرة محمّلة بالكتب والورق الأبيض والأقلام والمساطر.. مع وفد من الصليب الأحمر، وبدأوا -على مرأى من الجنود- يوزّعون على الأقسام هذه الحمولة التي رقصنا لها! وأخبرونا: بإمكانكم أن تكتبوا الرسائل الشهرية إلى أُسركم... رغم أن إدارة السجن ستراقب كل الرسائل قبل أن نوصلها إلى البريد، لتصل إلى أهاليكم!!
عندها، استطاع المعتقلون أن يقرأوا جيداً قصص وروايات غسان كنفاني، ويحيى يخلف، وسميرة عزام، ورشاد أبو شاور، وإميل حبيبي، وأشعار محمود درويش، وسميح القاسم، وفدوى طوقان، وكمال ناصر .. وأن يحفظوا الكثير منها، وأن يناقشوا، لاحقاً، في الجلسات الثقافية مضامينها وصورها وأشكالها الفنية! وبدأوا يتعرّفون على الوجه الآخر للقائد صلاح خلف "أبو إياد" من خلال كتابه "فلسطيني بلا هوية".
المباح قليل، والمسكوت عنه لا يُحصى! فكيف ستشرح أوجاعك، أيها المتأجج بكيمياء الرغبة، ولمسة البركان المهيب؟ وكيف ستجوح والبكاء عيب في كتابنا المهترئ؟ وكيف لك أن تقذف كل الزجاج المشروخ الذي يُدمي رئتيك؟ وهل تستطيع أن تمارس عادات الجنّ المخفيّ، أو الحصان الذي يشمّ ضفيرة الفرس تحت شمس اللوز، في البراري المفتوحة، للصهيل والنحل والفَراش الموعود بالنار؟
يتحلّقون حول بعضهم البعض .. فتأخذهم اللغة الجمعيّة إلى منابرها وإيقاعاتها الجاهزة .. ومع الشروق والمغيب، يتحللّون من ربقة الكلام المُعلّب .. وينسلّون، بخفوت وتكتّم، إلى الحكايا المُحرّمة، والليالي العاصفة بالنبيذ والشهيق البعيد!
فهل يكتفون؟
إن الغَزَل، والمبالغةَ في عبادة غلالات الليل وبنات حواء، هو آلية تعويض! مثلما تشرح النكاتُ الساخرةُ حالةَ اللارضى، والاحتجاج السلبي، على ما يدور! .. ودائماً ثمة لغة أخرى، تجدها في قاع المدينة، أو على جدران المراحيض العامة والحيطان . وهنا في "أنصار 3"، لغة أخرى أيضاً، تهمس بفحيحها وخريرها، في كل الزوايا، ما يشير إلى أن هذه المجاميع هي مجتمع آخر، له مواصفات البلد .. وآه يا بلد!
وماذا عن الصحف أيها الصليب الطيّب؟!
بعد يومين بدأت إدارة السجن توزيع صحيفة لكل معتقل! والصحيفة هي "كولاّج" مكّون من أخبار مقصوصة من صحف عبرية وعربية وإنجليزية.. تم مونتاجها على أربع صفحات، وتصويرها عدة نسخ... وتوزيعها على المعتقلين!! وبالتأكيد، فإن الأخبار المُمنتجة والمدبلجة، تتحدث كلّها بلسان إسرائيل وتطعن في خاصرتنا!
ولمّا سأل شاويش القسم ضابط السجن عن جدوى هذه الصحيفة، التي لا يقرأها أحد قال الضابط: ألا يقرأها واحد من كل ألف، فقال الشاويش: ممكن ... فقال الضابط: إذا استطعنا أن نؤثر كل يوم في سبعة معتقلين، فهذا يكفينا..
ما الذي جاء بك، إلى هذا الجحيم؟ أما كان بإمكانك أن تتوارى قليلاً، عن عين النار؟ لماذا كنتَ مندفعاً لتكون ساتراً تحمي المدينة؟ هل أنتَ المسيح الذي سيفدي البلد .. وتبكي أُمّهُ؟! أم أنتَ حارس أحلام الأسوار والأغاني؟ كان بمقدورك أن تتشاغل بعملك وأكل عيشك! وكان سيتمّ ذلك بدعوى أن هاجسك الحرف وليس السيف!
بل إنك تخشى من أن يكون كل هذا الألم والصراخ والدم، عبثيّاً ومجانيّاً .. فلماذا العذاب، إذاً؟
وغداً، ماذا ستفيد وتستفيد؟ بل ستخرج، إنْ خرجتَ حياً، إلى رتابة الفراغ والعادة المقيتة! وستكون، في أحسن الأحوال، واحداً من آلاف مؤلّفة .. ولن تتمايز عنهم .. فلماذا لم توفّر على نفسك، هذا الجنون والذلّ، والموت الساقط مع الشمس القاهرة أو النجم البارد؟!
- ماذا تقول يا رجل؟
هل سمعك أحدٌ غيرك؟ اُسكت! فأنتَ الآن رجل حقيقي، وتستطيع أن ترفع رأسك جيداً، وأنتَ تطأ الأرض كالنَمْر الواثق، ولا بأس إنْ ارتفع صوتك في الجلسات، فأنتَ الآن معتقل!!
وسينقلب تاج الرمل هذا إلى هالة من الطمأنينة والرسوخ والمجد .
اعتدلْ في جلستك! واسمع ما يقوله الآخرون .. فلقد ذهبتَ بعيداً، وتركتهم حولك، كأنّ طيراً عظيماً قد حملك إلى سماوات الظلام .. لكنك تعود الآن إلى دائرة الأصدقاء الساطعة .. فلا تنطفئ، وابدأ كلامك من نهايته .. عليك اللعنة!
بإمكانك الآن يا صديقي العزيز أن تكتب قصيدتك التي حفظتها عن ظهر قلب، بإمكانك يا عبد الناصر صالح! أيّها الشاعر المكافح، أن تكتب عن "أنصار 3"، ما يستحق من كلام غير هذا الكلام الفائض. اُكتبْ يا صديقي تلك القصيدة التي نفذت إلى قلبي مثل سهم النور، وأشاعت القوة في روحي ...
أعلنَ الفجر مخاضَهْ
خرج المولود : شعب الانتفاضهْ .
خرج المارد من قمقمهِ
صارخاً ملء الوجود
أزِفَ العهد الجديدْ .
يا عدوَّ الشّمس والإنسانِ
عُدْنا من جديدْ
ورفعنا في جحيم الموت صرحاً للصُّمودْ .
وعشقنا الأرض ملء القلبِ ،
ملء الرُّوحِ
أشهرنا على الباغي السلاحْ .
فاستبيحوا الأرض
لا تنتظروا
وانصبوا الأسلاك من حول البطاحْ .
قَدَرُ الإنسان أنْ يحيا
على نبض الجراحْ .
قدر الجلاَّد أن يهلك في زحف الصَّباحْ
من دمي ينبثق الفتح ويعلو الانتصارْ
من دمي يخرج مليون نهارْ
فاقتلوا المرأةَ في منزلها
واخنقوا بالغاز شيخاً طاعناً بالسنِّ
يا أحفاد هولاكو التّتارْ
وأطلقوا النار على كل الصغارْ
لا غضاضَهْ .
إنّنا ميلاد شعبٍ ردَّ للكون بياضَهْ
إنّنا ميلاد شعب الانتفاضه .
فاحرقوا أغصاننا الخضراء إن شئتم
فللغصن اخضرارْ
والجباه السُّمر إعصار ونارْ
وَهْيَ جيلٌ حطّم الأغلال والقهر
وأهوال الحصارْ
اقتلوني ،
لستُ أرضى عن تلال اللوز
والزيتون والتين استعاضة
واسلبوا أرضي إذا شئتم
فللأرضِ نسيم الجبل الشامخِ
ماء النَّهرِ
أسراب العصافيرِ
وللنّسر إذا ما أزِفَ الصُّبح انقضاضَهْ
فاقتلوا النّسر
وعيثوا في روابينا فساداً
لن تمرّوا
جسدي العاشق للثورة جسرُ
وأنا العاصي على القتلِ
ولحمي يا عدوَّ الشّمس، مُرُّ
وعلى جبهتي السَّمراء يسترسل فجرُ
وعلى أرض بلادي ،
يا عدوَّ الشّمس
لن يمكث قهرُ
فاستمرّوا
أيُّها الأبطال، يا عنواننا الغالي
استمرّوا
لكم المجد وطوق الياسمينْ
لكم الرّاياتُ، رغم السُّحب السوداءِ
واللّيل اللّعينْ
لكم الحريُةُّ الحمراءُ
والنّصر المبينْ
أعلن الفجر مخاضهْ
خرج المولودُ: شعبُ الانتفاضهْ
نهض الماردُ: شعبُ الانتفاضهْ
كنتُ وقتها شاويشاً لقسم "1"، عندما أصدر "إيتسيك" قراراً يقضي بأن نطأطئ رؤوسنا وقت "العدد"، ولما أبلغتُه أمام المعتقلين أننا نرفض هذا الطلب . هزّ رأسه، وضرب عصاه بيده .. ومضى!
عند مغرب اليوم الثاني أخذوني إلى الزنزانة الضيّقة، الموضوعة بجانب ثلاث زنازين أخرى، هي كلها زنازين جاهزة، مكوّنة من بناء اسمنتي وأرضيتها مُغطّاة بكميات كبيرة من الجير "الشيد"، عرضها متر وطولها ثلاثة أمتار، لها بوابة حديدية سميكة... أخذوني، وأدخلوني إلى الزنزانة... وربطوا رجليّ بكلبشة... ويديّ خلف ظهري بكلبشة أخرى، ورموني على أرض الزنزانة وربطوا كلبشة رجليّ وكلبشة يديّ بكلبشة جديدة... هذه تسمى "ربطة الموزة"، حيث يتكور الشخص مثل الهلال، ووقعت الهراوات على كل جسمي، فهل أصرخ أم أحتمل وأصمت!؟
إذا صرخت، فإن هذا معيب لي، بصفتي شاعراً ورئيس اتحاد كتّاب فلسطين، وستهبط معنويات المعتقلين الذين ينظرون إلينا كقيادة للمعتقل!
وإذا احتملتُ وسكتّ، فإن هذا سيجعل الجنود يطمعون في ضربي، وسيقولون في أنفسهم: إن هذا لا يحسّ... فاضربوه.!! لكن صوت عبد الناصر صالح جاءني برداً وسلاماً، حيث سمع هو والمعتقلون صوت الهراوات وهي تزنّ على عظامي ولحمي، وكانت الزنزانة تقع إلى جانب قسم 3، حيث عبد الناصر صالح، الذي وقف على برميل الماء البلاستيكي، وراح بأعلى صوته يقرأ مقطعاً من قصيدة لي ومقطعاً من قصيدته تلك ... ولم يصمت عبد الناصر طيلة الأيام الأربعة التي أكلت فيها ما يكفي من الهراوات، ولم أشهد ولم أذق ما يفعل الشعر بالروح مثلما شعرت في تلك الأيام الأربعة.
كان صوت عبد الناصر الراعف بالشعر يصب في دمي حمماً من الغضب والصمود والجبروت، كان الجنود يضربونني، وكان عبد الناصر يعبئني بالشعر، وانتصر الشعر.. أربعة أيام من العمر الذي لا ينسى، لا أتذكر وجوه الجنود ولا طعم الضرب أو رائحة الزنزانة، كل ما علق ويعلق الآن بأنفي هو رائحة الشعر العابقة الجليلة ... حيث كان يناديني، ويسمعني أشعاره وأشعاري، ويشجعني! ولم أخرج من الزنزانة حتى أعلن المعتقلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ضربي ومعاقبتي ... وأخرجوني.. وكان الرجل محمد الحوراني قد أصبح شاويشاً للقسم .. وليلاقي ما لاقيت بعد أيام قليلة ..
خرجت ولم أنس كلمات صنو روحي عبد الناصر صالح، الذي وصل إلى "أنصار 3" شبه ميت من ضرب الجنود!
- كيف جرى ما جرى لك يا عبد الناصر؟
يقول المعتقلون الذين كانوا في الحافلة التي نقلتهم من معتقل طولكرم إلى معتقل "أنصار 3"، إن جندياً حقيراً طلب من عبد الناصر صالح أن يشتم "أبو عمّار"، فرفض عبد الناصر، فقام الجندي وخبط عبد الناصر على رأسه بالهراوة... وكّرر الجنديّ الطلب... وعبد الناصر مُصرّ على موقفه الشجاع... وما أن وصل إلى "أنصار 3" حتى كان رأسه مثل الباذنجانة الكبيرة المنتفخة ... ومحيط عينيه أزرق .. لكن بصيرة عبد الناصر ظلّت باقية مثل النسر الباشق ... في أعاليه.
ماذا لو مُتَّ؟ وجاءك ملاك الموت؟
ابدأ من أول المشهد، ولا تنس شيئاً
سيندفع الخبر الصاعق بين الجموع ..!
هل تتخيّل المشهد جيداً؟ أكمل إذاً ..
ستجتمع اللجنة النضالية، وستلتقي إدارة المعتقل، لترتيب نقل جثمانك .. وسيحملونك وحيداً إلى أهلك ..
توقف! كيف سيخرج أهلك لاستقبال موتك؟ وكيف سيصوّحون المدينة بصراخهم المفجوع ..
.. وزوجتك، وأولادك، وأمك، وأشقاؤك، وأصدقاؤك.. والجنازة .. وبيت العزاء ..
ترفع يديك، فتمسح دمعة حزنكَ على موتك! وعزاؤك أنك ما زلتَ حياً!
ولكن! لماذا يتكرر هذا المشهد؟ اللعنة ..
ما زلت أحتفظ باللوحة التي رسمها لي (سائد حلمي)، على "بلوزة" بيضاء، أو قميص داخلي، كان أحد قطع الملابس الداخلية التي بدأت تصل إلينا عبر المحامين، من الأهل أو الصليب الأحمر. كنتُ معجباً بسائد حلمي، هذا الفتى الهادئ الصبور، الذي أمضى فترة اعتقاله في الرسم على الفالينات، هدية منه للمعتقلين، شرط أن يُقدَّم له بالمقابل إطار صورة، يُصنع من الكرتون والنايلون، ويتم تثبيته بخيوط ملوّنة، وله إطار معدني خفيف، هو ما يتبقى من أغلفة أنابيب معاجين الأسنان والحلاقة . كانت اللوحة بانوراما لوحدات المعتقل، وفي داخلها الأقسام والساحات والوجوه الغاضبة، وقبضة كبيرة تشقّ كل هذا الوجود، تشعّ من حولها الشمس.
ولعل سائد ابن مخيم العروب الواقع شمال مدينة الخليل، لم يكن خريج معهد للفنون الجميلة، لكنه كان علامة فارقة، طالما اعتمدنا عليها في رسم لوحات، وتخطيط شعارات، نزيّن بها ساحة أحد الأقسام، لتكون جزءاً من احتفالاتنا بالمناسبات الوطنية أو الدينية، والتي، دائماً، كانت تنتهي باقتحام الجنود للقسم، ومصادرة كل المُعلّقات، و"زنزنة" عدد من المعتقلين!
وفي إحدى المرات، كان على رأس حملة الاقتحام نائب مدير المعتقل، وكان ضابطاً يهودياً من أصل ليبي واسمه "ألبرت"؛ كان يتحدث العربية، ويعرف مزاج العرب وعاداتهم وطقوس حياتهم .. وعندما رأى إحدى لوحات سائد.. خرج من فمه صفير إعجاب حقيقي! وغمغم قائلاً: إنكم مصممون على الحياة يا أولاد الكلب! لكن كامل جبيل، الذي كان وقتها شاويش القسم، ردّ له شتيمته بأحسن منها .. فبلع ألبرت الشتيمة .. ومضى!
في الوحدة "ج" القسم الثاني، وفي خيمة رقم 53، كان عبد الله علاونة "أبو الأمجد" ينام على بُرشه، وفوق رأسه تتدلى مُعلّقة سائد حلمي، لقد كانت لوحة لشهيد يضيء بدمه آلافاً مؤلّفة، يحملونه كالراية، في مسيرة هادرة!
ما هذا يا أبا الأمجد؟
- إنها لوحة .. وعلينا أن نُجمّل كل شيء، حيث نقيم .. حتى أحزاننا ..
وعندما دخل الجنود، في ساعة شؤم إلى القسم، لمصادرة الشعارات واللوحات، صادروا لوحة أبي الأمجد.. فبكى، وكان إفراجه في اليوم الثاني، وكان ينوي حمل تلك اللوحة تذكاراً معه إلى البيت . لكنه حمل معناها الساطع، فما أن وصل إلى جبع، قريته الواقعة جنوب جنين، حتى تماهى في تظاهرة اصطدمت مع جنود الموت ... وراح الرصاص ينخّل جسده، حتى رسم، في اليوم الثاني، وفي شوارع جبع، لوحة سائد بنبضها وحيويتها ودمها الحقيقي .
لن يصدّقني أحد ..!
- لماذا؟
لأنني رأيته ..
- رأيتَ مَنْ؟
رأيت الذئب نفسه، ثانيةً، كان ينظر إليّ من خلف السياج، كان، كما رأيته أول مرّة، هرماً متهدّلاً، والدمع يبرق في عينيه .. وكأن الجنود لم يروه أو يحسّوا بوجوده!!
- ألم يره أحد غيرك؟
ربما، لا أدري .. لكنني رأيته .. أقسم لك .. وبعد أن وقف مليّاً متجمداً ينظر إليّ، لفّ دورة كاملة .. وابتلعه الظلام ..
- ربما تهيؤات يا صديقي ..
لا، وسأنتظره الليلة، فإنه سيعود!
بعد ساعة أو ساعتين، جاء صديقي، وأيقظني بانفعال، وسحبني خارج الخيمة، فرأيت الذئب كما وصفه لي صديقي، غير أن ذئباً صغيراً يقطر الدم من عنقه المذبوح، كان مُعلّقاً بين فكيّ الذئب الذي .. ما أنْ رآني حتى عاد بهدوء من حيث أتى ..
هَدَموا...!؟
- وما هدموا سوى بيتٍ
ستُعلي سقفَهُ أيدي الطفولةِ والحجارة
سَجَنوا...!؟
- قد أصبحتْ كلُّ السُجونِ
منارةً تلوَ المنارةْ
قَتَلوا...!؟
- وماذا إنْ غسلنا أرضَنا بدمائِنا
فليقتلوا...
أعراسُنا ارتفعتْ وقد نِلنا البشارةْ
جَرَحوا...!؟
- فلْيجرحوا...
لا بأسَ من تفجير موجِ العشقِ
في جسد البكارةْ
قد أغلقوا...!؟
فلْيُغلقوا كلَّ المنازل
سوفَ نبقى في الشوارعِ
كي نسعِّرها عليهمْ
بالرجولةِ والجسارةْ
قد أبعَدوا العشرات...!؟
- ماذا إنْ حملنا أرضَنا في القلب للدنيا قليلاً
سوفَ نرجعُ بعدَ أنْ نرمي إلى التاريخِ
قُضبانَ "النَّظارةْ"
مَنَعوا التَجوُّل...!؟
- سوفَ نكسرهُ
ونُشعِل في المواويلِ الشَّرارةْ
قَد قَلّعوا الأشجَار...!؟
- سيكونُ تحتَ جذورهَا
قبرٌ لِمَن قصّوا ضفائِرَها المُثارةْ
قَطعوا الميّاه...!؟
- ماذا إذا شربَ الرِّجالُ الظامِئون جراحَهُمْ
وتَهلَّلتْ بهُم الحضارَةْ
مَنَعوا السَفَر...!؟
- السَبْعُ يفتكُ إن تقيَّد في المغارةْ
قَد أحرَقوا...!؟
- فلْيحرقوا
هذي جهنَّمنا صليناهمْ بها
ستظلُّ مؤصدةً تُنادي:
هل سيأْتي من مزيدٍ؟
هل سيأتي من مزيدٍ؟ هل سيأتي من مزيد..
في شهر تموز 1988، أدخل الصليب الأحمر، رقع الشطرنج، والزهر (الشيش بيش والـ 31) إلى أقسام السجن، فوجد عدد كبير من المعتقلين ضالتهم في قتل الوقت، وتمضية ساعات الرمل الثقيلة . وأدخلت إدارة السجن "المقاشات" (صواني بلاستيكية مستطيلة لسكب الطعام في مربعاتها التي تفصلها خطوط بارزة) وأدخلت "القعارات" (صحون بلاستيكية كبيرة الحجم، قد تتسع لثلاثة ليترات من الماء) .. فاجترح المعتقلون لاستغلال هذه "القعاراه" معجزات مضحكة، أوّلها أنهم قطّعوا الخبز إلى مربعات صغيرة في القعاراه، وسكبوا كؤوس الشاي على الخبز حتى يرنخ، ثم يضعون قطعة المرجرينا "الزبدة" على سطح الخبز، ثم يقطعون أصابع الموز فوق كل ذلك، ويعصرون برتقالة أو اثنتين، ويتركونها قليلاً.. ثم ينقضّون عليها! وهم يفعلون ذلك، كعملية احتيال لإيجاد وجبة جديدة يسكتون بها نداء أمعائهم الخاوية . أما أبو عاصف البرغوثي وأبو محمود السلوادي، فلهما طريقة أخرى في استغلال "القعاراه"، حيث يدلحون فيها كمية الرز والشوربة وقطع الخبز وحبات الزيتون وشقفة المرجرينا والشاي .. دفعة واحدة، ثم يحركون بملاعقهم البلاستيكية هذه الخلطة .. ويبدأون التهام "القعاراه" وما فيها! وفتحي جرادات يجحظ بعينيه، ويفركهما.. غير مصدّق ما يرى!
مرّ أُسبوع، ولم يدخل بطوننا سوى الماء والملح.. وربما سيطول الإضراب عن الطعام .. وهنا تتفتق خيالات المعتقلين عن "أكلات" عجيبة! وقد هدّهم الجوع!
وفي هذه الأثناء، تتأكد من أن الله، عز وجل، لم يُخضع الإنسان إلاّ بالجوع أولاً .. ثم بالنار والويل والثبور..
يجلس المعتقلون، يتذكر كل منهم ألذ طبخة، وأطيب طعام... فيقول قائل: تخيلوا لو أن الله ينزل علينا طنجرة ملفوف أو محشي! ويقول آخر: تخيلوا أن "منسفاً" أمامنا الآن.. ماذا سنفعل به؟ ويقترح ثالث أن نتذكّر طبخة "المنزّلة" أو "البامية في الطابون مع لحمة رأس عصفور".
أما أغرب ما سمعت، أن معتقلاً تخيّل "مرج بني عامر" مليئاً بالرز المغطّى باللحم، وتمطر السماء "شوربة".. ونأكل بالمعاول!!
فيما رأى آخر أن برندة بيتهم مُغطاة بالكنافة .. فينزل من نافذة الشُرفة، ويغطس في الكنافة ..
أما الشيخ أحمد، فكان يدعو الله تعالى بأن يأمر الولدان المخلّدين، أن يهبطوا من الجنة، ويأتوا إلينا حاملين صواني اللحم والفاكهة والخمر الحلال .. وننام، وعلى أطراف أفواهنا بقايا ضحك ناشف، وما تبقى من صور اللحم والموز، وكلمات تدعو لأبي الشمقمق ...
ولا سامحك الله يا ابن الرومي الذي تلمّظت أمام الزلابية العباسية الطافحة بالسمنة والسكر .. ولم تأكلها عنوة.. بالسيف.
دائماً كُنا نضع جانباً لبّ الخبز، ونلفّه في كيس بلاستيكي، ليحتفظ بنعومته، ونلحف في طلب تهريب رؤوس البصل من المطبخ .. وما أن ندخل الخيمة بعد العاشرة ليلاً، حتى يدفعنا الجوع إلى البحث عن أكياس الخبز وفحول البصل، ويكون عشاؤنا خبزاً وبصلاً .. وننام! وما أن نستيقظ صباحاً، حتى يكون "الفسفور" قد عبّأ الخيمة .. ويا سلام! على الروائح التي تفوح مع كل حركة، أو تحية أو تثاؤب كسول!
وغالباً ما كُنّا نُطرّي لقمة الخبز والبصل بكأس شاي ساخن!
- كيف؟
كان بعض المعتقلين يتفنّنون بإتقان عمل الفتايل "بابور الورق"، حيث يحضرون لفافة ورق تواليت، ويفردونها .. ثم يغطّون سطح كل الورق بمادة المرجرين "الزبدة" ويعيدون لفّ الورق كما كان .. ويشعلون سطحها.. فتصبح مثل رأس الغاز! ثم يأتون بعلبة فارعة من مطبخ السجن، كانت إحدى المعلبات، ويجعلون لها يداً من أسلاك تلتف حول عنق العلبة .. يدلحون فيها الشاي، ويحملونها مثل القنديل فوق اللفافة المشتعلة .. حتى يسخن الشاي .. وبعد حين صرنا نشرب القهوة الساخنة.. منتصف الليل، وفي الشتاء الذابح! تخيلّوا!!
محمد روحي الملقّب بـ "أبو سلاح" شاب وطني صلب وهادئ، يحبّ أشعار محمود درويش، والحديث عن أسرار النساء.. وطالما شربنا سويّة الليالي مع القهوة، التي أعدنا تسخينها على "الفتيلة" .. وكان أول مَنْ قرأ مسودات "فضاء الأُغنيات" ديواني الشعري الثاني في المعتقل، بعد ديوان "زمن الصعود"، .. وكان قد اقترح عليّ أن أُسميّه "جمهورية الخيام".
.. "أبو سلاح" هذا، كان يحمل، إحدى الليالي، علبة القهوة، المعلقة كالقنديل، فوق نار الفتيلة .. ولم ينتبه إلى أن القهوة كادت تتبخّر لكثرة تقلّبها على النار .. فأشرتُ إليه لينتبه ..!
- أين سرحت يا أبا سلاح؟
ابتسم أبو سلاح، وأنزل قنديل الماء البنيّ من يده، وضرب كفاً بكف .. وضحك، كأنه سمع نكتة طازجة!
- مالك يا أبا سلاح؟ أضحكني معك ..
قال "أبو سلاح": نفسي أن أبطح الشحرورة وسط الشارع الرئيس الذي يقسم وحدات وأقسام المعتقل .. وأمام الجنود وكل المعتقلين .. أوقفها، وأخلع ملابسها قطعةً قطعة.. وأرفع ... وأضعهما على ... و...ضحكت .. وضربت كفاً بكفّ .. فيما تعالت ضحكات اثنين آخرين اعتقدت أنهما كانا نائمين.
- ما بكما تضحكان .. يا ملاعين!
اعتدلا في جلستيهما .. وضحكا من جديد .. لقد كانا يحلمان أن يفعلا في الشحرورة مثلما حلم أبو سلاح ..
بعد عام تقريباً، من افتتاح هذا المعتقل الذي شطروه إلى نصفين، الأول لمعتقلي أبناء الضفة الغربية، والثاني لمعتقلي أبناء قطاع غزة، في محاولة من إدارة السجن لتعميق الفصل، وعدم إتاحة الفرصة لتكريس وحدة الحال، بين أبناء الشعب الواحد.
قلنا بعد عام من افتتاح هذه البقعة الجهنمية، أدخل الصليب الأحمر، ولأول مرّة، علب الحلوى والملبّس، لمناسبة حلول عيد الفطر، إلى المعتقل، وصدرت التعليمات لكل الأقسام أن يقيموا صلاة العيد جماعة في ساحات الأقسام، ومهما تكن النتائج!! وتمت الصلاة، ولم تستطع إدارة المعتقل فعل أي شيء لتعطيل هذا القرار الجماعي الحاسم! واصطف المعتقلون في دائرة واسعة، في ساحة الأقسام، ووقف أحد المتحدثين المميزين ليلقي كلمة في المعتقلين، يشدّ أزرهم، ويهنئهم بالعيد، ثم صافح بعضهم بعضاً، وتناولوا حبة حلوى .. لم تستطع بالتأكيد أن تطفئ مرارة الحزن والفقد، أو تمنع بعض الدمعات من التقاطر الخجول.
ونادراً ما كان معتقل يعلم بموت أبيه أو أمّه أو أحد أقاربه، لصعوبة الاتصال مع الخارج، إلاّ إذا جاءت دفعة جديدة من المعتقلين، أو نقل أحد المحامين الخبرَ إلى السجين! عندها كانت لجنة القسم تفرغ إحدى الخيمات، وتحيلها إلى بيت عزاء، فيأتي كل المعتقلين قاطبة لتقديم العزاء إلى السجين المُصاب .. ويتبرع أحد الأخوة بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم طيلة فترة تقديم العزاء، ثم يقرأون الفاتحة على روح المتوفى، وينفضّ العزاء، شرط أن يتم فرز ثلاثة من بلديات المُصاب أو أصدقائه، ليظلّوا معه طيلة أيام أخرى، للتخفيف عنه، ومشاركته ساعاته الصعبة الموجعة.
الكآبة هلاك، ينبغي ألا تصدع لها، وإلاّ دفعتك إلى حافة الجنون، لهذا، عليك أن تخرج من دوّامتها فوراً، وأن تستنفر كل أسباب قوتك وثباتك، وتطردها، كما يُطَرد الشيطان من الروح البريئة.
وعليك أن تشغل نفسك بالقراءة، والأفضل بالجلوس مع مَنْ تحبّ وتستريح، وأن تواجه حالة الاكتئاب بعقلك، وجهاً لوجه، كأنك طبيب نفسك، تجمع كل عوامل الثقة والاطمئنان والقوة والزهو التي بداخلك، وتجعلها متراساً في وجه هذا الهواء الفاسد الغامض .. ومرّة تلو أخرى، يتراجع الاكتئاب، ويصبح أكثر هشاشة وضحالة وخفّة!
والسجن أرض خصبة لهذا النبت الشيطاني الذي يشبه الأفعى، أو الفأر النجس! وكلما تراكمت الهموم، تسللت الأفعى بنعومتها السامة إلى وريد القلب، وكلّما حضرت الأحزان والأسى دخل الفأر قلبك يقضمه بأسنانه المسننة!
والكآبة معادلة كيميائية كاملة، لا تؤثر في النَفْس أو الروح فقط، بل تحس بحِبال أفاعيها، وهي تلتف حول مضغة صدرك، لتهتك أستاره، وتوقف تدفّقه النوري .. البهيج! بل تخشى أن يحتشد قلبك، فجأة، برغوة الكآبة، فيضيق مجرى التَنفُس، وتصبح على موعد مع السيد عزرائيل!
ولعل حدوث اللامتوقّع، المخيف، أو ما لا نعرف نهايته هو السبب الرئيس للكآبة! ولسوء الحظ أن كل هذا، وأكثر منه، يحدث كل لحظة، ويقع أمام عيوننا، يومياً، في المعتقل، ونلمسه على جلودنا وجدران روحنا.. ورغم كل هذا، نُبعد هذه الكآبة بالحياة، بكل مكوناتها، من الكلام .. إلى الغناء، ومن المجابهة إلى التصميم الأمر الذي يعيد صياغتنا، ويجعلنا أكثر قدرة، وخرقاً للعادة، من غيرنا.
لم تكن الدولة العبرية بحاجة إلى سبب لاعتقال الفلسطينيين، فثمة قانون "يُشرّع" لها كل ما تريد، بدءاً من القوانين العسكرية، وانتهاءً بقوانين الطوارئ البريطانية البائدة، التي تجيز كل أشكال القمع والاستلاب وإزهاق الأرواح، بدعوى الحفاظ على الأمن والنظام!؟
ويقف "الاعتقال الإداري" في مقدمة قوانين الطوارئ، إذ يحق للدولة المحتلة حجز الإنسان ستة أشهر، دون إبداء الأسباب، كما يحق لها تجديد أمر الحجز أو الاعتقال ستة أشهر أُخرى... وأخرى ... دون سقف أو تحديد. لهذا عمدت إسرائيل إلى هذه الحيلة "القانونية"، التي أتاحت لها اعتقال اثنين وأربعين ألف فلسطيني منذ تموز 1967 حتى تموز 1993، حيث أمضى بعضهم عشر سنوات في الاعتقال الإداري، أو عشرين أمر حجز إداري!
وتذهب الدولة العبرية حتى النهاية، في لعبتها "القانونية" هذه! إذ تحيل المُعتقل إدارياً إلى المحكمة العسكرية، لتثبيت اعتقاله، إن كان ثمة أسباب موجبة لذلك، أو لإطلاق سراحه، إذا لم يقتنع القاضي بأسباب الاعتقال. لكن التبريرات جاهزة، والمسببات حاضرة ومفبركة ومقنعة، الأمر الذي جعل تلك المحاكم صورية مئة بالمئة!
كُنّا نقف أمام "القاضي" العسكري الذي غالباً ما يكون ضابط مخابرات، وينبغي أن يكون مع "المتهم" محامٍ ليترافع عنه.. وتبدأ اللعبة - المحكمة، وباللغة العبرية الفصحى... ولمّا يطلب المحامي من القاضي كشف أسباب اعتقال موكلّه، يبصق القاضي تلك الجملة الشهيرة التي تنهي المحكمة، ألا وهي "هناك ملف سرّي"! .. وبعد دقائق يصدر قرار تثبيت حكم الاعتقال.
بعد أن أنهيت الأشهر الستة الأولى، أي الاعتقال الإداري الأول، الممتد من 18/2 - 17/8/1988، تم إطلاق سراحي! .. لكن المخابرات الإسرائيلية، وبعد عشرة أيام، دهمت بيتي ليلاً، وقلبته رأساً على عقب، بعد أن حطّمت الأثاث، ومزّقت الفِراش ومقاعد الكراسي، وصادرت كمية كبيرة من الكتب، وأخذتني معصوب العينين، وبعد شهرين من "الحجز الإداري"، كان ثلة من المحامين يترافعون عنّي في المحكمة، شأني شأن الكثير من المعتقلين، ولمّا بيّنوا للمحكمة أنه لم يكن أمامي وقت كاف "للاعتداء على النظام والأمن" لأنني، ببساطة، كنتُ معتقلاً، أجاب القاضي بأنه ثبتت على المتهم حيازة مواد تحريضية ممنوعة! ولمّا سأل المحامون عن تلك المواد، قال القاضي: ديوان شعر ذو مضمون عدائي ضد دولة إسرائيل، ومؤلّفه المتوكل طه. وعندما حاول المحامون إيضاح الأمر للقاضي بأن مؤلف الكتاب هو نفسه الذي يقف أمامه، رفع القاضي نظارته عن عينيه، وقال: إذاً لدينا سبب آخر لتثبيت حجزه واعتقاله.
معطف الليل من هواء! يفرد جناحيه وسادةً لإعادة ترتيب الأشياء، أو ليأخذ العيون إلى رحلة الغموض، أو الموت المؤقّت . والليل يبسط حريره البارد تحت رأس المُتعبين، فيمتصّ الغيظ والعرق المتيبّس، ويعرّي الغافي من كل حباله وقيوده، ويُطْلقه جناحاً يَغمس ريشه في الشهوات الممنوعة، أو ليتخطّى أسوار النهار، أو ليُخرج كل الرمل بصرخة كابوس حاد، واهتزاز الماء المتصبب من الجبين.
والليل يبدأ مشدوداً .. لينتهي بالركود الهادئ.
نتمطّى على الفِراش الفقير، ونسند رقابنا على جدار مُرتّب، فيظلّ الجسد في مكانه، فيما تذهب الروح إلى أحلام يقظتها ...، وتعود لتصطدم بالنتوءات الصعبة، والمشاهد المكفهرة الخشنة.
ماذا حلمت أيها الراكض خلف خيط الوهم اللذيذ، هل وصلت إلى البيت، وكشفت الغطاء عن الجسد الرَخِص البضّ.. وماذا بعد؟ هل أكملتَ الصورة التي ستظل ناقصةً ما دامت الحياة..؟
تتعب الروح من مشاويرها البعيدة .. فيتسلل الوسن إلى صحنين ذابلين، هما عيناك .. وتنام!
"إيتسك" و"راز" ضابطا الأمن في معتقل "أنصار 3"، يعرفهما المعتقلون بمشيتيهما وهما يتبختران بين الأقسام، كل حينٍ وحين . وكان كثير من المعتقلين يتشاءمون من هاتين البومتين الأنيقتين!
كان ضابطا أمن المعتقل يُرسلان في طلب بعض السجناء، وبالذات أولئك الذين ليست لهم تجربة في عالم السجن والاعتقال، وأساليب الدهاء في التحقيق والإسقاط ... ويشنّان حرباً نفسيّة على "المطلوب"، ويضعانه في أجواء مخيفة وترقّب طويل، حتى تصبح "الفريسة" سهلة الوقوع في الفخ! ثم يُدْخِلان "المطلوب" إلى غرفة مكيّفة نظيفة، ويجلسانه على مقعد مريح، وأمامهما قنينة ماء مثلّجة وكوكاكولا وسجائر فاخرة، ويبدآن معه التحقيق . فواحد منهم "يشدّ" والآخر "يرخي" ... وتستمر لعبة الترهيب والترغيب ... ثم يطلبان منه أن يتخلّص من سعير المعتقل وأيامه القاسية، ويهوّلان الأمور له، ويهددانه، ثم يدّعيان أن لديهم أخباراً تفيد أن المعتقلين يشكّون به، وينظرون إليه كمشبوه! ... ثم لا يطلبان منه أن يتعامل معهما مباشرة، بل يقولان له: سنُطلق سراحك في المحكمة، وسنلتقي معك في أي مكان تريده.
لقد أفادت التقارير أن النسبة الغالبة من "المطلوبين" انتصروا على "إيتسك" و"راز" ... ولم يقعوا في مطبّ السقوط. وقد تنبّهت قيادة المعتقلين إلى الأمر مبكراً، فبدأت شرح كل هذه الأمور للمعتقلين المستجدين، على طريق تحصينهم، وخلق مناعة كافية لديهم، ليستطيعوا مواجهة ذلك الموقف! ثم، وبطريقة غير مباشرة، تم فرز مجموعة من المعتقلين المجرّبين، لالتقاط مَنْ يعود من المقابلة... للاستفسار منه عمّا جرى ودار... ويرفعون تقريراً للجنة الأمنية المعنية بالأمر، لمتابعته، أو لاستخلاص العبر منه.
كان ثمة رأيان، للمعتقلين، يتغالبان، لتسيير أمور السجناء. الأول يسعى إلى ضبط كامل الوضع في السجن، بطرائق هادئة، بعيدة عن إثارة الهوَس الأمني والضبط الحديدي، بل الدفع بالتي هي أحسن، ورصد المشبوهين، دون فتح زوايا للتحقيق معهم وإخافة ضعاف القلوب والنفوس، والعمل ما أمكن لعدم الانجرار لمصادمة إدارة السجن، وخلق حالة مشدودة حذرة، كلها ترقّب، وطوارئ... والرأي الثاني، يسعى إلى تأزيم العلاقة مع إدارة المعتقل، ومصادمتها، والتحقيق مع المدسوسين، ومعاقبتهم، وخلق أجواء صارمة، وقيود حاسمة وتعليمات رادعة لضبط كامل الوضع في السجن!
وأعتقد أن الرأي الأول هو الأكثر عافية وصحة وذكاء، وهو الذي ساد وغلب! وهذا ما جعل مُناخ الحياة في السجن مُحتملاً ومعقولاً، وغير منفّر للمعتقلين الجدد، الأمر الذي جعلهم، وبعد الإفراج عنهم المرة الأولى، يعاودون نشاطهم الوطني خارج السجن، ويعودون ثانية، مطمئنين، راضين مرضيّين إلى "أنصار 3" أو غيره من المعتقلات.
مدينة العذاب، "أنصار 3"؛ هذا المعتقل الصعب أظهر وأخرج أجمل ما فينا، نحن المعتقلين الفلسطينيين، كما أوضح أسوأ ما في الجنود الإسرائيليين ... لأن مهمّتنا كانت تقضي أن نتربع على عَرش الزلزال، مثلما دفعتهم أوهامهم إلى التشبّه بأبشع المخلوقات، وتمثّل أكثرها دموية!
ولعل ذهابنا بالجَمال إلى أقصاه، هو الذي خلق لدينا قوّة إضافية! ولا أعني جَمال المكان، بقدر ما أعني عيوننا الجديدة ورؤيتنا العميقة المختلفة، التي رأت المكان، وسبرت غوره، وأحاطت به وأدركته، واجترحت الأشكال والآليات المناسبة، للتعاطي معه، بحيث ظل المكان تحت سيطرتنا ما أمكننا ذلك.
والجمال داخلي بالضرورة، يتعلّق بتجاوز نقاط الضعف فينا، بعد التوقف أمام الخاصرة الضعيفة، أو الثغرات في تربيتنا الجمعية.
والجَمال، هنا؛ قوةٌ حالت دون تفريغنا، من محتوانا النضالي والإنساني والثقافي، وخلق حالة من العدمية فينا ... ورافعةٌ اعتلت بنا، فوق مشاريعنا وأحلامنا الفردية؛ بدءاً من الغرائز المكتسبة، انتهاءً بنفي الخوف، في ظل التماهي الجماعي، والتشابك الدافئ الذي طرد الإنكفاء والتراخي والإحساس المرضيّ بالوحدة.
بدأت رسائل الأهل تفتح لنا نافذة نتنفّس من خلالها، وأصبحت صور الزوجة والأولاد تطمئننا عليهم، وشيئاً فشيئاً، بدأت الخيمات تعجّ بالصور المعلّقة بإطارات مصنوعة في المعتقل، كُلٌّ يُعلّق صور أسرته فوق رأسه، وغالباً ما تلاحظ معتقلاً يسرح مع تلك الصورة المعلّقة بصمت صاخب أمامه! كأنه يقول:
يا امرأتي التي أهوى
أُحبّكِ كالخرافةِ والعَذابْ!!
ومُنايَ أنْ أمشي إلى كَسَلِ المَفاصِلِ
بالزوابعِ والرُّعودِ
وأنْ أرُشَّ على نُعاسِ عيونِكِ النَّجلاء
شهْدَ البرْقِ
أوْ هَلَعَ التَّوجُّعِ والتلذُّذِ والغيابْ
وأُحَرِّقُ الزَغبَ الطريَّ، وأشتهيه
وأُشعِلُ الصَّدرَ الشهيَّ، وأشتهيه
وأُوقِدُ الجَسَد المُبلَّلَ بالأوارِ، ويَشْتَهيني
ثُمَ أُوقِدُهُ ... لنغرقَ في الضبابْ
وتطولُ غفوتُنا
لنرجِعَ كي نذوبَ معَ التموّجِ
تسحقينَ الشمسَ في ظهري
وتسكنني البحارُ الصاخباتُ
أروحُ مع دوَّامةِ الأضواءِ
تصهرُني الشراسةُ
أرتضي موتي
وأعبدُ فيكِ ريحَ الندِّ والغاباتِ
أخلعُ وجهيَ الشرقيَّ
ما دامتْ تضاريسُ الخصوبةِ
لم تُدجِّنْها الخشونةُ والصلاةُ ...
أحبُّ دفني فيكِ يا هذي
خُذيني، وافتحي كلَّ المعابدِ والمُهودِ
فإنني طفلٌ يُخربشُ فوقَ ألواحِ الإلهِ
طقوسَ مولدهِ الشقيِّ
أُحبُّ تشييعي على بحرِ الرَّذاذِ
اللاّهبِ الورديِّ
أهبطُ في بهاءِ اللذَّةِ القُصوى
ويجذبني القرارُ ...
يطيبُ منْ فمكِ الرِّضاب .
ويكونُ يا امرأتي
بأَنا قد زرعنا عشقَنا طِفلاً
تزيّا في الحَنايا مثلما شِئْنا
فنامي كي يتمَّ الحملُ
فالحَمْلُ نُضوجٌ وشقاءٌ واصطِحابْ ..
وَغداً هُزّي جذوعَ النخلِ
إن شقَّتْ بُروقُ الألمِ الصَّاخبِ لحمَ القلبِ
طوبى لرِهام العَرقِ الفضيِّ
ينسابُ معَ الأوجاعِ
لا بأسَ على الآهِ
ودمعِ الجُرْحِ
لا بُدَّ من الصرخةِ حتى نكسِرَ الصمتَ
ولا بدَّ من الموتِ لنحيا
فإذا كانتْ فتاةً
خضِّبيها بدمِ الجرحى ليومِ العُرْسِ
أو كانَ فتىً
فلْتزفِّيهِ إلى عُرسِ الشبابْ .
واجعلي أثوابَهُ من رايةِ الشعبِ
احمليهِ بين كفيكِ لمتراسٍ عنيدٍ
واغسليهِ بدخانِ العَجَلِ الشمسيِّ
قومي واسمعيهِ أُغنياتِ النارِ
قومي عمِّديهِ بجلالِ الثارِ
قومي واجعلي أيقونةً من حجرٍ صَلْبٍ
على صدْرِ صغيري ...
وفي فترة الاعتقال الثالث، كان موعد ولادة زوجتي! وربما لم أكن قلقاً عليها، لأنها محاطة بعائلتها وأهلها، وباهتمامهم الحريص ورعايتهم الكبيرة، ودلالهم الواضح، ولأن زوجتي من النوع الصلب الذي يستوعب تغيّرات الحياة، ولا يَنكسر أو يَنهار أمام حدث هنا أو أمر هناك! بل إن مرونتها ووعيها وتجربتها في الحياة علّمتها أن تكون واقعيتها سبباً لصالحها ومعها، وليس عليها.. وبعد أيام وصلتني رسالة تبشّرني بميلاد "نوّار" الآية الثانية، على ألواح قلبي، بعدَ أن ملأت "هزار" حياتنا بهجة وحيوية!!
.. هل أَتوكَ ليخبروك
بأَنَّ نوّار البهيّة قد أتتْ
ما أجملَ الأطفالَ!!
آهٍ لو تراها .. تُشبهك
عينان من عسل البحار
وشعْرها حنّاءُ أعراس الهزار
لكنّهم أخذوكَ منها،
من ضفائرها الصغيرةِ،
من مُناغاةِ الشفقْ ...
- هل تذكر تلك الليلة؟!
كانت متجاوبةً دون اتفاق مسبق، كأن ورقة الليمون التي طبعتها على بوابة الدار، و"الصمْدة" وتلك الأغاني الهائجة الحلوة، كُلّها تؤذن لأن يدخل الرجل على زوجه، فتخلع، لأوّل مرة، كل ثيابها، وتندسّ تحت حرير الترقّب واللمعة الخارقة، التي ستجعلها امرأة من جديد، وتطوي سنوات الفتوّة، وتضعها على مدرج الأمومة .. والغرق الحلال!
- أين أنتِ الآن .. أما كان بمقدور أمكِ أن تلدك طائراً يحطّ أنّى شاء، ويهبط حيث ربابة الشهوة الجارحة!
عليكَ أن تنسى، وأنت تذرع دروب "جمهورية أنصار"، كل النساء .. وأن تُبقي نفثاتك المحمومة، وخيالاتك الفوّارة، في ثلج العمل، وأن تُحنّط صهيلك، إلى الكشْف الآتي..
- لكنك تتحسس في الليل عنق النار، وتخشى من فيض العسيلة، ودفقة صبابات الخيال!
سأحبس النار في القمقم، حتى ييسر لهذا الجان، مَنْ تحكّ فانوسه السحري .. وبعدها، ليكن الطوفان ..
- ذكّرتني بالجنّيات اللواتي يعشقن الرجال، لماذا لم تعشقني جنيّة مليحة، وتأتي بطاقية الإخفاء، لتطفئ هذا الموقد؟؟ أين أنتِ أيتها الجنيّةُ .. تعالي .. واصحبيني إلى مدن النحاس البعيدة .. الغارقة
في قيعان الماء ..
كان بعض الذين أُفرج عنهم، يبعثون بصورهم وهم يجلسون قبالة "صدر منسف"، أو "كوم لحمة مع الرز"، أو وهم يلتهمون "صدر دجاجة" ... ليغيظوا بها أصدقاءهم الذين خسروا أكثر من عشرين كيلو غراماً خلال الأشهر الستة الأولى في السجن.. وأصبحوا رشيقين أكثر من اللازم، ويصلحون "مانيكات" رجّالية لعرض الأزياء! كما كان يقول جمال الديك هذه الجملة .. دائماً، ويُوجّهها لعلي الرجوب السمين "الناصح"، كلما رآه!!
وخوفاً من أن تصبح لنا جدائل وضفائر مثل الخنافس أو الجييز أو البوهيميين، وخوفاً من انتشار القمل والبق ... حرصنا على حلق شعر رؤوسنا، وبالأمر التنظيمي الصارم! وكان حلاّق القسم (حسام الحرامي)، ابن قرية جيوس الواقعة شمال شرق قلقيلية، وهو صاحب صالون "الناطور والحرامي" في مدينة طولكرم! كان شاباً مهذباً ذوّاقاً، ولا يشبه أخاه غسان الحرامي، الذي تعتّق في الظُرْفِ والسجون.. وجاءنا، هنا، ليكون، حيثما حلّ، سبب الضحك العالي، وخفّة الظلّ، وسرعة البديهة الفكهة الحاضرة.
وبعد أن يُنهي "الحرامي" حلق رؤوسنا، يقوم بتسليم عدّة الحلاقة لمسؤول المخزن الجندي الإسرائيلي "شوكي" الذي كان يخاف، لسبب غامض، من قدورة موسى، مُمثّل المعتقل في المطبخ والمخزن!
لم أكن أرغب في توضيح سبب خوف "شوكي" من قدورة موسى، لكنني سأقول... ومهما يصير .. يصير!
كان قدورة أو "أبو موسى" يأخذ من المحامين مبلغاً من المال، ثم يعطيه لـ "شوكي" ليشتري لنا أجهزة راديو صغيرة، حيث يأخذ "شوكي" ثلاثة آلاف شيكل، ليشتري لنا أجهزة بستمئة شيكل، والباقي يأخذه لنفسه، الأمر الذي وفّر لكل الأقسام أجهزة راديو وبطّاريات. أي أن أبا موسى "كَسَرعَيْن" "شوكي" ... وأصبح يطمع في أن يشتري لنا ما نشاء، شرط توفير مبلغ مُغرٍ من الشواكل!
كانت اللجنة الإعلامية تتسلّم المذياع، وعليها أن تسمع نشرات الأخبار، وتلخّصها، ثم يتم تعميمها على الأقسام، وكان إبراهيم رمضان المسؤول عن كل أجهزة الراديو ومتابعة أحوالها، وإخفائها .. وبهذا لم ننقطع لحظة واحدة عن المحيط المتفجّر الطاحن! وهنا لا ننسى أن نشير إلى الصديق الصحافي سالم أبي صالح، الذي كان يوحي بعظمة وأهمية وخطورة المهمّة التي يقودها وهي "سياقة" المذياع، وقيادة الدفّة الإعلامية، ونشر رذاذها اللامع الحلو (التقارير والأخبار) إلى كل الجهات، عدا قيادته القسم الذي استشهد فيه بسام السمودي يوم 16/8 المشؤوم ... وجدع يا أبا صالح!
دخل "ألبرت" اليهودي، الذي لم يعد ليبيّاً، مع أكثر من مئة جندي، أيديهم على الزناد، فجأة، إلى القسم! وأمروا المعتقلين أن يجلسوا لـ "عدد" استثنائي، فجلس الجميع، وراح الجنود يفتشون بين الأبراش والبطانيات وأكياس ملابسنا الداخلية ... وأخيراً عثروا على "المذياع". وتم استدعاء شاويش القسم منير العبوشي للتحقيق معه عن كيفيّة دخول المذياع، رغم تلك الإجراءات والتفتيشات! وكاد ألبرت يفقد أعصابه، ويصيبه الجنون: كيف أدخلتم الراديو؟؟... وأخيراً طلب ألبرت من منير العبوشي أن يعلمه كيف تم إدخال المذياع، ووعده بأنه لن يعاقب القسم بالسجائر أو بمنع زيارة المحامين أو بوقف الرسائل، لكن منير العبوشي وجد جواباً مقنعاً وهو أن الجنود الإسرائيليين وضعوا هذا الراديو بين أمتعتنا، ثم ادّعوا انهم وجدوه ...
ولمّا سأله ألبرت: ولماذا نفعل ذلك يا عبوشي؟
قال له منير: حتى تعاقبونا يا ألبرت!
وتمت معاقبة القسم أسبوعاً كاملاً بالسجائر والقهوة والرسائل وسماع "صوت إسرائيل".
سلك معدني شديد يلتف حول رأسك، يشتدّ، ويضيق.. فتنهض من نومك، وتجلس حتى تتأكد أنك لن تموت الآن!
وتحاول أن تتشاغل، وأن تفرك صدغيك .. وتنظر حولك، فترى نزلاء الخيمة نياماً، وموسيقى الشخير العالي تتعاكس وتتقاطع، كأنها أوركسترا موزّعة بين شخير هذا وشخير ذاك ..
- فكيف سيبارحك الأرق، وينقطع السلك المعدني، وتنام؟
تشعل السيجارة الأخيرة، وتنظر لعلّ أحداً من الزملاء، أصابه الأرق، لعلّكما تتسامران .. فيقطع تفكيركَ صوتُ الموسيقى السفلى التي، غالباً، ما تعقبها رائحة البيض الفاسد!
إذاً، كيف ستنام!
اللعنة على المعتقل، وعلى الليل والأرق ..
تحاول أن تدفن رأسك تحت البطانية الوسادة، فتختنق من رائحة الرطوبة المشبعة الثقيلة .. وترفع رأسك .. وتبقى بين يقظة وصوت وشخير ورائحة .. حتى تنكسر قشرة الليل، ويبدأ الديك البعيد بإيقاظ الشمس.. وبعد ساعة، ربما، تستيقظ مضطراً لـ "العدد" ..
تمشي متثاقلاً، كأن رمحاً قد فخت جمجمتك، واستقرّ في جبهتك، أو كأن رأسك قد فارقك من صداعه المهلك، وشظاياه الحارقة ..
يا إلهي! ما الذي جاء بي إلى هنا!؟
لم تكن "الجندرمة" قادرة على قتل تلك الأفعى التي يتحدثون عنها، غير أن عاملي التنظيف والطبّاخين الذين كانوا يحملون بقايا الطعام والخضروات في أكياس وسلال لإلقائها في الحفرة العميقة التي وجد الجميع أنها مناسبة لاحتواء كل البقايا والفضلات البشرية، كان هؤلاء العمال يسمعون صوتاً أقرب ما يكون لصفير الزوبعة، قادماً من جنبات الحفرة ومغائرها وشقوقها الكثيرة والعميقة، لكنّ جندياً انكشارياً ابيّضّ شَعره فجأة، أقسم على المصحف، وهو ينتفض راجفاً، أنه رأى أفعى بحجم مئذنة قريتهم.
في المساء، أمر الضابط العسملّي بإشعال نار ضخمة حول الحفرة، وبعث في طلب شيوخ القبائل المحيطة ليتبيّن قصة أفعى تلك الحفرة. أجمع شيوخ القبائل؛ على أن هذه الحفرة انشقّت فجأة إثر رعدة شتوية صعقت الأرض فخسفتها، وأحدثت فيها هذه الحفرة التي لا يعرف أحد قرارها، لهذا سُميّت المنطقة بـ "الحفرة" أو "الجورة". ولمّا أرادت القوافل المتجهة شمالاً من سيناء، التزوّد بالماء، كانت تُعرّج على هذه الحفرة التي قيل إنها ظلت تفيض بمائها حتى سنوات قريبة . لهذا السبب -قال الشيوخ-: أقامت الدولة العثمانية مركزاً إلى جانبها كنقطة حراسة، سُمّيت بـ"مركز الحفرة" أو "الجورة"، بل إن شيخاً يافعاً أضاف: "إن ماء الحفرة قد غار في الأرض منذ أن أُقيم أول مركز للجندرمة في هذه المنطقة!
وعندما جاءت بريطانيا، تسلّمت المركز والحفرة، فأطلقت على المركز اسم (عوجا حفير) وجعلت الحفرة مكبّاً للنفايات ومصبّاً لشبكة المجاري، بل مدفناً سريعاً وسهلاً لكثير من الجنود البدو الذين رفضوا أوامر الضباط البريطانيين، أو الذين جُرحوا في الحرب من ابناء العرب والأقليات والهنود!.
ولمّا وقعت الدولة العبرية على هذه الأرض، يُقال بأنها ألقت بجثث الأسرى المصريين في قاع هذه الحفرة، وأبقتها، طبعاً، مكبّاً للنفايات ومصبّاً للمجاري.
ويبدو أن الأفعى التي يتحدثون عنها، وجدت ما تأكله طيلة سنيّ "العُسمليّين" والانتداب والاحتلال اليهودي، غير أن اليهود، رأوا، ربما، الأفعى فابتعدوا قليلاً وبنوا السجن الذي أسموه "السجن السابع"، وضربوا سياجاً حول الحفرة، لكنّ عدداً من الجنود اليهود اختفت آثارهم، ولم يجد ضُبّاطهم تفسيراً لغياب جنودهم الغامض، سوى أن الصحراء ابتلعتهم، رغم أنهم يدركون أن قوّة غامضة اختطفتهم وابتلعتهم، وربما يكون هذا من فعل الأفعى، لكن الضباط تطامنوا فيما بينهم، ولم يذكروها بسوء.
كان أحد المعتقلين قد ازدحم الماء بجسمه، فاستيقظ منتصف الليل، وتوجّه إلى وحدة المراحيض الواقعة خلف الخيام أقصى ساحة القسم، لكنّه، فجأة، توقّف وأُغمي عليه، ولمّا تنبّه شاويش القسم لما وقع له، حمله إلى خيمته ورشّ على وجهه الماء، وخضّ بكفه خدّه غير مرّة، لكنّ الشاب، وقبل أن يستيقظ، تماماً، كان يهرف بكلمات تردّد فيها قول: الأفعى ... الأفعى.
بعد قليل لم يصدّقه أحد!! قال، وألحف، وأقسم، وأغلظ، أنه رأى أفعى طولها أكثر من عشرين متراً وارتفاعها يطاول علو السياج!
كان الصيف قائظاً ونسائم ليله تهمس بخجل، تحمل بعض الصبا، فينتعش النائمون الذين تمدّدوا على "بروشهم" دون غطاء، لكنهم استيقظوا واحداً تلو الآخر، على صوت جاءهم من بعيد، لكنه موحش وغريب، ويبدو كأنه يفحّ من تحت رؤوسهم.
اعتدلوا في جلساتهم، وظلّوا ساهمين، والصوت يتجاوب مع صداه... وبقوا على هذه الحال حتى انقطع الصوت واختفى!
ما هذا الصوت؟ قال بعضهم: هذا صوت نحيب قلب الأرض التي تنذرنا ببركان قريب.
وقال البعض: هو صوت طير خرافي جاء ينشر ريحاً جديدة، ستغطي الصحراء وتحرقها من جديد .
وقال البعض: هذا صوت آلات وماكينات اخترعها الاحتلال الإسرائيلي ليُرهبنا ويقضّ مضاجعنا ويخيفنا.. فلا تقلقوا ...
وقال البعض: هذا صوت أفعى عمرها ألف عام، مُغطّاة بالريش كما الطاووس، ولها قرنان كالتيس البريّ، مثلما لها في كل فصل رجلٌ أو دابّة تبلعها دفعة واحدة، وتخلع ثوبها مرّة كل عام. تسكن هذه الأفعى مغائر البرق والصواعق وتلد مع الرعد. منذورة إلى يوم الدين، لتكون نموذجاً لأفاعي يوم الحساب. لا تأكل إلاّ قاتلاً أو قاطع طريق، وتنتحب كلما بكت أرملة أو جاع يتيم، دمعها صناديق الذهب المخبّأة في خواصر الآبار والمغائر والجبال، وغضبها وباء البلاد الذي لا يُبقي ولا يذر. تموت إذا ما استتب العدل في المعمورة، وتدفن عظامها حتى لا توخز ناقة تحمل حنّاء عروس . تتقن كل لغات الأرض فهي صنو الملك النبي، ولديها عِلمُ الجان الذين حبسهم سليمان في قوارير النحاس والزجاج، دخاناً في قيعان المحيطات. لديها مرونة التحوّل إلى عروس أو رجل أو عجوز أو فرس أو ما شاءت، لهذا تتحوّل إلى امرأة تطرق باب الأيتام لتحضنهم وتمسح رؤوسهم بريش يديها وتحمل لهم الطعام. وتقف حارسة للشيخ الذي قتلوا أبناءه، وتوقد له الحطب وتحدّثه عن صبر الرجال . وتقف فرساً تحمحم بين يدي الفارس الذي اغتصبوا أهله وقافلته.
تنسرب مثل الحلم إلى عينيّ التاجر الأمين، فتحذّره من السطو القادم، أو الحريق المعدّ، وتهمس في أذن العروس فتعلّمها لغة الريحان وطاعة الجسد .
تصعد إلى السماء الدنيا، فتحمل غيمة مكتنزة وتبعثها مطراً يطفئ نار الاعتداء . أو تنخرط مثل اللولب دوّامة في وجه قافلة العبيد أو النخّاسين . ترقص على دفوف البيادر وليلة ميلاد هلال العيد، وتبكي إذا احترق قلب والد، أو انشلخ عقد الدار.
الآن يعلم المعتقلون مصدر النحيب الغرائبي الذي أحاط بالأقسام ليلة سقوط الشهيدين في "أنصار 3" . واليوم يدركون سرّ قدوم الغيمات التي أنزلت ماءها في عزّ صيف الصحراء فابتلّ رمل الطرقات، وطابت هذه المعمورة الصغيرة لقاطنيها . ولهم أن يعرفوا مَنْ الذي كان يفرد ريشه في السماء البعيدة، فيظلّل الأسرى، ويردّ شأفة الشمس الوهّاجة عنهم .
وجاءت الساعة التي تكشف عن وجه ذاك الذي كان يعبئ براميل الماء الفارغة، والمعتقلون نيام، أو الذي كان يمسح عرق الحُمّى وقطرات الوجع عن جبين المرضى، أو الذي كان يجمع الملابس (الغيارات) المُتّسخة من كل الخيام فيغسلها .. ويطويها نظيفة عند رؤوسهم.
كُلّما توجّه إلى وحدة المراحيض، يتوجّس خيفةً من أنْ يقع! وعلى ما يبدو، فإن الحرص الزائد يؤدي إلى نتيجة معاكسة. فما أن مغصه بطنه، وتلوّت أمعاؤه، حتى فتح باب الخيمة، ودلف إلى صندوق الزنك الكبير، ونسي أن يغلق باب المرحاض وراءه... وجلس ينتع ويشدّ على ليف بطنه، ثم انتبه إلى أن الباب مشرع، فحاول، وهو مقرفص، أن يردّه بيده...
في المرحاض المجاور كان معتقلٌ آخر يقضي حاجته، سمع ارتطاماً وبقبقبة وتهويشاً وصراخاً مكتوماً، فاعتقد أن زميلاً له وقع في الجورة، فقطع جلسته، وخرج مفزوعاً يخبر المعتقلين عمّا سمعه!!
وما هي إلاّ ثوان، حتى كان كل معتقلي القسم يحيطون بالمراحيض، لكنهم لم يروا شيئاً، وبدا سطح الماء، الطافح بالوسخ والغائط والورق الذائب المتفسخ، ساكناً! كان لا بُدّ من أن ينظر مسؤول كل خيمة فيحصي عناصر خيمته، ويعدّهم فرداً فرداً ... والمفاجأة كانت أن أبا ضحى السوداني غير موجود؟!
- إذاً، أبو الضحى هو الذي سقط في الجورة؟!
قالوا: انظروا بُرْشه لعله نائم...
- بُرْشه فاضٍ ...
ماذا سنفعل، قال شاويش القسم؟؟!
لاحظ الجنود أن ثمة جلبة حدثت في القسم، فتوجه الضابط المناوب وسأل الشاويش عن الأمر؟ لكن الشاويش، وبعد أن أمر المعتقلين بالدخول إلى الخيام، أخبر الضابط الإسرائيلي أن شاباً مريضاً بالإسهال هو سبب هذه الضجّة، لكنه تحسّنّ!
ذهب الضابط، ودخل المعتقلون إلى خيامهم، مع الثانية بعد منتصف الليل!
بعد ساعة أو يزيد، خرجت لجنة القسم بقرار نهائي، مفاده: أن يتم إبلاغ إدارة السجن بسقوط أبي ضحى في الجورة، ويتم فرز ثلاثة من الشبان، لتقديم شهادة (إفادة) إلى إدارة السجن، تؤكد أنهم شهود على سقوط أبي ضحى، وهو يقضي حاجته، وعلى شاويش القسم أن يبلغ الضابط الإسرائيلي المناوب بذلك، قبل أن يتم إجراء "العدد" الصباحي بعشر دقائق.
خرج شاويش القسم وأعضاء اللجنة، وتوجهوا إلى المراحيض التي انقطع زائروها، لعلهم يروا جثة أبي ضحى، أو أي أثر يدلّ عليه ... فعادوا أدراجهم، إلى الخيمة، ثانيةً، ليجدوا النقاش المحتدم بين المعتقلين على حاله ...
- يجب أن ننقذه، وبالإمكان أن نربط أحدنا بحبلٍ نصنعه من قمصاننا، وندلّي شخصاً منّا ليبحث عنه، ويخرجه...
- هذا مستحيل، لأنه انتحار .. ولا فائدة من إخراجه بعد ساعتين، لأنه مات وشبع موتاً... ولو أردتم إنقاذه، لفعلتم ذلك فوراً.
- يا إخوان! لو مات أبو ضحى لطاشت جثته ... وإن عدم ارتفاعها دليل على أنه حيّ...
- حيّ؟ ماذا تقول؟ هل جننت؟ فهو إنْ لم يمُت غرقاً، فقد مات من الرائحة والقرف..
- فكّروا كيف سنغسل جثته، ونكفّنه، ونضمن أن توصله إدارة السجن إلى أهله، شهيداً معزّزاً مُكرّماً ... واقترح أن نفتح باب العزاء منذ الصباح، ولمدة ثلاثة أيام!
- يجب أن نضرب عن المراحيض، كما نضرب عن الطعام، حتى يتم تحسين وضع المراحيض، ونتجنّب سقوط آخرين.. أية ميتة لقيتها يا مسكين.. يا أبا ضحى؟؟ الله يرحمك!
- هناك ثلاثة معتقلين من دير السودان، وواحد منهم هو قريب أبي ضحى، في القسم الثاني، يجب إبلاغهم بالأمر ... وتقديم العزاء لهم ...
- يجب، أولاً، أن نحقّق مع الشاب الذي أبلغ عن سقوط أبي ضحى في الجورة، لنتبيّن علاقته بالأمر، ونسأل من أين هو، وهل ثمّة عداوة بينه وبين أبي ضحى...؟!
- يا جماعة! صلّوا على النبي .. الصباح رباح، اذهبوا لأبراشكم وناموا... وغداً، لكل حادث حديث.
ربما نام بعضهم أو كاد ... ومع الخيط الأوّل من الفجر، دخل شاويش القسم إلى الخيمة الأولى لإيقاظ الطبّاخين، الذين يجب أن يتوجهوا إلى مطبخ المعتقل لإعداد وجبة الفطور، قبل "العدد" بساعتين.. ومن ثم توجّه إلى الخيمة الثانية لإيقاظ رئيس لجنة القسم، الذي ذهب إلى خيمته ولم يعدّ، فوجده ممدّداً بحذائه على البرش، دون غطاء ... لكزه بقدمه، ونادى عليه ... وفجأة دخل شاب، وأخبر الشاويش أن أبا ضحى نائم في برشه!!؟
تحلّق المعتقلون حول أبي ضحى ينظرون إليه ويتفحصونه، كأنهم يرونه لأوّل مرّة، وهو مبتسم، يؤكد لهم أنه لم يبارح بُرْشه، وكان نائماً... ولم يسمع شيئاً، ولم يذهب إلى المراحيض!!!
انفضّ المعتقلون، وانفردت أساريرهم، وظنّوا أن كابوساً جماعياً أصابهم، أو أنهم كانوا مسرنمين...
اختلطت ظنونهم، وقلّبوا شفاههم .... ولم يجدوا بُدّاً من تصديق ما قاله الرجل عن نفسه!
- في الأمر ريبة!؟ قال شاويش القسم لنفسه، ثم سأل أبا ضحى: أين كنت الليلة؟
أجاب: في خيمتي وعلى بُرشي...
- لم تكن في خيمتك، ولا في بُرشك! بل إن رائحتك تضجّ بالبارفان، وها هي ذقنك ناعمة، كأنك خارج من حمّام تركي، وملابسك نظيفة ومكويّة ... ألا تريد إخباري يا أبا ضحى، أم أنك تعتقد أنني غبي؟؟!
ابتسم أبو ضحى، وشدّ على يدّ الشاويش، وأكّد له أنه سيخبره بكل شيء، بعد الإفطار.
جاءتني، كالعادة، بعد أن نام الزملاء، وقبل أن تحملني تحت جناحها، لفّتني بأوراق وردة بلون الأرجوان المخملي، وأخذتني ... وشعرت أنها غطست في بحر، ثم مررنا بسراديب طويلة معتمة، لنُطلّ، بعدها، على مدينة منطفئة ساكنة، كأن أهلها عميان نيام أو أموات. مدينة، لا ترى في أفقها إلا نتوءات قباب، وشبه مآذن خرساء مهجورة. شاسعة، حتى لا ترى آخرها، كانت سطوحها كابية كالمرآة المهترئة، باردة، لا غيمة تعلوها ولا غراب. شوارعها مهجورة، والصمت المُفزع يعوي أمام حوانيتها المقفلة. لا شجر يتمايل فيها ولا ماء. يضيء غَبشَها قمرٌ رمادي كئيب. مدينة موحشة، كأنّها بُنيت تحت سقف مغارة خرافية، وكأنّ سقف المغارة قد طار، فظلّت مُحاطة بجدرانها المسكونة بالعظائيات والعشب المتشابك الهائش. وفي جحور تلك الجدران الجبلية، تتقافز السناجب والعرسات والجرذان والخفافيش المعتمة.
قالت لي: هذه المدينة يسكنها مصّاصو الدماء الذين يجرّون ملابسهم السوداء الطويلة خلفهم، كأنهم يكنسون الشوارع بها، في الليل البهيم ... ويقفون خلف الأبواب الصامتة، لينقضّوا على مَنْ تحمله الريح إليهم، أو الذين يتدحرجون ويسقطون، من أعالي الجبل. لأنفاسهم النتنة رائحة الموت، ولأنيابهم الحادّة صعقته المُهلكة. - وأين سكّان هذه المدينة؟
قالت: هم سُكّانها
- لِمَ لا تُخلّصي المدينة منهم؟
قالت: أنتم الذين يجب أن يخلّص المدينة منهم..
- كيف؟
قالت: بأن لا تغيب الشمس.
- لكنها تغيب ..
قالت: أشعلوا شمساً من دمكم وأبدانكم ..
وتجاوزنا المدينة ... وحطّت بي، في غرفتي ... وقبل أن تزيح الشمسُ لحافَ البحر عنها ... عادت بي إلى خيمتي.
وما أنْ أنهى أبو ضحى كلامه، ونظر إلى شاويش القسم، حتى وجده ذاهباً في نومه!
وأبو ضحى شابٌ اعتقلته سلطات الاحتلال صبيحة يوم عرسه، وفي القسم، بدأ أبو ضحى الاختفاء ساعات طويلة، لا يراه أحد، لكنه يظهر، كاملاً، وينبع من بين المعتقلين، ساعة "العدد" فلا يجرؤ أحد على سؤاله أين كان، حتى لا يسخر منه ومن سؤاله، إذ كيف له أن يختفي وأين..؟؟
لكن أبا ضحى يختفي فجأة مثلما يظهر فجأة! والأكثر غرابة أنه ظلّ بعافيته، لا يطلب طعاماً، بل يوزّع حصته على زملاء خيمته، ومعها بعض السجائر الفاخرة ..
- منْ أين هذه السجائر يا أبا ضحى؟
يبتسم أبو ضحى ولا يجيب!
- هل أنت صائم، لماذا لا تأكل معنا، ألا تجوع؟
يبتسم أبو ضحى ولا يجيب!
- أين حلقت ذقنك، وتطيّبت بهذا العطر، من أين؟
يبتسم أبو ضحى ولا يجيب .
وعندما يتسلل السائلون إلى الخيمة التي ينام فيها أبو ضحى، يرون، كالحلم، أن بُرْشه دون جسد، وفجأة يرون أبا ضحى بكامل سخونته يتقلّب على فراشه يقظاً!!؟
حار مسؤولو القسم في أمر اختفاء أبي ضحى، وفي مسائل نظافة ملابسه وعطره الفوّاح وسجائره الفاخرة .
رصدوه خطوة بخطوة، وعيونهم على بوابة القسم التي تظل مغلقة بالمفاتيح الكبيرة والجنازير .. لكنه يختفي، كيف، وأين، وماذا؟؟
ذات مساء اجتمعت لجنة القسم في خيمة أبي ضحى، واتخذت زاويةً للحديث معه، لسؤاله عن اختفائه المؤكد الغريب المبهم .
ابتسم أبو ضحى، وقال لهم بصوت هادئ: لن تصدّقوا إن قلتُ لكم!
- سنصدّقك، قُلْ ولا تخف، وسنتفهّم ظروفك، احكِ لنا بالتفصيل، ولن نقول لأحد شيئاً .. كُنْ مطمئناً .
كانوا يُهيّئون له لكي يعترف، كأنه مشبوه!! وهم على ثقة بأن أبا ضحى أكثرهم صلابة وعطاء ووطنية، لكنّ الفضول يقتلهم وينهرهم ليعرفوا السرّ.
كرّر أبو ضحى قوله لهم: لن تصدّقوا روايتي . والأفضل أن تثقوا بأن كل شيء على ما يرام . ولا حاجة لأن تقلقوا .. لكنهم ألحفوا في الطلب، واصروا عليه وألحّوا..
- لي أخت تحملني، متى شئت، وكلما اشتهى قلبي الذهاب إلى ما أريد .. تحملني تحت ثوبها، وتحطّني، في لحظة، حيثما حلمت . ثم تعيدني برمشة عين، حيث كنت.
تلعثم أعضاء لجنة القسم، ونظروا بعضهم إلى بعض، مستغربين مندهشين، لا يعرفون، هل يصدقونه أم يطبقون بأيديهم على رقبته ..
أدرك أبو ضحى هول مفاجأته لهم، فراح يشرح لهم الأمر بشيء من التفصيل، وبداية علاقته بتلك "الأخت" التي تلفّ به الكرة الأرضية، قبل أن يرتدّ جفن إلى جفن.
كان أبو ضحى نائماً، ولمّا أحسّ بأن يداً تمسّد جبينه ووجهه برفق، غير مرّة، فتح عينيه، فوجد زوجته ممددة إلى جانبه، تبعث غمّازتاها ابتسامة الرضى .. ولمّا اكتملت يقظته، وعلم أنه في السجن .. هزّ رأسه كأنه يطرد حُلماً غطّى عينيه! ثم جال بنظره في أرجاء الخيمة فلم ير سوى المعتقلين النيام المتقلّبين..
استعاذ بالله من الشيطان، وعاد إلى نومه .. وقبل أن يغفو تماماً جاءه صوتها، بأنها تنتظره وتطلبه، فما عليه إلاّ أن يدير ظهره ليجدها بين ذراعيه بكامل نبيذها!
أدرك أبو ضحى جيداً، أن هذا الصوت لم يكن قادماً من رؤية أو حلم، بل إنه صوت من لحم ودم .. ومما زاد من خوفه أن يدير ظهره فيجد عروسه، بالفعل، إلى جانبه، وفي حضنه!!
لكن أبا ضحى رجل شجاع، ولا يخشى المفاجآت، وقرر أن يفعلها، فأدار وجهه، فأحسّ بدوار خفيف، ثم توازَنَ وفتح عينيه على مصراعيهما، فوجد نفسه في سرير غرفة بيته!!؟
نهض عن السرير، وترجّل، وراح يلمس أُكُرة الباب، فوجدها حقيقية، ثم توجه إلى النافذة، وفتحها، فهبّ ريح الطوابين من أرجاء "دير السودان" وقرى مزارع النوباني وعارورة وعجّول.. وها هو الجبل الذي يحمل قرية أم صفا ..؟!
نظر إلى عروسه، وغرق في لثمة الحياة .. وما أن انتهى وحاول أن ينهض، حتى وجد نفسه على بُرشه في الخيمة رقم 26 وفي القسم 3.
في الليلة الثانية، استيقظ على اليد التي تمرّر فروها على جبينه، مرّة أخرى . كان أقل خوفاً ودهشة، فتح عينيه فوجد عروساً بكامل خلاخيلها وكحلها المرسوم . اعتدل في جلسته، وابتسم لها كأنه يطمْئِن نفسه، ويشكرها على رحلة ليلة أمس . لكنها أشارت له أن يتبعها.
نهض أبو ضحى، وفتح باب الخيمة، فوجد نفسه محمولاً، دون أن يعي، وبعد أقل من لحظة، رأى حاله يقف أمام تلك العروس التي اقتعدت حجراً أملس عند حافة بئر كأنها حفرة عظيمة معتمة.
- مَنْ أنتِ، وأين نحن، وماذا تريدين مني؟
ابتسمت له العروس ..
توقف أبو ضحى عن الكلام المباح، وقال لأعضاء لجنة القسم .. هذه هي القصّة، ولن أزيد!
أما مَنْ سيتفوّه بحرف واحد منكم عن حكايتي هذه، فأنا لستُ مسؤولاً عمّا سيقع له! إنّي أحذركم، وقد أعذر مَنْ أنذر.
انسلت لجنة القسم، وهم ينتفضون رهبةً وخوفاً ..
في اليوم الثاني، طلبت اللجنة من أبي ضحى أن يتم توظيف هذه "الأخت" لخدمة أهداف المعتقل ..
وعد أبو ضحى أن يطرح الأمر على "أخته" التي لم تحضر ليلة أمس أو اليوم . وفي المساء، جاءت "الشحرورة" تُنادي على رقم أبي ضحى ضمن أرقام المعتقلين المُفرج عنهم.
وقبل أن يخرج أبو ضحى من بوابة القسم، سأله رئيس اللجنة: كيف سنتصل بـ "الأخت"؟
ابتسم أبو ضحى، وهمس له قائلاً: كانت أحلام يقظة رائعة يا صديقي.
في الأزمات، يكتشف الإنسان كنوزه المدفونة فيه! ويدرك، ربما، بعد فوات الأوان، أن أشياء كثيرة سقطت منه، وهو غير آبه لها، وأن هذه القطرات، هي نسغ حيويته، وماء روحه .. وما عليه إلاّ أن يلملم نفسه من جديد، ليندفع في دفاعه عن سماوات جسده وأرض قدميه. لهذا، وبعد حين من الصراع والمساجلة والمغالبة مع العدو الذي يسعى لإلغائه تماماً، يكتشف أن فيه من القوة، ما يفوق خياله، وأن فيه قدرة احتمال تعزّ على الجبال، وأن شرايينه تتسع لكل الغابات.
إن الإنسان أقوى مما يعتقد، وإنه لم يوظف أكثر من عشرين بالمئة من إمكانات وقدرات روحه وجسده وعقله، وإن فيه من الجبروت والغرابة وغير العادي ما يفهق أمامه مثل النيزك، إذا ما تعرّض للإنهاء أو الإفناء.
ولعل السجن، بكل ما يمثله من نظرية للتغريب والكسر والاحتواء، هو ما يستفزّ كوامن الإنسان الذي يبدأ الردّ، حتى يُشكّل نظرية مضادة، هي نظرية التحدّي والبقاء... وفي طريق تأصيل هذه النظرية، تنكشف جواهر البشر غير المرئية فيهم، ولآلئ الاختراق والخوارق المُغطاة تحت قشرة الرتابة ونمط الحياة.
وإلاّ، فكيف يمكن أن نفهم تحمُّل السجين آلام الجوع مدة تزيد على الشهر؟ أو البقاء يقظاً، دون أن يغمض له جفن مدة خمسة أيام متواصلة؟ أو استيعاب ضربات العصيّ والهراوات مدة خمس ساعات، دون أن تنكسر فيه إصبع؟ أو أن يهجم على الجنديّ الذي يسدّد فوهة بندقيته نحو صدره .. ولا يتردد في الانقضاض عليه .. أو تقطيع الأسلاك الشائكة بالأيدي المجرّدة!
لا أبالغ، لأنّ مَنْ يمكث عامين أو أكثر، في زنزانة عزل انفرادي، لا يرى أحداً ولا يكلّمه أحد، ويخرج عاقلاً معافى، وبكامل توازنه ووعيه، ليس آدمياً عادياً، لكنه، وفي كل هذه الأحوال وما شابهها، يظلّ إنساناً فلسطينياً طبيعياً، ومن الممكن أن يكون فيتنامياً طبيعياً، أوجزائرياً طبيعياً، أوجنوب إفريقي، أو برازيلياً طبيعياً.
هل تصدقون أن معتقلاً فلسطينياً، كان سيتمّ نقله إلى سجن آخر، وهو مضطر لحمل رسالة مهمة، قرأها مرة واحدة فحفظها كاملة عن ظهر قلب، دون أن ينقص منها حرف؟!
وأن معتقلاً آخر، تم نقله إلى مستشفى السجن، لإجراء عملية "الزائدة" له، قطع عضوه التناسلي بشفرة حلاقة، عندما خشي من أن تغريه مُجنّدة إسرئيلية، وتسقطه في شباكها؟!
هل تريدون أسماء هؤلاء، غير العاديين، حسناً! إن أسماءهم معلومة لدى كل مَنْ دخل معتقلاً من معتقلات الاحتلال!
عندما اعتقلوني للمرة الثالثة، وحملوني إلى مركز اعتقال الظاهرية، مرة أخرى، ومكثنا في جحيمه أسبوعين تقريباً، أخرجونا إلى ساحة المركز، وكالعادة، ربطوا كل اثنين من المعتقلين بكلبشة واحدة، يومها تقاسمت مع الأخ المناضل راضي الجرّاعي شرف الارتباط بقيد واحد .. وقبل أن نصل، بعد عشرين ساعة، إلى قسم "5" في "أنصار 3"، وقبل أن تحرمنا إدارة المعتقل من الأخ راضي؛ بإعادته إلى مركز التحقيق في مدينة "ملبّس" الإسرائيلية "بيتاح تكفا".
كُنّا نقف في طابور ثنائي، في ساحة مركز الظاهرية، في انتظار الإجراءات وتعصيب العيون وركوب الحافلة، وعندها جاء ضابط إسرائيلي، وأشار إلى أحد المعتقلين، بعدها حمل جندي يهودي قضيباً حديدياً غليظاً، ووقف على صندوق خلف المعتقل المُشار إليه، وهوى بكل قوته وحقده على رأسه .. فوقع السجين، وأسقط معه الشاب الذي كان مربوطاً وإياه بالكلبشة.. وبعد دقائق استيقظ "المضروب على رأسه"، ووقف بكامل وعيه كأنما سقط على رأسه عامود ماء . عندها همس لي راضي الجراعي قائلاً: يبدو أن هذا المضروب خليلي! فرأسه يابسة، ولن تتأثر ولو ضربوه بقنبلة نووية.
أما أنت يا راضي، فكيف رأسك الآن، بعد كل هذه السنوات من السجن والمسؤولية! هل أحالت الليالي شَعرك إلى فضّة من نهار... يا أبا شادي! طوبى لك في كل أحوالك أيها الرجل الباسل.
وفي معتقل المسكوبية، الواقع على ضفة شارع يافا في القدس الغربية، حجزتني المخابرات الإسرائيلية يومين، قبل أن ترسلني في "البوسطة" سيارة نقل المعتقلين، إلى مركز التحقيق في طولكرم... والمسكوبية مركز توقيف حقير وخشن ودموي، وكان قد سبقني إليه أخي وصديقي د. سمير شحادة، وكان حينها في زنازين التحقيق في المسكوبية كما علمت لاحقاً... وأدخلوني إلى إحدى غرف السجن .. فاعتقد السجناء أنني د. سمير شحادة.. فأوضحت لهم أنني صديقه، وعلمت حينها أنه هناك، كما كان هناك، وفي الغرفة التي أدخلوني إليها، فتىً لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، أمضى في التحقيق المركزي، وتحت التعذيب المهول شهرين، ولم يعترف بأنه كان يعدّ "المولوتوف"... وأنه أحرق أكثر من خمس دوريات عسكرية، إلاّ أن واحداً مِمَّن لم يحتملوا التعذيب اعترف بكل شيء، ورغم ذلك فالفتى لم يعترف، وتمت محاكمته، لاحقاً، على اعترافات رفيقه!!
هل تذكر ذلك الفتى يا أبا نزار؟ ربما يقضي -حتى الآن- فترة سجنه، مع نزار في معتقل عسقلان، وربما أصابته رصاصات سوداء، في قلبه، مثلما أصابت ذلك الفتى "رامي"؛ ابن أخينا عزّت الغزاوي، الذي سقط شهيداً، تاركاً حَمام الدار دون قمح أو غناء.
وكُلّما التقيت المناضل يوسف عزريل، أو صديقاً آخر يذكّرني بأيام كتسيعوت "الجميلة"! وبما فعله شاويش قسم 4 الأخ الجسور أنور النابلسي. وقتها لم يصدق أحد ما رأى بأم عينه .. حتى سأله أحدهم: هل أنت من الأولياء، أصحاب الحظوة يا أنور؟! لكن أنور لا يزيد عن كونه مناضلاً شريفاً صلباً، مثل كل هذه الآلاف التي تفترش رمل الصحراء.
- إذاً، ما الذي جرى؟
حدث أن رمى أحد المعتقلين رسالة، بوساطة "الحمام الزاجل" من قسم2 إلى قسم4، لكن الرسالة وقعت بين أسلاك السياج "الشيك"، وكان مستحيلاً، أن يتم التقاط الرسالة - التي تحتوي على معلومات أمنية خطيرة تتعلق بإحد التنظيمات - من بين الأسلاك الشائكة، وكان لا بُدّ من إحضارها، عندها مَدّ أنور النابلسي ذراعه كاملاً بين الأسلاك، وراح يدفعها، كأنه يمددّها، حتى وصلت أصابعه إلى الرسالة، فالتقطها وسلّمها للفصيل المعني بالأمر، دون أن تنخدش ذراعه، أو ينقدّ كُمّ قميصه!!
أين أنت الآن يا أبا رامي؟ هل ما زلت تطرق بيمينك القادرة على الحديد، حتى تقوّمه، وتصنع منه بوّابات لبيوتات القدس! على ذراعيك الرضى والبركة!
وحدث أن كُنّا عائدين من زيارة المحامين، وفي طريق عودتنا إلى الأقسام، قام الجنود بتفتيشنا، تفتيشاً دقيقاً، وصل، كالعادة، إلى تحسيس ما بين أرجلنا، لكن جندياً بذيئاً حاول أن يُجبر أحد المعتقلين على الانحناء ليفتش مؤخرته، فرفض المعتقل ... فقام الجندي التعس وصفع المعتقل على وجهه . بعد ذلك لم نر إلاّ والجندي يطير في الهواء ... ويسقط في جهة، ورشاشه في جهة أخرى.. لقد وقع بين يدي مدرب كاراتيه! ولم يوقف ذلك الشاب إلاّ جديّة الجنود الذين سحبوا أقسام أسلحتهم في وجهه، إذا ما استمرّ في ضرب زميلهم، وبعد شهر ظهر ذلك المدرب الحزين، بعد أن أكلت العصيّ من جنباته، وهو مقيّد في الزنزانة ليل نهار.
في إحدى جلسات اللجنة النضالية العُليا، خلال فترة اعتقالي الثالثة عام 1989، دار نقاش ساخن حول مفهوم الوحدة الوطنية، والتمثيل النسبي، ومدى نفوذ "فتح" وسيطرتها على القرار، ومدى المركزية التي تتمتع بها قيادة حركة "فتح" داخل بناءاتها التنظيمية الفضفاضة .. وكُنّا، على ما يبدو، وقتها، لم نتعلّم ما يكفي لنكون مستمعين جيدين! حيث إن دفاعنا "العشائري" عن الحركة، هو ما دفع القوى الأخرى لتكون عشائرية، هي الأخرى! لقد كان الجميع ينتمي إلى "دين" سياسي، لا يقبل له خدش أو نقد. وبعد أن انتهت الجلسة، مضيتُ أنا وممثل الجبهة الشعبية في اللجنة، إلى رياضة المشي في الساحة .. وفجأة، وقف زميلي الرفيق فريد م.، وقال لي: سأُخبرك بشيء!
- ما هو يا فريد؟
ذهبنا، وجلسنا بعيدين عن الزملاء، وبدأ شرح السيناريو السياسي القادم ... عندها أحسست بأنه يبالغ، أو أنه مغرم بالفنتازيا والتحليل اللامعقول.
هل تدرون ما الذي قاله الرفيق فريد؟
لقد قال لي، تقريباً، كل ما جرى لاحقاً في مؤتمر مدريد، وفي أوسلو .. وأنّ الحلّ سيكون حكماً ذاتياً .. وحتى سنوات طويلة! عندها لم أصدّقه! فهل تُصدّقون الآن، أم صدق المحللون السياسيون ولو كذبوا؟
عذراً يا فريد .. لم يعد الأمر سرّاً .
يا أيُّها "الختيارُ" إنّكَ في ضلوعِ صغارِنا
الدَّفَقَ الذي يُعطي الطفولةَ نُضجَها
أنتَ الذي يُعطي الحجارةَ
في أكُفِّ صغارِنا، الوَهَج المُهابْ
وصغارُنا وكبارُنا والأُمَّهاتُ
- بزفَّةِ الشهداءِ في برقِ الصِّدامِ
وفي النِّقاشاتِ السريعةِ -
يهتفونَ لوجهِك القُدُسيّ
أَنت الرمزُ
أَنتَ نَشيدُنا العَصرِيّ...
فاحكُمْ بيننا بالعَدْل !
أنتَ مُحاصَرٌ بالنارِ والأَسوارِ
حَولكَ إِخوةٌ أعداء
أمزجةٌ وتجَّارٌ
وألسنةٌ يُنَضْنِضُ سُمُّها حولكْ
فلا تَأمنْ لَهُم ... تهلكْ
وصدِّق كلَّ مَنْ عانوا ومَن جاعوا
ومَنْ ماتوا
ومَنْ ظَلّوا، برغمِ الثلجِ، في الخندقِ
هُمو أَهلكْ
فلا تهلكْ ..
فكلُّ الناسِ، رغمَ دموعِها، خلفكْ
وكلُّ النّاسِ أضحى دَربُها دربكْ
ولم نبدأ لكي تُنهى حكايَتُنا
بهذا الصَّمتِ والليلكْ
فلنْ يَعطوكَ،مَنْ ذَبحوكَ، غَيرَ الكذْبِ
لن يأتوكَ إلاّ إنْ رأوا سَيفَكْ
وَلَن يأتوكَ إنْ ظنّوا
بأَنَّكَ سائِرٌ وَحدَكْ
وَلنْ يَعطوكَ إلاّ ما سَتأخذهُ
بساعِدِكَ الّذي يَشْتدُّ بالمعْرَكْ
وَلنْ يَعْطوكَ إلاّ ما سَتأخذهُ
بساعِدِكَ الّذي يَشْتدُّ بالمعْرَكْ ...
كثيراً ما كانت "الشحرورة" تأتي، وبيديها أوراق الإفراج، وأحياناً تكون الأوراق التي بين يديها أوراق تجديد الاعتقال الإداري ستة أشهر أُخرى .. وبهذا، فإن "الحفلة" التي كُنّا نحرص على إقامتها ليلة يوم الإفراج الموعود والمحدد تنقلب إلى جلسة تضامن مع المعتقل الذي جددّوا حجزه نصف سنة كاملة ! أما الذين يتم ذكر أرقامهم كمُفرج عنهم، على ذمّة الشحرورة، فإنهم يبدأون تسليم ملابسهم الداخلية النظيفة لصندوق التموين، وبمصافحة المعتقلين وتوديعهم ..
.. وبالتأكيد، فإن عليهم أن يحفظوا الرسائل الشفوية من المعتقلين إلى أهاليهم أو أصدقائهم، ونقل الأمانات إلى أصحابها، وغالباً ما يكون آخر المودّعين شاويش القسم، الذي يدعو الله بقوله "عُقبالنا" .. فيجيبه كامل جبيل : إن شاء الله لمّا تروّح أنت وغسان الحرامي تنفقسوا !
- ما هي الفقسة هذه يا كامل؟
يقول كامل: عندما أفرجوا عن "فلان" بعد سنة كاملة، ووصل إلى بيته، وسلّم كلُ أهل البلد عليه .. وذهب للنوم .. انفقس! كانت امرأته "جاييتها" (العادة الشهرية).. وعقبال عند المُفرج عنهم يا شباب..
يضحك الجميع، وينصفق الباب، وتلّوح الأيادي للذاهب إلى صغاره وأم عياله على جناح الحرية العزيز !
ناعم .. ناعم .. هالريحان
كُلّه ريحه .. هالريحان
قَطْفه منّو .. هالريحان
تغني عنّو .. هالريحان
يا حْليل إموّ .. هالريحان
ما في منّو .. هالريحان
.. ويكون العريس قد خرج من حَمّام العُرس، وجلس ليتزيّن، فيبدأ "الحلاق" كشط لحيته، وتسريح شعره، ودهنه بالأطايب والعطور .. وصوت الشبان حوله:
خففّ موسك يا حلاّق
إعملْ لهُ غُرّة .. يا حلاق
هكذا تبدأ حفلة زفاف المعتقل الذي يجلس بين يدي (حسام الحرامي) ليشذّب لحيته، ويهندس شَعره، ويهيئه للقاء يوم غدٍ، يوم الإفراج .
والمعتقل، حتى يخرج إلى بهاء اللقاء الموعود، عليه أن يجتاز "فقستين"؛ الأولى "فقسة" أن يتم تجديد اعتقاله ستة أشهر أخرى، وإذا تجاوز هذه، فعليه أن يجتاز "فقسة" كامل جبيل، وهي أن تكون الزوجة مستعدة! وعلى رأي كامل (مش جاييتها) وعلى رأي المثل: مَنْ حفر حفرة لأخيه وقع فيها، فقد وقع كامل "أبو أيمن" في الفقسة الثانية، بعد أن انفقس في الأولى، وها قد مرّ عام كامل على كامل وهو يحلم.. وبستاهل!
السجنُ يصقل زندَ الفُتوّة
يزرعُ معنى التجلّد في الروحِ
يخلقُ روحَ الجماعةِ في الفردِ
يسكبُ فولاذَ صبرِ الرجال بقلبِ الجزوعِ
ويصهرُ صلصال آدمَ فينا
لنغدو شلاّلَ نورٍ ونار .
والقيدُ في السجنِ لا يغلبُ السجناءَ
إذا لم يصل للجنان
وأخطرُ ما في السجونِ
انتقالُ ظلام الزمان المملّ لعقلِ السجين
ويومُ السجين انتظارٌ ثقيلٌ لأي انبلاج
وكلُ سجينٍ يقولب ساعاته لانتظارِ الخلاص
ويرغبُ في أن يلوكَ الجرائدَ بحثاً عن الضوءِ
يقرأُ .. يلعبُ بالزهرِ...
وحين يخطّ الرسائلَ للأهل
يُذهلُه أي شيءٍ أليفٍ
ينتظرُ المعجزاتِ التي ستخلّصهُ فجأةً
من رمادِ القيودِ
يُجمّلُ أحزانَه بانفعالٍ
ويغضبُ من أيّ أمرٍ صغيرٍ
ويسعى لكسرِ النواميس بعضَ الأحايين
يبكي بصمتٍ
ويضحكُ من أيّ شيءٍ سخيفٍ
وتُغريهِ بعضُ الأحاديثِ والنكتِ الشبقيّةِ
يعشقُ لون الهدوء المعذّب
في أُغنياتِ الأصيل
ويلعنُ نوعَ الطعامِ المُكرّر
يغضبُ من قلّةِ الأكلِ والّلبسِ
يرمي بجثتِهِ للرّصاص
إذا مسّهُ الذلّ مسّاً طفيفاً
ويجهرُ بالانتماءِ اذا ما أحسّ بريحِ التَعدّي
ويحتجّ إن غابَ مشط التساوي
ويحترمُ الشيبَ والسنواتِ التي قدّها الظُلْمُ
من جسدِ الصامدينَ
ويكرهُ إهمالَ هذا وذاك
يريدُ حياةَ المِئاتِ
كما يشتهي أن تكونَ الحياة
ويهتمّ كي يعرف السرّ في الحركات
أو الجلسات
ويُسعده أن يقوم ببعض المهمّات للسجناءِ
ويكرهُ غسلَ ملابسِهِ والأوامرَ
يختلقُ العُذرَ إنْ شتمَ الآخرين
ويُسْقِطُ فِعْلَته فوقَ وجهِ الزمان
ويأملُ أن تتحقق بعضُ الإشاعاتِ
حين تكونُ على صِلةٍ بالرواح
ويبحثُ عن ذاته في العلاقاتِ
والشللِ المُنتقاة
وكلّ السجونِ يُوحدّها أملٌ لا يجفّ
ويجمعُها الخوفُ والانتماءُ
وصمتُ التوتر والرعب
والجوع والارتقابْ .
وليلُ السجينِ حديثٌ يطول عن الانتفاضةِ
والبيتِ
والعشقِ
والسجنِ
والخبزِ
وشوشةٌ مع صديقٍ
تفاصيلُ حادثةٍ قد جرت عن قريبٍ
حكايا عن الجامعاتِ وبعضِ الرّجالِ
عن البلدِ الذي ينتمون إليهِ
وكيف تبدّل
كيف يريدونهُ أن يكونْ
عن الاجتماع أو الاقتصادِ
عن الشِعرِ والساسةِ الخارقين
عن الحلّ والرّبط
والرفضِ والموتِ
والعيدِ ...
وليلُ السجينِ إعادةُ ترتيبِ كلّ الدقائق
إخضاعُ ما قد مضى للسؤالِ
ارتخاءٌ
دعاءٌ
هدوءٌ
ورحلةُ فكرٍ عميقٍ
ورسمُ حدود الزمان الذي
سوف يتلو الخروج من السجنِ
أحلامُ صَحْو تعوّضُ ما قد تطايرَ منّا
وما ينقصُ الكف والقلب والعين
ذكرى تشعّ بقنديلها الأرجواني
رحلةُ موتٍ شهيّ
وكلُ السجونِ تسافرُ في الليلِ
خلفَ الجدارِ
... وتحلمُ بالصّبحِ والإنقلابْ .
يلد السَحَرةُ وقت الغروب، حتى يكونوا قادرين على تأصيل هذه الغربة! والغروب في الصحراء لوحة تتداخل فيها الوان المغيب مع بياض الغيوم الرقيقة، فتكتسب الغيوم لون الحنّاء الحزين. ودائماً، ثمة دمعة كبيرة، في السماء، تظل حتى الخيط الأخير الذاهب إلى البحر، كأنها وردة جُلنّار فقدت أُمها، وأتت لتشاركنا الأسى الطريّ .
وعلى مرمى عينيك، ترى العوسج يستعد للنوم، تحت لحاف الندى . وثمة زهرة يتيمة تذبل عند حمأة الظهيرة، لتستعيد تفتّحها! وكم تجمّعت حدقاتنا حولها، وحاولنا أن نستقدمها نحونا... لكن دونها خرط القتاد والبساطير.
وفي حضرة هذا الغروب الرسولي، وبعد يوم من سقوط الشهيدين الشوّا والسمّودي، أي يوم 17/8/1988، وقبل يوم إفراجي الأول بساعات، جلس المعتقلون، وما زال وحي المأساة يُجلّل المكان، ليشاركوا في الأمسية الشعرية التي أحياها الصديق وسيم الكردي وأنا.. وكان لا بُدّ من أن تكون القصائد، مُكملة للمشهد الدامي، ولحالة الغضب والحزن، والصمت المتوتر الذابح . وراح وسيم يقرأ قصائده، ماسكاً الأوراق بيده اليسرى، فيما كانت يده اليمنى تكسر هواء الصمت، وتعيد تشكيل الغيوم، حتى سقط العندم، وتقاطر من ذراعه! كان الصمت مدوّياً، أكاد أسمعه!! لكن وسيم، استطاع بصوته العميق المنفعل، وبحركة يده المُتّسقة مع صور الكلام الواضح، أن يكون أقوى من الصمت، وحلّ الليل برداء مصاصي الدماء السوداء، وما زالت كلمات وسيم الكردي ترمي نداءاتها، وتردد الصحراء أصداءها حتى الساعة:
قامت من الرمل البشائر
طوّفت أنسامها
رفّت أهازيجاً
زغاريداً تكابر
قامت من الوجع الضفائر
وبدت ملوّحة
مناجية حداق النبع
أجساد المعابر
واستفاقت من هضاب العمر
تستبق الهواءَ
هم فتيةٌ نهضت زنابقهم
كآلهة
تخصّب فوهات نشيدهم
وتقضّ صمتاً
قد تعلق فوق أجراس البقاء
وأنت يا سامي الكيلاني، يا شقيق الشاهد والشهيد.. كيف ستُهّرب قصائدك وقصصك القصيرة؟ وأنت يا صديقي وسيم الكردي، كيف ستحمل "جدار الدم" وباقي القصائد التي تلوّنت بالعوسج والندى والنجمة العاشقة؟ وأنت يا أخي عبد الناصر صالح، كيف ستحمل روحك المطرزّة بأرجوان الشهيدين وصراخ المذبوحين... كيف سينحني مجد القصيدة أمام هراوات التفتيش؟؟ هل ستحفظون قصائدكم عن ظهر قلب، وتعيدون كتابتها، مرّة أخرى ؟؟ أجبني يا جمال بنورة.. ويا كل الكُتّاب المحبوسين!
لا بأس. فالحاجة أم الاختراع، وثمة "الكبسولات" اللواتي سيحملن كل الآيات الذهبية، باطمئنان وأمان، وستصل كل القصائد إلى المنصّة كاملة، دون نقص أو اعتداء.
ثمة ورق شفاف، يكتب على صفحته المعتقلون قصائدهم وحكاياتهم وأخبارهم، بقلم رفيع، وبخط صغير، يشبه النمل الأسود المتراص، حيث بالإمكان كتابة خمس صفحات على ورقة شفافة بحجم كفّ اليد، ومن ثم يتم ثني الورقة وطيّها وجمعها حتى يصبح حجمها بحجم حبّة الفول، وتتّم تغطيتها غير مرّة، بالنايلون، وتذويب نايلون إضافي على جنباتها.. حتى تصبح شبه كبسولة الدواء المُغلقة، لا يخترقها الماء أو الهواء. وقبل الخروج من القسم، يقوم السجين بِبَلْع عدد من الكبسولات، مع قليل من الماء.. وعندما يصل إلى بيته.. يذهب لقضاء حاجته، فتخرج الكبسولات.. ويتم غسلها جيداً، وفتحها، وبهذا تمّ نقل وحفظ كل أدبيات وأسرار السجون!
بعد ثلاثة اعتقالات إدارية، في المعتقل نفسه، والانتقال من قسم إلى آخر، أصبح وجهي شبه مألوف للشحرورة، التي جاءت في اليوم الأخير من الأشهر الستة الأخيرة، ونادت على رقمي، ضمن المفرج عنهم!
- كان رقمي في الاعتقال الأول (3589)، وفي الاعتقال الثاني كان رقمي (6168)، وفي الاعتقال الثالث (9576)، أليست أسماء جميلة؟! -
هل أقول إنني فرحت؟ أم أقول إن الأسى حلّ فجأة في صدري، وانقبضتُ، وأصابتني كآبة غامضة !!
لم يكن "أنصار 3" يشبه "كاميلوت" إلاّ بجسارة مواطنيها، وتفانيهم الحقيقي دفاعاً عنها، لتظل المدينةُ الذهبية، حارسةً للبحر والمراعي . بل إنّ كل معتقل في "أنصار 3" كان يطاول الملك الشهيد، الذي حلم طوال عمره بالمرأة، وبرؤية مدينته ناصعة النقاء والعدل . وحتى، حين كاد يتزوج الأميرة المستنجِدة - وكان يشكّ في أنها تعشق "لانسيلوت" الليث الآدمي الذي ربتّه الغابات - لم يشأ أن يحضن جسداً، روحه فرّت منه إلى غيره، لهذا كان يقول للأميرة: تزوجي الملك، واعشقي الرجل الذي يلبسه الملك، وإلاّ فابتعدي! لكن الملوك الحقيقيين، لا يموتون إلاّ شهداء، أمام النبال وطعنات الرماح، وعيونهم شاخصة نحو شمس الشروق، التي تتطالع من العيون الدامعة.
ربما كانت أرض "كاميلوت" المُمرعة بالزهر والعسل ساحرة إلى حدّ الخوف، أما أرض "أنصار 3" الرملية، فكانت مسحوقاً بشرياً ناشفاً، قلّبته الرياح بعد أن تآكلت الأجساد، وتحلّلت إلى حبّات تذروها الأيام منذ آلاف السنين.
هنا المدينة الجهنمية الكاملة الفاضلة! "أنصار 3" الذي حقق "لتوماس مور" حلمه كاملاً على هذه الرمال، وأكاد أصرخ أن هذا المعتقل هو "جزيرة الشمس" التي تجاوزت مدينة الفارابي الفاضلة، لأن حيّ بن يقظان - الذي تشبه أيامه الأولى أيام النبي موسى عليه السلام - أخذته الغزالةُ إلى حليبها، قبل أن يكشف له البرقُ الحقيقة! مثلما تجاوزت جمهورية أفلاطون التي أبقت على التمايز الطبقي، بل كيف لها أن تكون "فاضلة" وقد أقصت الشعراء والمبدعين، على اعتبار أن "الفن" صورة مشوّهة عن واقع مشوّه أصلاً؟؟! لقد تخطى "أنصار 3" كل الأحلام التي تطلعت لإنشاء عالَم عادل ومعقول . لكن مدينتنا الكاملة "أنصار 3" تجمع بين كثبانها كل ما قاله يوليوس فوتشيك في "تحت أعواد المشانق"، وأوراق معين بسيسو الفلسطينية، وشرق عبد الرحمن منيف المتوسط، وأشعار ناظم حكمت. وتنطبق عليها، انطباق الحديد على الحديد، نفحات خريجي المعتقلات الصحراوية والرطبة من المحيط إلى الخليج، ورواية "المفاتيح تدور في الأقفال" لعلي الخليلي، ورسائل عزت الغزاوي الرائعة التي لم تصل بعد، وما قاله عدنان جابر في "القيد والحرية"، وكتاب "السجن ليس لنا" لمعتقلي سجن نفحة الذي أعدّه وحررّه عطا القيمري، و"سجينات الوطن السجين" لريموندا الطويل، وكل ما كتبه جبريل الرجوب وعبد الستار قاسم وفاضل يونس وحسن عبد الله وناهدة نزال، عن المعتقلات الاسرائيلية ..
هنا المدينة الجهنمية "الفاضلة"، و"الكاملة" "أنصار 3"، الذي حقق "العالم الجديد والشجاع" كما تصوره الدوس هكسلي بقمعهِ ووحشيتهِ وسلبهِ روحَ وإرادة الإنسان، وتحويله إلى مجرد هيكل عظمي دون أدنى مقومات.
ومن عجب أن العقلية الاستعمارية الامبريالية تشرب من نبع واحد؛ "أنصار 3"، هو ذاته عالم الدوس هكسلي، وهو ذاته جزيرة العقاب كما تصورها فرانز كافكا . العقلية الإمبريالية الاستعمارية تعتقد واهمة أنها تستطيع حمل الإنسان إلى نقطة يتخلى فيها عن روحه وإرادته وأحلامه وطموحاته .. باستعمال القوة، العزل، التعذيب، القمع، زرع اليأس في النفوس، تذويب الإحساس بالتمييز، قتل الإبداع، إنهاك الجسد من أجل إنهاك الروح .
"أنصار 3"؛
المدينة الجهنمية الفاضلة؛
آخر ما وصلت إليه عقلية فاشية عنصرية من أساليب في تنميط جزيرة عقاب صحراوية بعيدة ومنعزلة، مستفيدة من سرمدية الصحراء وأبدية الشمس، من عقاب القرّ وخناجر الحر.
"أنصار 3"؛
معسكر اعتقال، أو قل، معسكر تجميع يشبه معسكر تربلنكي أو أوشفيتس، أريد له أن يكون تقطيراً لكل معسكرات الامبرياليات السابقة، وتركيزاً لكل تجارب إجهاض الثورات والشعوب، من خلال هذا الاحتكاك اليومي بين القاتل وضحيته، بين السجان وسجينه.
مدينة جهنمية كاملة هو معسكر "أنصار 3"،
وكان علينا أن نطوّع أجسادنا أولاً، وكان علينا أن نحصّن إرادتنا، وكان علينا أن لا نرى من خلال عيوننا، وإنما من خلال هذه الأرواح التي تسكننا لتجعل من أجسادنا لا تشعر بحرٍ أو بقرّ، ولنحتمل صحراء فلسطين الجنوبية القارسة الموحشة، ولندرّب أفاعي تلك الصحراء لتخدم "التنظيم".
كان علينا أن نجعل من مدينتهم الجهنمية الكاملة، وعالمهم الجديد مجرد أضحوكة ليس إلا، وقد فعلنا .
كان الوقت عصراً، وبعد ثلاث ساعات، انفتح الباب وخرجت.. بعد عناق ودموع ووشوشات، وبلعت كبسولات ديواني الشِعري الثالث (رغوة السؤال) الذي رأى النور في كتسيعوت. وكالعادة ساقونا إلى الساحة التي تم استقبالنا فيها، سلّمنا العهدة (البنطال والقميص)، وأعادوا لنا لباسنا المدني الذي اعتقلونا ونحن متلبّسون فيه. وأعطوا كل واحد منا ورقة بالعبرية مختومة، تفيد بأن حاملها مُفرج عنه من معتقل "كتسيعوت"، تبقى معنا، حتى نذهب لاستعادة " أماناتنا" من المركز الذي اعتقلونا فيه، وحوّلونا منه إلى "كتسيعوت". والأمانات هي: الهوية الشخصية، ساعة اليد، الفلوس، الخاتم، حزام البنطلون ..
وركبنا الحافلة التي ستوصلنا إلى مفترق بلدة راهط البدوية الواقعة ما بين الخليل شرقاً وبئر السبع غرباً، وهناك، علينا أن نجد وسيلة لتوصل كل منّا إلى بلدته.
وصلنا إلى مفترق راهط منتصف تلك الليلة .. وكنّا نخشى من أن تمر سيارة عسكرية أو متطرفون إسرائيليون يرشقوننا بالرصاص .. وينتهي أمرنا . لهذا كان عِرْق الرقبة ينبض بصوت مسموع . وبعد نصف ساعة توقفت سيارة تحمل نُمرة منطقة الخليل، ركبناها، بعد أن اعتاد سائقو السيارات على التقاط المُفرج عنهم .. ونقلتنا السيارة الصغيرة، وكنّا ثلاثة، حتى دخلنا بلدة الظاهرية، وهناك نزلنا...
وأمام أحد البيوت، ظهر شاب، سأَلَنا عن أمر وقوفنا ؟! فشرحنا له الأمر، .. فما كان منه إلاّ أن عانقنا بحرارة، حتى أصابتني الريبة من مبالغته في الترحاب بنا .. لكننا تبعناه إلى بيته، ودخلنا، فأوسع لنا الجلوس، في غرفة الصالون المتواضع، وذهب إلى داخل البيت، وعاد مبتسماً مُرحِبّاً بنا .. وبعد دقائق كان البيض المقلي وطبيخ العنب والجبنة البيضاء والخبز وإبريق الشاي يُعبئ طاولة الوسط التي كانت أمامنا !
ورغم الجوع، لم نأكل، كُنّا مشغولين بالوصول إلى بيوتنا، لكنه أصرّ على أن نأكل ونشرب الشاي ونُدخّن .. حتى يحضر لنا سيارة توصلنا إلى رام الله !
تَركَنا وحدنا في بيته .. فازداد خوف واحدٍ منا، حتى كاد يهرب من البيت، لولا أننا تداركناه، وأقنعناه بأن هيئة الرجل تطمئن .. وبالفعل حضر، بعد قليل، مع رجل سمين، لم يمشط شعره، كأنه أيقظه من نومه .. وسألَنا الرجل: أين ستذهبون؟ فقلنا: إلى رام الله، فقال: تدفعون ثلاثمئة شيكل، فوافقنا، وقلت له: سنعطيك المبلغ فور وصولنا إلى البيت، إطمئن.
وقبل أن نخرج من البيت، سألت صاحبه: ما اسمك؟ فضحك، وقال: فاعل خير، الله معكم !
ركبنا سيارة الأجرة، وبدأنا نتجاذب الحديث مع السائق، وكان اسمه مصطفى، (أبا درويش) .. وسألت أبا درويش: مَنْ ذاك الرجل الذي استضافنا في بيته؟ فقال: هذا ابن محمود أبو شرخ، وهو رجل طيّب، وله أخ في سجن عسقلان.
.. وصلنا إلى مدينة الخليل، وقبل أن نخرج منها، وفي وسط الشارع المؤدي إلى بلدة حلحول شمالاً، في منطقة "رأس الجورة" أوقفنا حاجز للجيش الإسرائيلي .. لنمضي ساعة كاملة في استجواب ممضّ، وتفتيش دقيق .. وسمحوا لنا بمواصلة الطريق .. ووصلنا إلى القدس !! لقد كانت مدينة أشباح، تجوبها دوريات عسكرية خائفة، وجنود يقعقعون بأسلحتهم، كأنهم يوقظون الجنّ من حولهم، ليطردوا الرعب المحيط بهم . وعلى الساعة الثالثة صباحاً، وصلت إلى بيتي الواقع على مشارف رام الله، في منطقة ضاحية البريد، شمال القدس، وطلبت من أبي درويش والشابين المفرج عنهما معي، أن يتفضلّوا لكي أُعطي السائق أجرته، ولأقوم بواجب الضيافة!! لكن أبا درويش نظر إليّ، وقال: إذهب لعائلتك، حقّي وصلني، وسأحرص على إيصال الشباب كلاً إلى بيته في رام الله وبيتونيا، لا تقلق !
- ولكن يا أبا درويش ..
لا تكمل، قال أبو درويش، "فأنتم لستم وطنيين أكثر مني، وهذا واجبي" ..
اُكتُبْ رسالتك الجديدةَ
للصغارْ
يا ليْلكَ الأطفالِ يا نُوّار
يا نَغَمَ الهزارْ
سيجيء فجرُ الانتصارْ
وستشهدون نهاركم
والليلُ، يوماً، لن يعودْ ..
فلتشهدوا
هذا زمانُ الانتفاضة
إنّه زمنُ الصعود
ربما لن أعرف أبا درويش، إن رأيته مرّة أخرى. لكنني أراه وأرى ابن محمود أبو شرخ وآلاف الوجوه المعفرّة بالرمل والشمس، في كل الوجوه التي تطالعني أنّى ذهبت .. من عكا إلى رفح، ومن يافا إلى أريحا، ومن البيوت التي تعجن حنّاءها، الآن، تحت شبابيك الجزّارين، إلى الطرقات التي جعلت صدورها العارية سواتر، تردّ الدخلاء الذين يتراجعون، وسيتراجعون حتى يدخلوا في التيه القادم الطويل، ما داموا مرهونين لعقدة الأغيار، وحلّ المقاصل المثالي! وما دام الطفل الفلسطيني مضطراً ليحمل أمتّه العربية الإسلامية على كتفيه .. ويمضي بها إلى فضاءات القرن الجديد.