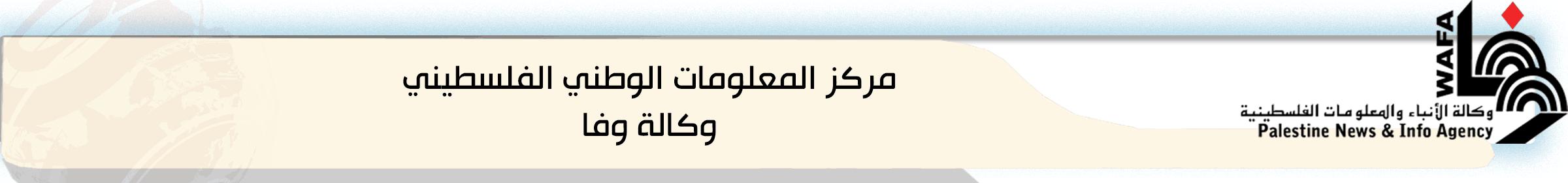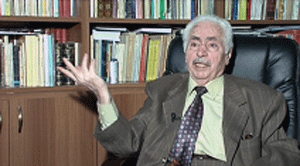
مواليد 1933 – قرية الجش قضاء صفد.
مؤلف كتاب "تاريخ جسكالا" (الجش).
أمنيتي وأنا في هذا العمر أن أرى قريتي(الجش)، وأن ادفن في مقبرتها، مقابل جبل الجرمق؛ تعبنا وتعذبنا كثيرًا؛ ولكن حين نشاهد بلادنا محررة سيزول عنا كل ذاك التعب والمعاناة. رافقنا في رحلة العذاب عام 1948 كلبنا؛ وعندما اجتزنا الحدود مع لبنان وقف ذاك الكلب على تلك الحدود، ثم أدار وجهه نحو "الجش"، وعاد مسرعا إلى القرية ولم يتجاوز الحدود مترًا واحدًا.
مستوطنة "عين زيتيم" كانت شبه معزولة عما حولها، "وعين الزيتون" كانت تقف عائقا أمام الصهاينة للدخول إلى صفد، وكانت هذه القرية مسلحة أكثر من غيرها من القرى الفلسطينية، وكان مقاتلوها أشداء يشهد لهم كل من حولهم؛ فكان لا بد من إزالة هذا العائق.
في مساء 6 أيار من عام 1948، وبينما كنا نجلس على أطراف قريتنا؛ شاهدنا غمامة سوداء تمشي على الأرض. هذه الغمامة لم تكن إلا لنساء كثيرات كنّ يتشحن بالسواد، جئن إلى "الجش" يصرخن ويبكين ويستنجدن، ويرددن عبارات تختلط فيما بينها (القتل... المجزرة... الشباب... الرجال النساء... الأطفال... الدم... الجامع... اليهود... العصابات الصهيونية... )؛ وعندما وصلوا القرية؛ سمعنا منهم تفاصيل ما حدث في قريتهم (عين الزيتون): لقد داهمت العصابات اليهودية من قوات "البالماح"، على حين غرّة، القرية، بقوة مدججة بالسلاح المتوسط والثقيل، ترافقهم الدبابات، وكان قوام قوتهم الـ 900 مجند، مدربين أفضل تدريب. وعند وصولهم ساحة القرية؛ قاموا بتجميع العشرات من شبان القرية، ثم أطلقوا عليهم النار عليهم جميعا؛ فخروا صرعى. احتمى بعض الأهالي من النساء والأطفال والشيوخ، بمسجد القرية؛ قام الصهاينة بتلغيمه ونسفه؛ فتهدم على من فيه، وأخذوا يطلقون النار بشكل عشوائي؛ فهرع الناس مذعورون إلى القرى المجاورة .
سقطت قرية عين الزيتون بعد أن ارتكب الصهاينة فيها مجزرة فظيعة راح ضحيتها العشرات من أبناء القرية. وبسقوط هذه القرية، تمهد الطريق أمام الصهاينة لاحتلال مدينة صفد.
وبالفعل؛ وبعد خمسة أيام فقط؛ في 11\أيار؛ سقطت تلك المدينة الجميلة الوادعة .
أهالي قريتنا (الجش) أدركوا معنى سقوط صفد وبعض القرى المجاورة؛ أخذوا يعدون العدة؛ لأنهم أدركوا أن الدائرة قريبا ستدور عليهم: جمعوا المال من الأهالي، وذهبوا يجوبوا القرى لشراء السلاح، ومنهم من ذهب إلى سورية من أجل ذلك. وتمكنوا من شراء بعض القطع، منها اثنتان من نوع "توميغان"؛ وأربعا أخرى لم اعد أتذكر ما نوعها؛ ولكن لم يكن هذا ليكفي حتى نواجه تلك القوات الصهيونية المدججة والمدربة، والذين يسيرون ضمن خطط عسكرية دقيقة ومحكمة.
دخل جيش الإنقاذ قريتنا (الجش) والقرى المجاورة (ميرون والصفصاف ورأس الأحمر) ، وحاول هذا الجيش بقواته المتواضعة تحرير صفد؛ لكنه فشل؛ وأقام في قريتنا الاستحكامات القوية المبنية من الاسمنت والحجارة. واختيرت منطقة "المرج" من أراضي القرية لتلك الاستحكامات، وانتشرت قوات جيش الإنقاذ في الجش والقرى الأخرى، وكان قوام تلك القوات قرابة الـ700 جندي، مدعومين بحوالي 800 مدافع من القرى الأربعة (الجش، وميرون، والرأس الأحمر، والصفصاف)؛ وبقي الحال على حاله حتى مساء 29 تشرين أول، هذا اليوم الذي كان مفصليا بالنسبة لنا وللقرى الثلاثة الأخرى؛ فبينما كنا نلعب أنا وأصدقاء لي بالقرب من المدرسة في مساء ذاك اليوم؛ جاءت من جهة الجنوب الشرقي للقرية طائرتين ومروا فوق القرية، وفوق جبل الجرمق؛ فتصدى لها جيش الإنقاذ وأطلق نحوها بعض القذائف، ولكن لم تكن لتصل لتلك الطائرات؛ بل كانت تنفجر بالجو، ولم تكن أيضا لتخيف الطيارين الصهاينة؛ حيث تابعوا التحليق في سماء القرية والمنطقة كلها.
وعلى ما يبدو، كان هدفها الاستكشاف؛ لأنه وبعد ساعات من طلعاتها؛ بدأ اليهود يقصفون القرية قصفًا شديدًا وحاولوا التقدم نحو القرية من جهة المرج؛ أي من جانب الاستحكامات العسكرية التي أقامها جيش الإنقاذ. تصدى لها المقاومون وجيش الإنقاذ ومنعوهم من التقدم؛ فارتدوا إلى "طريق ميرون- صفد"، ومنها تحولوا إلى قرية ميرون، وأخذت الدبابات الصهيونية تقصف هذه القرية، حتى شاهدنا النيران والدخان يتصاعد منها؛ وإثر ذلك هرب أهالي قرية ميرون (هذه القرية الصغيرة والمؤلف سكانها من عائلة واحدة، هي عائلة كعوش مع وجود بعض الفلاحين من خارج القرية).
لقد حرق اليهود المهاجمون قرية ميرون واحتلوها، واتجهوا بعد ذلك إلى قرية الصفصاف المجاورة. وعند الشارع الرئيسي للقرية هذه، كان ينصب مدفع أطلق منه طلقة واحدة باتجاه الدبابات المهاجمة؛ لكن القذيفة انفجرت بالمدفع ذاته. واستمر زحف الدبابات الصهيونية دون أي عائق، ثم قاموا بتطويق القرية وقصفها، ومن ثم الدخول إليها.
واستبسل جيش الإنقاذ والمدافعين عن القرية واخرجوا الصهاينة منها؛ وسقط الكثير من الشهداء دفاعا عن هذه القرية؛ ثم أعاد الصهاينة الكرة، واحتلوها مرة ثانية؛ لكن كان إصرار المدافعين أشد؛ فحرروها مرة ثانية.
أتت للصهاينة تعزيزات إضافية؛ فهاجموها للمرة الثالثة، بعد أن استبسل المدافعون، وقدموا خلال ذلك أكثر من سبعين شهيدا، ونفذت الذخيرة منهم؛ ليستسلموا بعد محاصرتهم وليساقوا إلى شوارع القرية، ولتدوسهم جنازير الدبابات اليهودية المهاجمة وهم أحياء.
بعد أن ارتكب الصهاينة مجزرة في قرية الصفصاف؛ اتجهت دباباتهم إلى قريتنا (الجش)، وكانت تبعد عنا كيلو مترا واحدا. حاولوا تطويق جيش الإنقاذ الموجود في منطقة المرج عند الاستحكامات؛ ولكن تنبه لهم أحد الرقباء، الذي استطاع أن يسحب القوة المدافعة إلى خارج المنطقة، ولولا ذلك الرقيب وتنبهه، لأبيدت هذه القوة بالكامل.
انسحبت قوات جيش الإنقاذ عن طريق الرأس الأحمر إلى الحدود اللبنانية؛ أما أهالي القرية، فهربوا أثناء ذلك.
وكانت ليلة 29 -30 تشرين أول 1948، ودخل الصهاينة القرية مطلقين نيران رشاشاتهم وقذائف دباباتهم على كل شيء في القرية، ليدمروها ويعبثوا فيها وبمنازلها وخيراتها.
خرجنا أنا وأهلي إلى قرية "بنت جبيل" ولحق بنا أبي بعد ثلاثة أيام. أقمنا في هذه القرية عند صديق لأبي مدة يومين، ثم تابعنا سيرنا إلى الشمال، ومررنا خلال ذلك بالعديد من القرى؛ حتى وصلنا إلى قرية "تبنين". تعبنا خلال ذلك تعباً شديدا، ومن شدة التعب؛ نمنا تحت شجر الزيتون، مقابل قلعة تبنين. كان عددنا بين عشرون أو ثلاثون رجلاً وامرأة وطفلًا.
في صباح اليوم التالي؛ جاء إلينا أحد قادة جيش الإنقاذ، وكان يعرف أبي؛ فسأله عن أحوالنا؛ فشرح أبي له عن ما حل بنا. ذهب الرجل وعاد بعد قليل وهو محمل بالمواد الغذائية والماء من مؤن الجيش، وقال لنا: غداً كونوا مستعدين للانتقال من هنا. وفي الصباح: جاء الضابط ومعه باصًا. ركبنا فيه، واتجهنا إلى مدينة صور اللبنانية. وهناك وفي محطة القطار؛ التقينا بالكثيرين من سكان قرى الجليل، والتي سقطت في تلك الأيام القليلة الماضية، والتي بلغ تعدادها الــــ 86 قرية.
ركبنا القطار متجهين نحو الشمال، وكان يرافقنا لجنة كانت مهمتها توزيع اللاجئين على المدن اللبنانية. وعند وصولنا مدينة صيدا؛ أنزل مجموعة؛ وفي بيروت أنزل مجموعة أخرى؛ وفي طرابلس انزل مجموعة ثالثة. أما نحن فبقينا في القطار متجهين إلى مدينة حلب السورية. وعند وصولنا هناك؛ كان في استقبالنا من سبقنا من اللاجئين، خاصة من مدينة صفد، واسكنونا في منطقة تسمى "قشلة الترك" وبقينا فيها مدة ستة أشهر، نقلونا بعدها إلى "مخيم النيرب"، وأعطوا لكل عائلة بيت صغير. واستقر بنا المقام في هذا المخيم البائس والذي ذقنا فيه شتى أنواع العذابات.
تلك المعاناة والقهر، وتلك المشاعر فجرت فيّ الشاعر خليل خلالي. لقد صقلت هذه المسيرة المليئة بالآلام إنسانا مكافحًا، سلاحه العلم والثقافة والأدب. لقد خضت في هذه الحياة معارك على أكثر من صعيد مع العلم؛ فدرست ونلت أعلى الشهادات: مع السياسة انتظمت الأحزاب وعانيت فيها ما عانيت؛ و مع الكتابة كتبت فأنجزت العديد من المؤلفات شعرا وبحثا، منها: كتاب عن قريتي بعنوان (تاريخ جسكالا - الجش) ومنها كتاب (خليل خلايلي سنديانة من أرض كنعان).
وبعد هذه المسيرة وبعد فراق قريتي منذ63 عاما؛ أقول: انه مهما طال الزمن بيننا وبين قرانا، لا بد من العودة إليها؛ ومهما طال استعمار هذه المنطقة من قبل اليهود، فإنهم زائلون، لا يمكن أن يظلوا في أرضنا؛ لقد بقي الصليبيون قرابة 200 سنة؛ ولكنهم زالوا، وأصبحوا أثرا بعد عين؛ واليهود الصهاينة اليوم لن يبقوا، صدقوني، سيأتي اليوم الذي يصبحوا فيه أحاديث الناس الغابرة. وإن هذا يتطلب منا الكثير؛ لأن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة. وأنا إذ أقول هذا، أتذكر قصة كلب لنا تعلمت الكثير من مواقفه: فأثناء هجرتنا عام 1948 كان لدينا كلب عاش عندنا أكثر من عشر سنوات. رافقنا خلال الهجرة. وحين وصلنا إلى الحدود اللبنانية؛ توقف وذاك الكلب، ولم يدس الأراضي اللبنانية. نظر إلينا، وحرك ذنبه، ثم أدار رأسه إلى الجنوب، وعاد راكضاً باتجاه القرية. وقيل لي فيما بعد أن دورية يهودية جاءت إلى بيتنا وأرادوا نسفه؛ فهاجمهم ذاك الكلب؛ فأطلقوا الرصاص عليه؛ فمات.
نصيحتي لشبابنا اليوم: لقد رأيت الحفلات التي تقام في أوروبا، ورأيت الأولاد الصغار يعيشون قراهم وتراثهم، ويتمسكون بكل ذلك مثل الكبار وأكثر. وصيتي لهم ولأبناء شعبي هنا في المخيمات وفي كل مكان: أن نظل متمسكين بحقنا بعودتنا لأرضنا لقرانا لمدننا. ولدي إيمان عميق بأن العودة آتية آتية، وقريبة جدًا إنشاء الله.
أنا وصلت إلى ما وصلت إليه من العمر، وأكثر ما أشتهيه اليوم تلك المقبرة التي دفن فيها أجدادي مقابل جبل الجرمق وكم أتمنى لو أراها وأدفن فيها.
واختم بهذين البيتين الشعريين:
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل