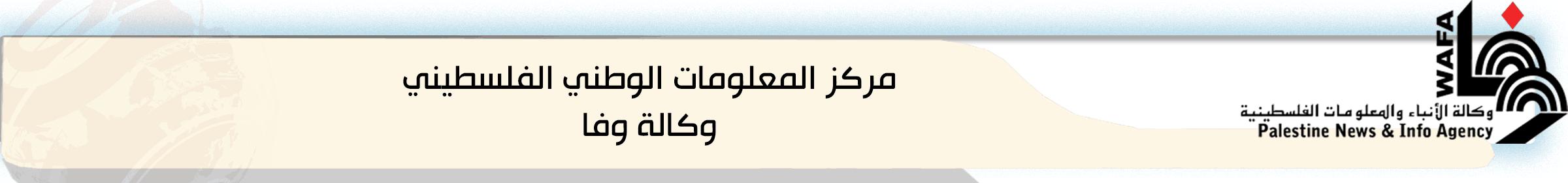أحمد الباش/ دمشق
اجزم، قرية من قرى حيفا العريقة، تبعد مسافة 25 كم إلى الجنوب منها، وتبعد عن البحر مسافة 3 كم. تحيط بها قرى: أم الزينات، وجبع، وعين غزال. وهي، كباقي قرى فلسطين، زراعية بالدرجة الأولى، تكثر فيها أشجار التين واللوز والرمّان، إضافة إلى الحبوب والخُضار. كانت بيوتها مبنية على تلال ترتفع قليلاً عن سطح البحر. بلغ عدد سكانها عام 1948 أكثر من 5000 نسمة.
يقول الشاهد الدكتور محمد توفيق البجيرمي (ابن اجزم والمولود فيها عام 1938م): كان بيتنا مؤلَّفاً من طبقة واحدة، وكنت أجلس على سطحه عند المساء؛ لأستمتع برؤية البحر. أقرب مستوطنة يهودية إلى قريتنا هي مستوطنة "زمّارين"، وتبعد عن القرية عدة كيلومترات.
تاريخ البلدة
لم تكن بيننا وبين ساكني مستوطنة زمّارين أية علاقة، ولم نختلط بهم، ولم يكن هناك أي نوع من الاتصال معهم. ومنذ عام 1936 وانطلاق الثورة العربية الكبرى في فلسطين؛ انخرط أهل القرية في الثورة، وسقط منهم الجرحى والشهداء، مثل: الشهيد توفيق مشينش. وكان الأهالي يحتضنون الثوار ويقدمون لهم المأوى والطعام، وكانوا يحمونهم من الجواسيس. وكان المحتل الإنكليزي يطلق الأحكام العالية الظالمة على أبناء القرى؛ لمجرد حيازة أحدهم سكيناً.
وأذكر، في قريتنا، أن أحداً أبناء القرية يكنى بـ"علي الزيبق" تسلل مرة إلى معسكر بريطاني، واستولى على بارودة للجيش؛ فعلموا به؛ ولكنه هرب إلى جبل شنّة؛ وجاء الإنكليز على أثرها وطوقوا القرية، وفتشوها تفتيشاً دقيقاً؛ بحثاً عن ذاك الرجل وعن تلك البارودة؛ لكنهم لم يجدوا الرجل ولا البارودة. وظل علي الزيبق متخفياً في الجبال مدة من الزمن.
سلاح الثوار والمدافعين عن القرية كان يأتي بعدة طرق، منها: على طريقة علي الزيبق (من المعسكرات الإنكليزية)؛ ومنها ما كان يُشترى من سورية ومصر؛ وكان ذلك يكلف أبناء القرية الكثير من المال؛ لأن ثمن البارودة كان مرتفعاً جداً.
وحين أحدق الخطر بقريتنا (اجزم) والقرى المجاورة لها؛ أدرك الأهالي أن لا سبيل إلا بمواجهة الصهاينة؛ فراحوا يتدربون في الجبال. وأذكر أن مسؤولية الدفاع عن القرية توزعت على الجميع، وخاصة آل جياب وآل زيدان. وأذكر أنه برز منهم حسن الجياب. وقد حفر المدافعون عن القرية الخنادق، وبنوا الاستحكامات، وخاصة فوق المدرسة التي وضعوا فوقها أكياس التراب.
وأذكر أن المدافعين عن القرية كانوا بضع عشرات من الرجال الأقوياء المدربين والمسلحين بالأسلحة الفردية وبعض الرشاشات الخفيفة؛ ورغم قلة عددهم؛ كانوا يخرجون لمؤازرة القرى المجاورة حين كانت تتعرض للهجوم من العصابات الصهيونية. ومن هذه القرى: عين حوض، التي صدّت هجوماً للصهاينة، أوقع المدافعون عنها إصابات كبيرة في صفوف الصهاينة، وغنم الثوار خلالها دبابتين.
في الأشهر الثلاثة التي أعقبت سقوط حيفا في 22 نيسان من عام 1948؛ لمع في القضاء نجم قرى ما سمي «مثلث الصمود الصغير» (قرى: جبع ،وعين غزال، واجزم)؛ وذلك لما أبلته في معركة الدفاع عن تلك القرى، ولمساندتهم للقرى المجاورة، إضافة إلى ما فرضه موقعهم الاستراتيجي على طرق الإمداد الصهيوني بين يافا وحيفا عل الطريق الساحلي.
لقد صمدت تلك القرى أكثر من ثلاثة أشهر، واستعمل الصهاينة لاحتلالها كل صنوف الأسلحة المتوافرة لديهم.
سقطت قرية "طيرة حيفا" في 17 تموز، وجاء أهلها إلى "اجزم"، واستقبلناهم واحتضناهم. وكانت تربطنا بهذه القرية علاقة أنساب وصداقات قوية. ولم تمض أيام إلا كان الهجوم الشامل على قرانا الثلاث (جبع، واجزم، وعين غزال)، اندلعت في خلاله معارك شرسة قدّم فيها أبناء تلك القرى بطولة نادرة، استنجدنا خلالها بوحدات الجيش العراقي القريبة منا؛ وكان الاتصال معهم بجري عبر جهاز اللاسلكي، الذي كنا نسميه وقتها "الوايلس"؛ وكان يأتي الرد من قائد الوحدة: «إنّا قادمون»! لكن تبين في ما بعد أن ثمة قراراً متخذاً من قبل قيادتهم بعدم التدخل؛ فالجواب بالمختصر وباللهجة العراقية: "ماكو أوامر".
ازداد الضغط على تلك القرى، وازداد معه القصف، ونفدت الذخيرة من أيدي المدافعين، ولا نجدات من الجيوش العربية، ولا من الهيئة العربية العليا؛ فاضطر بعدها المدافعون إلى الانسحاب عبر الطرق الوعرة مشياً على الأقدام متجهين إلى جنين، حيث كان يتمركز الجيش العراقي.
بقيت النساء والأطفال والشيوخ في القرية، رغم سماعهم عمّا يرتكبه الصهاينة من مجازر بحق المدنيين؛ ودخلت العصابات الصهيونية القرية في 27 تموز، وجمعت الأهالي وأتت بباصات ركبنا فيها مثل أكياس البطاطا، وأُخذنا إلى منطقة "اللّجون" في قضاء جنين.
وقد لفت نظري حين نزلنا من الباصات أن بيادر القمح في تلك المنطقة قد أحرقت تماماً وأضحت متفحمة. أُنزل الجميع، وبدأ الصهاينة يطلقون الرصاص فوق رؤوسنا ويصرخون: «اخرجوا من هنا». وأنا أذكر تماماً كيف كان صوت الرصاصات يمرّ من فوق رأسي.
رحلة الشتات
اتجهنا من قرية "اللجون" إلى قرية "زلفة"، ثم إلى قرية "رمّانة"، ومنها إلى جنين؛ كل ذلك كان مشياً على الأقدام، في جوٍّ حارّ جداً مع قلة من الماء بين أيدينا.
المعاناة كانت أكبر مما يتصوره العقل، ولم نجد أمامنا من ملجأ إلا الجيش العراقي المرابط في تلك المنطقة. ومكثنا بجواره حتى اعتبرنا بالنسبة إليه مصدر شغب؛ فما كان منه إلا أن أتى بشاحنات من نوع "لوري" تابعة له، وصل عددها إلى ما بين 30 و35 شاحنة. وكان بعضها مكشوفاً والآخر مغطى، وحملونا فيها واتجهوا بنا إلى بغداد.
وصلنا هناك بعد ثلاثة أيام من المشقة والتعب والقهر، وكان ذلك في شهر آب، وكنا نتيجة لموقفهم منا في الحرب قد اتهمناهم بالخيانة؛ فما كان منهم إلا أن أشاعوا بين العراقيين في العراق أننا بعنا أراضينا؛ حتى يغطوا تقصيرهم في الدفاع عن فلسطين.
أنزلونا بداية في مدارس "دار المعلمين"، وتكفلت بنا وقتها وزارة الدفاع العراقية؛ باعتبارنا أبناء عائلات للمجاهدين، وصرفت علينا فترة من الزمن؛ بعدها تكفلت بنا وزارة الشؤون الاجتماعية وعدّتنا وقتها لاجئين.
بقينا في المدارس مدة بسيطة من الزمن، ثم نقلونا إلى مخيمات وبيوت مهجورة كان يسكن بعضها يهود عراقيون غادروا إلى فلسطين.
هذه البيوت لم تكن صحية؛ كانت ضيقة وعبارة عن غرفة واحدة للعائلة الصغيرة؛ وغرفتين للعائلة الكبيرة. والغرفة نفسها مطبخ، وحمام، وللغسيل؛ أما دورات المياه فكانت مشتركة، غير أنها مفصولة بين النساء والرجال. وكانت الشوارع في هذه المنطقة معبَّدة.
وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية كانت توزع على العائلات الفلسطينية في تلك الحقبة من الزمن ثلاثة دنانير للفرد، وكانت تقطع حين تعلم من قبل عملائها أن ربّ الأسرة تسلّم عملاً. والأعمال التي مارسها الفلسطينيون بداية هي: التدريس بعقد عمل خاص لمن كان يتقن اللغة الإنكليزية؛ والأعمال الحرة لمن يتقن حرفة.
معاملة أهل العراق تحسنت بعد ذلك، وخاصة بعد أن استطعنا أن نفنّد كذبة بيعنا لأراضينا، وأن نبدّدها من أذهانهم.
وأخذت بعض العائلات ممن عمل رب الأسرة فيها تتحسن أوضاعها، فقام البعض باستئجار بيوت أفضل من التي كانوا يسكنونها.
لا عودة إلا بالمقاومة
لا طريق لعودتنا إلا بالمقاومة، وهذه المقاومة مستمرة حتى الآن لم تنقطع. قال الصهاينة والأميركيون: إن العرب سينسون فلسطين بعد جيل أو جيلين؛ لكن ها نحن في الجيل الرابع؛ ولم ينس أحد قريته أو مدينته. وما زال الجميع متحفزاً للعودة؛ لأنهم ببساطة رضعوا مع حليب أمهاتهم كلام آبائهم وأجدادهم عن حلمهم بالعودة. الصغار لم ينسوا على الإطلاق، وهذا مدعاة فخر لنا بين شعوب الأرض كافة.
لا شيء يعوّض الفلسطيني عن أرضه. لقد اجتهد الفلسطيني في طلب العلم، وحصل على وظائف عالية، وقام بترقية نفسه في القراءة المستمرة والملاحقة المتتالية في إبقاء قضيته حية باستمرار؛ رغم محاولة الصهاينة تذويب القضية وإنهاءها.
المجتمع الدولي إلى الآن لم يقدم أي شيء، سوى أنه يعي هذه الآلام ويعي المصاعب ويتعاطف معها؛ لكن عملياً لم يُفعَل أي شيء.
نصيحتي للأجيال المتعاقبة من أبناء شعبنا: أن استمروا بالتمسك بحق العودة، واستمروا بالمقاومة، واستمروا في شرح قضيتكم وشرح آلامكم للرأي العالمي بلغة الأرقام والتواريخ. مطلوب من كل واحد منكم، في المكان الذي يوجد فيه، أن يوعّي الناس، ويوعّي الرأي العام؛ لكي تبقى قضيتنا حية في ضمائر شعوب العالم كلها.
المصدر: مجلة العودة ـ العدد ـ 58 / شهر تموز / 2012