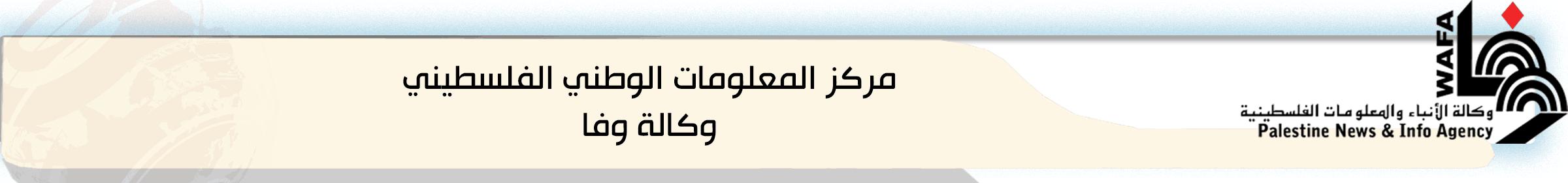أحمد الباش / دمشق:
حين أخذ يتذكر الوطن؛ قال لنا: إن قريته (المجيدل) هي قرية جميلة، من قرى قضاء الناصرة، تحاذيها قريتا: معلول، وصفورية؛ وبعض المستعمرات اليهودية مثل: خنيفيس، وجباتا، وجنجار، وفولة، والعفولة؛ وأنها تبعد عن مدينة الناصرة نحو سبع كيلومترات؛ وأنها غنية بالينابيع مثل: عين الحلوة. ويقول: كان عدد سكان القرية عند خروجنا منها عام 1948 قرابة 1650 نسمة؛ وأن أراضيها جزء من أراضي مرج ابن عامر، ذات الطبيعة الجميلة والغنية بمزروعاتها، والتي تُعَدّ الأخصب في فلسطين.
نحن والمستعمرات والإنكليز
يقول الشاهد عز الدين سلاّم؛ ابن الحاج المجاهد والشاعر الشعبي (فرحان أحمد سلاّم): نظراً لكون القرية محاطة بالمستعمرات اليهودية؛ فقد فرض هذا الواقع علينا (نحن أبناء قرية المجيدل) علاقة ما، مع هذه المستعمرات؛ ويمكن وصف تلك العلاقة (بالطبع قبل اندلاع أحداث 1948) بالعلاقة الودية إلى حد ما، ولكن لم تكن طبيعية. صحيح أننا كنا نعيش في ما بيننا بسلام، لكن لم تتطور لتصل إلى حد تبادل الزيارات. إضافة إلى ذلك؛ كان هناك بعض التوجس والخوف اللذين كانا يخيمان في الأفق، وكانا ينذران بالخطر.
وقد أدى الإنكليز دوراً كبيراً في تأجيج الكراهية بيننا وبين اليهود، كما أدوا دوراً أكبر في تسليح هذه الكُبَّانِيَّات (المستعمرات اليهودية). هذا الدور كانت تقوم به بريطانيا عن الغرب عموماً، وعن الحركة الصهيونية خصوصاً.
حكاية مع الوطن
يتابع الحاج عز الدين فرحان سلاّم قائلاً: أنا من مواليد 1935. لم أكن أعي أحداث ثورة 1936 في القرية! ولكن أبي كان من الذين انخرطوا في صفوف الثورة في وقت مبكر، وقد شارك في أعمالها، وكان يحدثني عنها وعن أحداثها كثيراً، فيقول: إن الاشتباكات في قريتنا (المجيدل) كانت تدور رحاها بين كروم الزيتون في أراضي القرية، وكان ثوار القرية ينصبون الكمائن للإنكليز واليهود هناك، ويطلقون النار ثم يختبئون، أو ينسحبون، حسب طبيعة الموقف.
ومن المهمات التي أوكلت إلى والدي أثناء الثورة، شراء الأسلحة من الشام. وبالفعل، حصل أثناء زياراته على عدد من البنادق، لكن لم يكن ليحصل لهذه البنادق على ذخيرة، (وإحنا كان عنا بارودة كندية، وكان معها 15 فشكة، وما كان في غيرهن. وبعدين؛ صار عرس؛ فضربنا خمس فشكات منهم، فما ظل غير عشر فشكات فقط. كانت مشكلتنا بالفشك. وقد ذكر لي أحد الثوار (أظنه من بيت الزغل) قائلا: "يشهد علي الله أنو ذهبت للمعركة، وما كان معي غير فشكة واحدة". وهذا الوضع لم يكن في قريتنا فحسب؛ بل في أغلب القرى الفلسطينية. وهذا من أهم الأسباب يلي سببت هجرتنا عن بلادنا.
يضيف الحاج عز الدين سلام فيقول: وكان لأبي في ثورة 1936 مهمة أخرى غير القتال، والمهمة كانت تنبع من كونه شاعراً شعبياً معروفاً وذائع الصيت في كل البلاد؛ فأثناء الثورة، كان يلهب بأشعاره مشاعر المقاتلين والثائرين، وتطور به الأمر إلى القيام بجولات على بعض الحكام العرب، وخاصة في دول الخليج العربي، وكان يلقي عليهم أشعاره التي يتحدث فيها عن الإنكليز واليهود وعن جرائمهم في فلسطين؛ فيستعطف مشاعرهم، ويؤلبهم على الإنكليز. ومن شدة تأثيره فيهم؛ لاحقه الإنكليز وسعوا إلى اعتقاله، وعندما شعر أبي بذلك، ذهب بنا إلى الشام، وهناك أقمنا فترة من الزمن، عدنا بعدها إلى القرية، وكان ذلك بعد أن اندلعت الحرب العالمية الثانية.
في أثناء الحرب العالمية؛ استغلت العصابات الصهيونية الأوضاع في المنطقة والعالم، وبدأت بالتسلح استعداداً لاحتلال بلادنا، وبدأت تقيم المستعمرات والمعسكرات بكثافة، وتدرب عصاباتها أفضل تدريب. واستمرت الحال على هذا المنوال إلى أن حطت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وقد عزز ذلك انتصار الإنكليز، وحلفاؤهم من المستعمرين الآخرين، على الألمان.
على أبواب النكبة
ما إن صدر "قرار تقسيم فلسطين" في تشرين الثاني من عام 1947؛ حتى كانت العصابات الصهيونية على أتم الاستعداد للانقضاض على بلادنا؛ فأخذت تروّع القرى والبلدات والمدن، وارتكبت بحق الشعب الفلسطيني أبشع المجازر، التي من أهمها مجزرة دير ياسين التي وقعت في نيسان عام 1948.
نحن في قريتنا (المجيدل)؛ عندما سمعنا بخبر مجزرة دير ياسين؛ اجتمع رجال القرية كلهم في دار المختار، وكان من عائلة كسّاب، وتدارسوا الأمر، وقرروا التباحث مع القيادة العسكرية في الناصرة، التي لم تجدِ شيئاً، وكان بعض الشبان من القرية يمتلكون بعض القطع من السلاح، ولكنها كانت بسيطة وقليلة.
عندما هوجمت قريتنا (قرية المجيدل) أول مرة، هرع هؤلاء المسلحون من شباب القرية ليدافعوا عنها بما لديهم من الأسلحة والذخائر، وبالفعل، استطاعوا أن يصدوا الهجوم عن القرية؛ لكن إثر هذا الهجوم؛ خرج بعض الأهالي بنسائهم وأطفالهم إلى مدينة الناصرة القريبة من القرية، وبقي بعض الرجال يحرسون القرية.
بعد ذلك؛ حصل هجوم آخر، قاومه الشبان بما لديهم من ذخيرة؛ لكنها سرعان ما نفدت من جعبهم وبنادقهم، وأصبحت البنادق تلك في أيديهم كالعصي؛ بدون رصاص؛ ما اضطرهم إلى الانسحاب واللحاق بأهاليهم وعائلاتهم إلى الناصرة.
معظم أبناء عائلات قريتنا (قرية المجيدل)، لجأوا إلى أقرباء لهم في المدينة، وسكنوا معهم في بيوتهم؛ والبعض الآخر استأجروا بيوتاً أو غرفاً. بالنسبة إلينا، كان لعمتي في الناصرة بيت واسع، سكنّا فيه مدة أسبوع واحد. بعدها، استأجر أبي عقدين (غرفتين)، وسكنّا فيهما حتى وصلت المعارك إلى مدينة الناصرة.
وصل جيش الإنقاذ إلى المدينة، وهذا الجيش لم يكن لديه الإمكانات الكبيرة؛ فلم يدخل في معارك كبيرة تغير ميزان المعركة مع العصابات الصهيونية التي كانت مدججة بالسلاح. لذلك، لم يمضِ وقت طويل حتى سقطت مدينة الناصرة.
وجع التهجير
بعد سقوط المدينة، خرجنا منها واتجهنا في سيرنا نحو الشمال باتجاه القرى اللبنانية القريبة، من الحدود مع فلسطين، وكان مشياً على الأقدام. وخلال خروجنا؛ كانت تلاحقنا بعض الطائرات اليهودية، وكانت تقصف وراءنا؛ لتمنعنا من مجرد التفكير بالعودة إلى الخلف (إلى قرانا ومدننا). بالطبع؛ كان ذلك ضمن خطة مدروسة ومحكمة.
وصلنا بعد هذا المسير الشاق إلى قرية "بنت جبيل" اللبنانية، ونزلنا عند أحد معارف أبي في القرية، حيث سكنّا في غرفة لمدة 15 يوماً.
بعد ذلك؛ جاء الجيش اللبناني ووزعَنا على المدن اللبنانية، وذهبنا نحن إلى مدينة بيروت، حيث بقينا فيها قرابة سنة أو أقل بقليل، انتقلنا بعدها إلى الشام (دمشق)، وهناك نزلنا في منطقة تسمى "الهامة"، وقامت الدولة آنذاك بإعطائنا بيتاً وبستاناً كانا لأحد المغتربين السوريين الذي كان يسكن خارج البلاد، وبقينا هناك سنة كاملة، قام أبي بعدها بتسجيلي أنا وأخويّ (الأكبر والأصغر)، في المدارس. وقد أرهقتنا منذ البداية مصاريف التنقل إلى المدينة؛ فاضطررنا للانتقال إلى منطقة "جوبر" في ريف دمشق، وسكنا في بيت يقع على "نهر تورا"، وصرنا نتابع دراستنا هناك في الوكالة (الأونروا). وعمل أبي بعد ذلك في الإمارات العربية.
أنا مفعم بالأمل
اليوم، بعد 63 سنة، ما زلت أذكر بيتنا حتى الآن، وكان مؤلفاً من غرفتين: واحدة من طين، والأخرى من حجر؛ وما زلت أذكر باب بيتنا الخشبي والقنطرة من فوقه، وكم أحنّ اليوم له! وكم أتمنى أن أعود إليه! صحيح أن اليهود هدموه؛ ولكن حين أرجع إلى أرضي سأبنيه من جديد، وأملي في ذلك كبير.
وأنا على اقتناع، بأن أول طريق لتحرير فلسطين هو توحيد العرب بيد واحدة ، "والله عندما يتوحدوا لو كل واحد عربي جاب سطل مي ورشه على (إسرائيل) لغرّقوا اليهود يلي فيها؛ ونحن مستحيل نرجع إلا إذا كان العرب يد واحدة، ونحنا أملنا بالجيل الصاعد، وأنا وبهذا العمر لو يصح لي أقاتل أقاتل؛ لأنه بغير القتال، فلسطين لا يمكن أنو تتحرر، واليهود ما رح يقولوا للفلسطينيين: خذوا بلادكوا، وإحنا طالعين منها".
بالنسبة إلى أبي؛ كما قلت: كان شاعراً شعبياً، ومن الأسماء الذائعة الصيت، وأشعاره كلها حماسية. كانت تلهب الثوار في المعارك؛ وقد حمل لقب "شاعر وثائر" بجدارة، وشارك في مجريات حرب الـ 36، وفي مجريات الحركة الوطنية الفلسطينية في ما بعد، وكان أبي قوية البنية يلبس (الديماية) (القمباز)، ويركب الخيل، ويجيد الحداء. ومن أشعاره المعروفة جداً:
إن كان بلفور يجهل قيمة الأوطان
إحنا بأرواحنا نحمي أراضينا
نبيع أرواحنا بأبخس الأثمان
حقاً على الله نصر المؤمنينا
يقول الحاج عز الدين سلاّم: رغم أن والدي كان حدّاء القرية (المغني الشعبي للقرية)، كان يحب أن يحضر في أعراسنا باقي الحدائين من القرى الفلسطينية الأخرى، مثل: أبو سعيد الحطيني، والريناوي، وعازف اليرغول (أبو شهاب)؛ وذلك لإظهار روح التحدي في ما بينهم. وكان والدي، إضافة إلى ذلك، محط احترام ورأي لدى رجالات القرية جميعاً، وكانوا يستشيرونه في كثير من أمورهم.
بعد النكبة، وفي عام 1958؛ تواصل أبي مع الفنان أبو عرب؛ وأصبحا يعملان معاً في إذاعة "صوت العرب، في القاهرة، في ركن بإذاعة فلسطين؛ وقد شاركهم أيضاً المغني الشعبي (أبو سعيد الحطيني)، وقد سجلوا للإذاعة آنذاك بعض الأغاني الفلسطينية الوطنية والتراثية، في برنامج اسمه "أهازيج ومكاتيب". أخيراً؛ رحم الله والدي، ورحم الله الحطيني، وأطال الله في عمر الفنان أبو عرب.
المصدر: مجلة العودة : العدد ـــ التاسع والأربعون ــ 2011