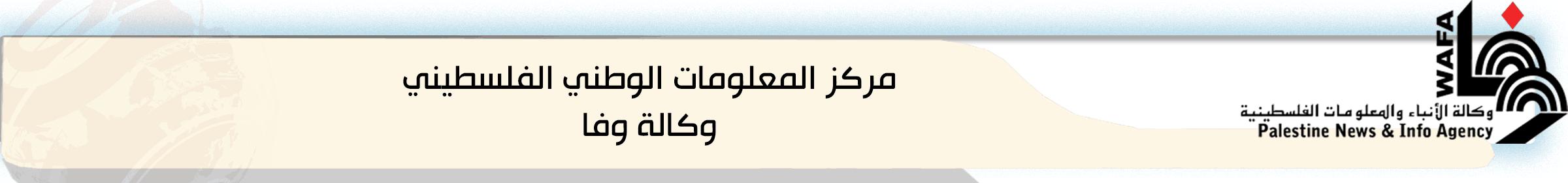حين نتحدث عن الأدب الفلسطيني، نعني أن نبحث في قسمين: أدب الشتات، وأدب الأرض المحتلة 48 ثم 1967؛ فلم يستطع الإنتاج الأدبي الفلسطيني قبل هذه الأعوام أن يترك أثراً كبيراً على الساحة الثقافية العربية، وإن ظلت هناك محاولات لافتة على ندرتها.
وما حدث في نكبة عام 48 من احتلال وهجرة قسّم الشعب إلى اثنين أيضاً، بكل ما حمله هذا الانقسام من ظروف وتجارب وتصادم مع الحياة وتباينها، ولكنها تصب كلها في مأساة شعب اقتلع من دياره أو بقي فيها محتلاً، وشكّل هذا بؤرة ومحور الأدب الفلسطيني نثراً وشعراً.
ولعل السمة الأبرز في الأدب الفلسطيني هي تلك الاختلافات الواضحة من حيث علاقته بالزمان والمكان، ولهجة الخطاب، والاتجاهات، وانشغاله الخاص بالقضية السياسية السائدة، وظهور الشخصية اليهودية فيه أو اختفاؤها، وتميز بعض هذا الأدب ببعده عن البكائيات إلى موضوعات إنسانية واسعة رغم حجم المأساة الفلسطينية واستمرارها.
واللافت أيضاً خلو مجمل الأدب الفلسطيني من التعامل مع الشخصية اليهودية أو تصويرها مع أنها الخصم الحقيقي الذي أوصله إلى ما هو فيه من البؤس والمعاناة والتشرد؛ وربما كان ذلك نتيجة للسياسات العربية التي حرّمت التعامل مع الإسرائيليين، واعتبرت ذلك خيانة وطنية.
وظلت صورة اليهودي الحاضرة الغائبة؛ فهو العدو الذي لم يواجهه الأديب أبداً، وإن تسبب في نكبته وضياع أرضه، وحتى عام 67 حين رآه لأول مرة محتلاً لما تبقى من فلسطين، فظهرت صورته بعد هذا العام كمحتل، لهذا؛ لا نجد عنصرية أو ازدراء لليهود، بل على النقيض هم الكتلة المخيفة التي جاءت مشردة من العالم لتحتل أرض فلسطين وتتسبب في محنته، وهو أقسى ما يتهم به اليهود في هذا الأدب، حتى عندما كتب غسان "عائد إلى حيفا" والتي يحكي فيها عن عودة اللاجئين إلى بيوتهم السليبة، بعد أن سمحت إسرائيل لمن يريد بزيارة مناطقها، فالتقى خلدون وصفية مع ميريام اليهودية التي سكنت بيتهم وربت أخيه، فدخل الجيش الإسرائيلي مجنداً، صورها إنسانة تكره ظلم قومها للعرب، وبعكس ما نجده في الرواية الإسرائيلية التي صورت العرب جهلة مخادعين، بدواً رحلاً بلا حضارة، أو من باعة البطيخ لافتقارهم للعلم؛ كما عند يائيل دايان أو ليون أوريس وغيرهما.
ولعل أول من أشار إلى الشخصية اليهودية من الكتاب الفلسطينيين هو خليل بيدس، العام 1920 في روايته (الوريث) التي كتبت في القدس عن حياة شاب من عائلة سورية هاجرت إلى مصر، ويقع الشاب هناك في حب راقصة يهودية تصورها الرواية مصاصة دماء، ويساعدها على ابتزاز أموال الشاب بعض من أبناء جلدتها، وهنا يظهر تأثر الكاتب الواضح برواية شكسبير تاجر البندقية، فالرواية لم تشر مطلقاً إلى خطر هؤلاء المهاجرين أو الصهيونية على فلسطين، ولكنها ركزت على جزيئية في الشخصية اليهودية عرفت عالمياً وهي حب المال.
ولم تكن الرواية الثانية –إذا جاز اعتبارها- رواية "مذكرات دجاجة" لإسحق موسى الحسيني 1943، قد اقتربت أو نبهت للخطر الصهيوني على فلسطين، رغم أنها نالت شهرة كبيرة وأعيدت طباعتها مرات عدة، وتروى أحداثها على لسان الحيوان؛ وربما كان في ذلك عودة إلى التراث، وقصص كليلة ودمنة. وكتب الدكتور طه حسين مقدمة كتاب اسحق موسى الحسيني، كما ظهرت شخصية جندي يهودي في رواية "ما تبقى لكم" عند كنفاني ولكنها شخصية ثانوية.
لقد ظل الكتاب الفلسطينيون بمنأى عن التيارات الفكرية العربية والأدبية التي هبت على العراق ولبنان من القاهرة؛ حيث بدأت حركات التنوير المختلفة؛ وهو ما يفسر جدب الحياة الثقافية فيها من أدباء بارزين قبل عام 1948، حيث برز بعده إبراهيم طوقان، وأبو سلمى، ثم فدوى طوقان، وتزامن معهم في المكانة الأدبية وفي لفت نظر الساحة الثقافية العربية أديب الشتات جبرا إبراهيم جبرا، الذي عرّف العرب بروائع شكسبير بترجماته المتعددة، والذي عاش متنقلاً بين بيروت والقاهرة وبغداد، وتميز بالبلاغة وتوهج الأسلوب، وعمق الأفكار في قصصه ثم رواياته، وإن ركز على حياة الصفوة من المفكرين، وربما كانت "البئر الأولى" التي تروي سيرته الذاتية في بيت لحم من القلة في إنتاجه التي تتعرض لحياة البسطاء وهمومهم وأحلامهم. وكان جبرا كذلك رساماً وشاعراً كتب قصيدة النثر.
أما من الأديبات؛ فقد برزت سميرة عزام في القصة القصيرة جنباً إلى جنب مع الشاعرتين سلمى الخضراء الجيوسي، وفدوى طوقان، وقد عملت سميرة عزام طويلاً في الإعلام المسموع في قبرص، وقدمت للقصة القصيرة العربية شكلاً فنياً مميزاً، كما أظهرت تفوقاً ملحوظاً وتنوعاً ثقافياً لافتاً في مجموعتها "أصوات الليل".
وللأسف، فإن سميرة عزام لم تترك إنتاجاً غزيراً؛ حيث ماتت في الثانية والأربعين من عمرها، وبعد نكسة عام 67 مباشرة، ولكن النقد العربي لم يركز على هذا الارتباط بين موتها والنكسة، في حين بحث طويلاً في أثر المعاناة النفسية للأدباء الرجال الذين لم يحتملوا صدمة النكسة وأثرها وانهيار الحلم العربي وفكرة القومية، فصمتوا عن القول أو انتحروا.
أما خير من يمثل الأدب الفلسطيني بعد جيل الرواد هؤلاء، فهو غسان كنفاني، الذي بدأ ظهوره اللامع بداية الستينات حين نشر مجموعته الأولى "سرير رقم 12" وتشمل 17 قصة عام 1961، ثم "أرض البرتقال الحزين" عام 1963، وهو عام نشر روايته الأولى "رجال في الشمس"، التي كرست رواية فلسطينية متقدمة فنياً، ولفتت أنظار النقاد إلى قدرة كنفاني المتفوقة في مجال الرواية، واحتفى بها المشهد الثقافي العربي وتحولت إلى فيلم سينمائي.
والرواية التي صورت المأساة الفلسطينية تقطر شعوراً بالذنب عند المثقف الفلسطيني؛ لعدم استشرافه لضياع وطنه وتشرده حتى وقعت النكبة، وقد أنهى غسان روايته بتلك الصرخة المدوية "لماذا لم تدقوا الخزان"، إنها قصة الفلسطيني المخنوق بظروفه وعدم بصيرته ومواجهة الخطر والسكوت عليه، فقد بقي صامتاً في الخزان، لم يدقه، ولم يهرب، ولم يجتز الحدود.
أما في مجموعته القصصية "عالم ليس لنا" عام1965، فيحكي كنفاني غربة الفلسطيني بعد 1948، وظروفه الخانقة وشظف العيش التي لا يمكن الانتصار عليها إلا بالحظ أو المعجزة، فيبحث فيهما عن الثراء الذي سيعوضه عن الهجرة وضياع الوطن في محارات قد تحمل إحداها لؤلؤة كبيرة غالية تغنيه وتعوضه عن بؤس الحياة، ويقتنع بأنه سيجدها لا محالة، ولكنه يفتح المحارات في تصاعد التوتر النفسي الذي يصل مداه مع خلو المحارة الأخيرة إلا من طراوة صدفتها، فيقتله الخذلان والحلم اللذان كبرا في عقله وقلبه، فلم يحتمل انهيارهما.
ولم يقتصر نقد الذات على كنفاني بل برز واضحاً عند كثيرين، مثل: رواية جبرا "البحث عن وليد مسعود" عام 1970، و"عالم بلا خرائط" بالاشتراك مع عبد الرحمن منيف.
إن غسان هو ابن النكبة، ولهذا صور الشتات الفلسطيني والخيام وضياع الأحلام والتشرد بحثاً عن فرص الرزق في دول الخليج، وهو ما يميزه عن الأدباء الذين بقوا في أرضهم من عرب إسرائيل، كإميل حبيبي، ومحمود درويش، وسميح القاسم. أو فيما عرف بالمملكة الأردنية وحتى الاحتلال في عام الحسم 67،مثل: كمال ناصر في الشعر، ويحيى يخلف، ومحمود شقير وغيرهم، وإن ظلت القضية السياسية المحور الوحيد لكل الإنتاج الفلسطيني بل وبعض العربي.
وتؤكد سلمى الخضراء الجيوسي، أن أزمة الأديب الفلسطيني هي في أنه (سواء كان من الفلسطينيين في إسرائيل، أم في الضفة الغربية وغزة، أو في الشتات، فإنهم ملزمون، بحكم هويتهم الفلسطينية ذاتها، بأن يعيشوا حياة تتحكم فيها ظروف وأحداث نابعة من رفضهم للأسر وضياع الوطن، مثلما تتحكم فيها نوايا الآخرين، وشكوكهم ومخاوفهم وعدوانهم... فالكاتب الذي يفكر في التوجه توجهاً منفصلاً عن السياسة ككاتب، يتنكر للواقع والتجربة والانغماس في الحياة اليومية (العادية)، ومعناه خيانة حياة الفرد ذاته، وخيانة شعبه).
لقد هيمن الشعر على الساحة الثقافية الفلسطينية؛ نظراً لمباشرة تأثيره وحماسته؛ لأننا أمة تعشق الشعر منذ القديم، وقد شكل دائماً الجزء الأبرز في تاريخها، ولوصول أصوات جديدة متميزة في طرحها ومقاومتها وانتمائها الفلسطيني العربي من داخل الأرض المحتلة، أنارت ظلمة انكسار الشعراء والأدباء الذين أحسوا بتأنيب النفس ولوم المثقف، والتي تشكل ظاهرة واضحة في الرواية والقصة الفلسطينية تحديداً.
لقد بدأت الرواية زحفها لتحتل مكانة رفيعة في الأدب الفلسطيني كما العربي منذ بداية الستينيات، حتى باتت النوع الأدبي الأبرز مع نهاية القرن العشرين.
وبداية من السبعينيات من القرن العشرين، برزت على الساحة الأدبية الفلسطينية أصوات مميزة في الشعر والرواية والقصة القصيرة، وترجمت أعمالهم إلى اللغات الحية مما وضع هذا الأدب على محك التماس مع الآداب الأخرى. وقد تنوعت التجارب الأدبية بإتقان الكثير منهم للغات الأجنبية أو الاطلاع على الآداب العالمية مترجمة، مع بقاء القضية السياسة المحور الأهم فيها بتنويعات مختلفة كما عند إبراهيم نصر الله الشاعر والروائي، وفي روايته الثالثة "مجرد اثنين فقط" التي كتبها بلغة شاعرية فائقة العذوبة، يلوم فيها الأنظمة العربية القمعية والمجتمعات الأبوية التسلطية من خلال لقاء رجل وآخر في قاعة الترانزيت وكل منهما يحمل بطاقة سفر ذهاباً فقط، وينتقد من خلال حديثهما وسائل الإعلام العربية التي ضللت الناس بكذبها وتهويشها السياسي ورجال الأمن والكاهن والأب والحاكم وكل سلطة أبوية.
إن الكاتب الفلسطيني، شاعراً أو روائياً أو قاصاً يعيش الآن مرحلة مفصلية في تقويم إبداعه وامتلاكه لأدواته، بعد أن ظل النقد العربي على مدى عقود يربط الكتابة بالقضية السياسية ويعتبرها جواز سفر متسامح مع كثير من النصوص الشعرية والروائية، فمرر كثيراً منها إلى ساحة الأدب، كما كرس أسماء ما كانت لتحظى بنجوميتها تلك لو لم ترتبط بالقضية السياسية.
وقد فعل النقد ذلك مدفوعاً بالعاطفة وإحساس المثقف العربي بالتقصير وعقدة الذنب لما حصل في فلسطين، والتي شكلت قضية العرب الأولى إلى مرحلة الخروج من بيروت لتصير قضية الفلسطيني بداية، وليصير النقد العربي كما السياسة العربية ناقداً ممحصاً لأي إنتاج أدبي فلسطيني، ورغم ما ينطوي عليه ذلك من معان سلبية سياسياً، إلا أنه بالتأكيد لصالح هذا الأدب؛ لأنه سيتخلص ممن حملتهم القضية إلى مصاف الأدباء دون وجه حق، لارتباطهم بفئة سياسية روّجتهم، أو للتسامح النقدي العاطفي معهم...
المثقف العربي عموماً عاش أزمته بالشعور بالذنب، ثم نقد الذات منذ بدايات الستين. ولعل رواية حليم بركات (ستة أيام) عام 1961، هي إحدى بواكير هذا الشعور، تلتها مذكرات هشام شرابي ثم غسان كنفاني، ثم توالت الاتهامات للنفس وللثورة وبشكل عنيف، وللأنظمة العربية، وهناك روايات فلسطينية كثيرة تحدثت في ذلك وبجرأة، مثل: يحيى يخلف "نجران تحت الصفر"؛ وليلى الأطرش "امرأة للفصول الخمسة"، ورشاد أبو شاور"آه يا بيروت"، و"البكاء على صدر الحبيب"، و"ثورة في عصر القرود"، وسحر خليفة في" الميراث "؛ وأفنان القاسم في "أربعون يوماً في انتظار الرئيس"، وأحمد عمر شاهين " زمن اللعنة"، وأحمد حرب في "بقايا".
وبرز الشعور بالذنب والتقصير عند الشاعر الفلسطيني مسلماً أو مسيحياً؛ ما ولد ارتباطاً قوياً بالتراث العربي والإسلامي والعودة إلى أمجاده، إنه البحث عن الهوية والجذور والماضي المشرق.
وشكّلت الأندلس حلقة بارزة في هذا التراث؛ فهي مدعاة فخرهم، وتمثل هذا في استحضار قرطبة وإشبيلية وغرناطة، وانتصارات طارق بن زياد، وعزيمة عبد الرحمن الداخل. نجد البحث عن الهوية بدءاً بإبراهيم طوقان، ثم محمود درويش، ومعين بسيسو، وعز الدين المناصرة، وسميح القاسم، ومحمد القيسي، وناهض الريس، وخالد أبو خالد وغيرهم، بينما غابت الأندلس ودلالاتها في النثر الفلسطيني باستثناء خليل بيدس.
إن نكبة الأندلس شبيهة بنكبة فلسطين، واستحضار الأندلس الضعيفة والمفككة حتى سقوطها هي نوع من محاسبة الذات من خلال توظيف التاريخ بين الوعي واللاوعي.
أمر آخر شديد الوضوح في مجمل الأدب الفلسطيني الحديث، وهو كتابة السيرة الذاتية التي كان لعودة منظمة التحرير وكوادرها أثر بالغ في ظهورها؛ فبعيداً عن "رحلة جبلية رحلة صعبة" لفدوى طوقان، كتب كثير من رجال المنظمة تجارب عودتهم من خلال سيرتهم الذاتية، وكان فيها الكثير من التجارب المرة، رشاد أبو شاور "رائحة التمر حنة"، و"الرب لم يسترح في اليوم السابع"، وفيصل حوراني "دروب في المنفى"، ويحيى يخلف "بحيرة وراء الريح"، ومريد برغوثي "رأيت رام الله" ومحمود شقير.
أين موقع الأدب الذي تكتبه النساء الفلسطينيات في المشهد الثقافي الفلسطيني والعربي عموماً؟
لقد استطاعت الروائية الفلسطينية أن تترك بصمة واضحة في الأدب الفلسطيني خاصة والعربي عامة، بل ترجم كثير من الإنتاج الأدبي للمرأة الفلسطينية إلى اللغات العالمية ولقي صدى مميزاً، ولكن الظروف السياسية الراهنة، وما تحمله من عدم الاستقرار وصعوبة التواصل مع الخارج، أبعد بعض الأصوات الأدبية النسائية الجديدة عما تستحقه من الاهتمام؛ لتنوع تجربتها وامتلاكها لأدواتها الإبداعية في حقول: القصة، والرواية، والشعر، مثل: حزامة حبايب، وحنان عوّاد، نبيلة العسلي، ديمة السماّن، رفيقة الحسيني، فيحاء جاد الله، رشدة المصري، وداد البرغوثي، تودد عبد الهادي، نداء خوري، وغيرهن.
لقد جاء الأدب الذي تكتبه النساء الفلسطينيات شديد الواقعية، وعميق الرؤية، ومواكباً للتطورات السياسية خارج الأرض المحتلة.
وارتبطت بعض التجارب الفلسطينية التي قوبلت بكثير من الاهتمام النقدي، وترجمت إلى اللغات العالمية، بالقضية السياسية مباشرة أو تداعياتها على هؤلاء الكاتبات، ولكن من منظور نساء يعشن في مجتمع أبوي مستحدث، أتاح لهن فرص التواصل مع الحياة والاطلاع على العالم والتعليم، وإن ظلت تلك النظرة ذات خصوصية واضحة.
وقد جاءت تجارب هؤلاء الكاتبات ناضجة الوعي سياسياً واجتماعياً وإبداعياً، مع تميز كل منها بالظروف الخاصة والعامة التي حددت إطار التجارب والتصادم مع الحياة. بعضها ارتبط بالمقاومة ومن داخلها ومعايشة رجالها كتجربة ليانا بدر، وسلوى البنا، ومي صايغ التي كتبت رواية بعد تجربة شعرية طويلة، أو بالظروف المعيشية للفلسطينيين في الداخل كروايات سحر خليفة، أو روايات الحرب ضمن سياقها الاجتماعي والتاريخي للفلسطينيين وارتباطهم بالمد القومي كروايات ليلى الأطرش.
لقد اهتمت التجارب الثلاث لسحر خليفة وليانا بدر، وليلى الأطرش بالوطن والمرأة ولكن من منظور اختلفت فيه التجارب والمعاناة الشخصية والعمل؛ ففي حين كتبت سحر خليفة تجارب حياتها الخاصة في "لم نعد جواري لكم" و"مذكرات امرأة غير واقعية"، كما كتبت عن مجموع الناس في الوطن ومعاناتهم اليومية تحت الاحتلال وفي ظل ممارساتها بشكل دقيق وبانوراما قلما تتوفر لكاتب إلا بالمعايشة اليومية لهذه الأحداث في رواياتها " الصبّر" و"باب الساحة" و"الميراث"، كتبت ليانا بدر، عن تجربتها في النضال ومعايشة الثورة في الخارج في روايتها "شرفة على الفاكهاني"، ثم "نجوم أريحا" وعن وجود المرأة الفلسطينية في مجتمع الثورة وما فرضه ذلك من خروج المقاومة من بيروت إلى تونس، ثم العودة إلى فلسطين.
وتناولت ليلى الأطرش الحياة الاجتماعية في فلسطين حتى السبعينيات في روايتها "وتشرق غربا"، وكذلك في مجموعتها القصصية "يوم عادي"، وعن الشتات الفلسطيني والفساد الثوري في الرواية الثانية "امرأة للفصول الخمسة"، وعن انفصال العائلة الواحدة وانقسامها بين فلسطين والأردن في "ليلتان وظل امرأة"، وعن خيبة المثقف العربي في "صهيل المسافات".
وتشترك الروائيات الثلاث في التركيز على قضية المرأة وارتباطها بالوطن ومعاناته. وفي حين ترفض سحر خليفة الاعتراف بأن المرأة شاغلها رغم ما يظهر في أعمالها، تعترف ليانا بدر، وليلى الأطرش أن هموم المرأة العربية هي واحدة من أهم ما يشغلهما.
إن الأدب الفلسطيني أسهم بشكل واضح في تعريف العالم بقدرة الفلسطيني على الإبداع والتميز بالمشاعر الإنسانية، والاطلاع والتمسك بالهوية العربية دون تعصب ودون بكائيات، أو تضخيم لحجم المأساة التي يعيشها الفلسطيني مطارداً من الأنظمة العربية، التي تنكر عليه فلسطينيته أحياناً وتجبره على التنكر لها.